
“الإجراءات الجزائية” النظام حين يتحول عالة على مشرعيه!
 27 نوفمبر, 2012
27 نوفمبر, 2012  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
(1)
باتت أغلب الدول في الزمن الحاضر تسير نحو خلق جو من المؤسسة النظامية في مرافقها كافة، بغية إرساء القواعد المفاهيمية العصرية، لتشييد الدولة الحضارية. والمملكة العربية السعودية، بصفتها دولة ناشئة، سعت لأن تكون ذات “سمعة” عالمية تتسم باحترام النظام الذي يصب في خدمة الإنسان، وشأنه العام.
ولهذا السبب نجد أن الدولة النفطية الأولى على مستوى العالم، أصدرت مجموعة من القرارات التي تعزز من تنظيم العلاقة بين المواطنين بعضهم ببعض، وبينهم وبين السلطة السياسية، التي تديرها أسرة آل سعود منذ العام 1932م. ووجدت تلك القرارات، التي صدر أغلبها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، الترحيب العالمي قبل المحلي، بسبب ما يشاع من أن هذه الدولة (أي السعودية) لا تحترم حقوق الإنسان، ولا تتيح له الفرصة للتعبير عن رأيه. ويأتي هذا التصور الغربي نتاجًا متوقعا بسبب غياب المجتمع المدني، ووسائل التعبير عن الرأي، وبقية النواقص التي يمكن من خلالها قياس الحريات، والحراك المجتمعي من عدمه.
وشهد العام 2001م صدور “نظام الإجراءات الجزائية” بمرسوم ملكي، في عهد الملك الخامس، فهد بن عبدالعزيز. هذا المرسوم الذي يتكون من 225 مادة موزعة على 9 أبواب، شكَّل نقلة نوعية على مستوى حقوق الإنسان في السعودية حسب تعبير عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام. هذه النقلة دفعت عديدًا منهم إلى جعل هذا النظام (الإجراءات الجزائية) خطا أحمرَ، ومن غير المقبول المساس به، بأي حال من الأحوال.
إلا أن ما وقع محليا من أحداث مؤسفة في العام 2003م، وما تلاه، التي واكبها حملة من الاعتقالات الواسعة لكافة المعنيين بملف الإرهاب، جعل هذا النظام (الإجراءات الجزائية) على المحك، بين التطبيق والتجاهل، كما يحدث مع كثير من الأنظمة “الجيدة” التي تسن، ومع ذلك ليس لها أي آثر على أرض الواقع. وبشهادة أغلب المتابعين، فإن نظام الإجراءات الجزائية سرى عليه ما سرى على غيره من الأنظمة، ما تسبب في إحداث صدمة للمهتمين، الذين أحسوا أن بارقة الأمل التي تشبثوا بها، لم تكن سوى سرابا لا يراد أن يكون له أصلا.
(2)
بسبب انعدام كافة أنواع المشاركة الشعبية “الفعلية” لاتخاذ القرار في المملكة، ووجود مجموعة من المشاركات العرجاء لا تتمتع بأي صلاحية لتنفيذ أي تغيير تنموي يشهده المجتمع، يكون بذلك مشرع الأنظمة هي السلطة السياسية وحدَها، وفق قوالبها وأشكالها، التي لا تخرج مسئولية القرارات عن دائرتها، سواء الإيجابي منها أو السلبي.
ويُعد نظام الإجراءات الجزائية نظاما إيجابيا صدر من قبل المشرع، إلا أنه واجه انتكاسة سلبية من قبل الجهات المنفذة للقرار، بحكم أنه جاء متسقا مع مفهوم حقوق الإنسان الذي لن أقولَ إنه ما زال يتبلور محليا، ولكن سأقول إنه شبه معدوم، بحكم أن هناك من يؤمن أن عملية إجهاضه فرض واجب!.
وهنا يبزغ سؤال محوري في هذا الباب، ألا وهو: لماذا تُشرَّع مثل هذه الأنظمة، وبذات الوقت تُجهَض؟!
الجواب عن هذا السؤال متفرع، وله أكثر من مدخل، ولكن من الأفضل البدء من أول السطر، والاعتراف أن مثل تلك القوانين تعد من أجود المواد الصالحة للاستهلاك الإعلامي لتلميع صورة النظام السعودي لدى المراقبين الغربيين. أما ما يلحق القرار من تبعات عدم تنفيذه، فإن الرد عليه سيكون عبر إلقاء تهمة التقصير على الأفراد، في مراوغة تبقى المراقب منقسم عند تقييمه وضع الإنسان السعودي حقوقيا، فهو من خلال الأنظمة والقوانين يلقى تعاملا جيدا، ولكن من ناحية التطبيق فهناك سوء إدارة يجب أن ينظر في أمرها. وبذلك تكون السلطة السياسية (المشرع للأنظمة) قد ردت على هجوم الإعلام الغربي، وتقارير المنظمات الحقوقية.
هذه البراءة العالمية، تختلف تماما عن البراءة المحلية “المفترضة”، بحكم أن الأولى تنظر للأوراق والمشاهد الظاهرة لها، فيما تنظر البراءة المحلية لعمق التجربة التي جعلتها قادرة على تفكيك حقيقية ما يعلن ودوافعه، وبين ما يجري ومن يدعمه. ولكن المفارقة، أن المشرع عندما شرع ذلك النظام كان قادرا على تطبيقه وفرضه بكافة حذافيره، حتى ولو كلفه ذلك شيئا من الخسائر المعنوية والمصالح المتقاطعة داخل إدارة الحكم، إلا أنه لم يرغب في ذلك؛ نظرا لأن البراءة المحلية لا تشكل له هاجسا يخشاه، بحكم أن السلطة السياسية تمتلك زمام الأمور عبر عناصر مختلفة، كالقبضة الأمنية، والمؤسسة الدينية، ومشايخ القبائل، ورجال الأعمال، والماكينة الإعلامية. إضافة لإنشاء مجالس وهيئات “صورية” مرسومة بمعايير السلطة، لتكمل المنظومة المتكاملة في إحكام السيطرة على مفاصل الدولة.
من خلال قراءة المشهد السعودي بالصورة السابقة، سيكون بقدرتنا معرفة السبب الذي يقف وراء انصراف أغلب المجتمع عن الانشغال بما يصدر من قرارات، والبحث خلفها لمعرفة ما الذي فعل منها أو وُئد، بحكم علمه أنه غير مخير في أمره، وكل ما عليه هو القبول. في حين نجد المواطن منصرفا إلى متابعة القرارات المتعلقة بتفاصيل معيشته اليومية، دون أيضا أن يستطيع خلق تغيير عليها، ولكن ذلك ما يستطيع فعله وهو القيام بتجسيد دوره “بإتقان”، كأي مواطن يعيش في ظل نظام رعوي.
وعلى الرغم من راحة البال التي يعيشها المشرع (وما زالت حتى الآن مستمرة بشكل نسبي) في صد كافة أشكال التمرد على قراراته، إلا أن الربيع العربي أحدث انقلابا مفاهيميا في كيفية الحصول على الحقوق، وهي التي جعلت السلطة تواجه واقعا يتمظهر في الشارع، وليس خلف شاشات الحواسيب الآلية، وبأسماء مستعارة، كما كان يحدث سابقا. إضافة لذلك وجدت السلطة نفسها أمام مطلب موحد من كافة التيارات الفكرية والأطياف الدينية، في سابقة تجير بلا شك للربيع العربي، ألا وهو المطالبة بحل ملف المعتقلين، ذلك المطلب الذي جعل الضرب على وتر الطائفية “مهلهلا” في بداية الأمر، إلا أنه أخذ شيئا من فعاليته مع مرور الوقت، وكسر جزء من العصا، لكنه حتى الآن لم يكسرها بالكامل.
اللافت في الحراك الحقوقي السعودي أنه لم يأتِ متطابقا مع بعض جيرانه للمطالبة بإسقاط السلطة، ولكنه جاء ليطالب بالقانون التي سنته ذات السلطة، في تحالف واضح بين الطرفين لإثبات الرغبة في مواصلة السير معًا لكن وفق النظام، ما يكشف أن “أكذوبة” المطالبة بإسقاط النظام التي اتهم بها بعض الإصلاحيين، لم تنطل على الكثير، وإن كانت صدرت بعض التصريحات من مجموعات فهي مذمومة ومرفوضة شكلا ومضمونا، ولم يرحب بها الطيف الأوسع من الحقوقيين السعوديين.
هذا الرغبة الحقوقية في تطبيق النظام، والتأكيد الدائم على التعاضد مع السلطة والتمسك بوحدة الوطن، جعلت نظام الإجراءات الجزائية يتحول إلى ما يشبه “العالة” على المشرع، الذي باتت تصرفاته تثبت أن هناك حالة من الندم على تشريع هذا النظام، حتى لا يقع في مأزق رفض مطالب شعبية لتطبيق النظام!
إن تضخم ملف المعتقلين، والذي يتكأ على نظام الإجراءات الجزائية في مشروعية مطالبه، تنبأ بتضخم “مقلق” قد يخلق أزمة يصعب حلها، وذلك نظرا لتعود الناس على النزول للشارع، وخلق تجمعاتهم بالطريقة التي يرون أنها قادرة على إحراج السلطة بشكل أو بآخر. هذا التأزيم الذي خلقه عدم تطبيق النظام، لن يطفئ فتيله سوى تطبيق النظام، بحكم أن أبر التخدير لم تعد بعد الربيع العربي تؤتي أؤكلها، وشيئا فشيئا باتت النخبة التي صنعتها السلطة، كرجال دين وكتاب صحفيين، في مأزق لفقدانهم السيطرة على الجموع المتلقية، ناهيك عن التأثير عليها. لذلك يجب أن ندرك أننا في أزمة نظام ولا شيء آخر. حيث إن الكل ينبذ الإرهاب ويطالب بمعاقبة كل من له يد في تلك العمليات الإجرامية، ولكن وفق النظام واحترام كيان الإنسان، حتى ولو أخطأ، فذلك ما تحث عليه الفطرة الإنسانية، والشرائع السماوية، والاتفاقيات الدولية، والنظام السعودي المحلي.
(3)
من المعلوم أن الملام في عدم تطبيق نظام الإجراءات الجزائية، وغيره من الأنظمة، هي السلطة السياسية بوصفها المشرع القانوني في المملكة. ولكن في ظل انعدام منابر قانونية للتعبير عن صوت الشعب لإحداث التغيير، يصبح هذا اللوم في نطاق التأثير الضيق، الذي لا يتجاوز مرحلة الوعي الشعبي، والتي هي بلا شك، مرحلة محورية ومهمة جدا. لذلك من هذا المنطلق، يجدر أن نلاحظ محاولات السعي لتشويه الحراك الحقوقي من الداخل، عبر أصوات تصنف نفسها أنها مناصرة للحقوق، في حين هي في ذات الوقت تطعن الحقوقيين في ظهورهم، خاصة في ملف المعتقلين.
ينطلق منهج هؤلاء عبر المزايدة على الوطنية، من خلال تأييد كل ما من شأنه قمع الإرهاب، وهذا الأمر وإن بدء للوهلة الأولى محمودا، إلا أنه يدخل فيما بعد في نفق مظلم يسقط الواحد منهم تلو الآخر، حيث يعد ذلك النفق الامتحان الفعلي لترجمة معنى أن تصنف نفسك بأنك حقوقي، وترفض الظلم وتنافح من أجل تطبيق النظام.
في ملف المعتقلين وقعت المفاجأة من بعض من يصنفون أنفسهم بأنهم حقوقيون، بسبب سقطوهم في امتحان نظامي واضح المعالم. إذ أن من الأساسيات القانونية، العلم أنه مهما بلغت فداحة أي جريمة كانت، فإن كافة الأنظمة والقوانين تحدد لها عقوبة رادعة، مع وضع آلية مناسبة لذلك، في رفض ضمني لنظام الغاب والفوضى. هؤلاء الحقوقيون عكسوا الآية تماما، وراحوا يقدمون أنفسهم بصورة المبررين للأخطاء والتقصير، ولكن هذه المرة على أشلاء الضحايا الذين كانوا يتأملون بهم خيرا، فخيبوا ظنهم بعد عجزهم من الوصول إلى أساسيات الحقوق، ألا وهي الانتصار من أجل تطبيق الحق والعدل عبر بوابة النظام، والتي لا تأتي من بوابة تلميع الأفراد والتكسب من المواقف.
وكان أسوء ما قام به هؤلاء هو نشر ثقافة “التضليل”، وذلك عبر الضرب على وتيرة الحالة الإنسانية التي خلفها الإرهاب. تلك الحالة التي تعد نقطة اتفاق مشترك بين كافة الأطراف، ولا يوجد أي اختلاف حولها؛ إذن: لماذا يُركَّز عليها؟! المغزى واضح، وهو رسم صورة ذهنية في عقل المتلقي أن مناصري تطبيق النظام في ملف المعتقلين لا يملكون حسا إنسانيا ولا يريدون للعباد والبلاد الأمن والاستقرار!.
وهذه السذاجة التحليلية من قبلهم، تثبت أن حاسة التطبيل والردح الفارغ وصلت أوجها؛ لأنهم وصلوا لمرحلة العجز عن فك “شفرة” النظام الذي ينص على مشروعية ما يطالب به كافة الحقوقيين في هذا الملف. حيث يقف نظام الإجراءات الجزائية كحجر عثرة تحول دون إكمال مسيرتهم في المزايدة الوطنية، ما جعل هذا النظام عالة لا يجد لها هؤلاء الذين تحالفوا مع “الجوقة” الإعلامية كما سماهم الرمز الوطني محمد سعيد طيب، إلا رمي التهم الباطلة التي تنفر الناس منهم، كالقول: “إنهم من الإخوان المسلمين..” أو “مجموعة من الشيعة وينفذون أجندة إيرانية في المنطقة..”، أو “يتلقون دعما من قطر..” وغيرها من الجمل المضحكة التي تثبت حالة “الانفصام” التي يعيشها هؤلاء، وتمنعهم عن المناظرة في مشروعية هذا المطلب بالأدلة والمستندات القانونية، لا بتهم التخوين البالية.
إنه لمن المؤسف أن يجد الحقوقيون أن أول من يولي لهم الظهر، هم فئة من يعلنون تقاطعهم معهم في نصرة حقوق الناس والمغلوبين على أمرهم. إذ أن تولي هؤلاء عن الوقوف بجوارهم تعد أشد ألما من أي طرف آخر، بحكم أن ذلك الفعل يشق الصف، ويضعف القوى الحقوقية التي يفترض أنها في مرحلة التشكل.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يقوم به هؤلاء المحسوبون على الحقوقيين من مناصرة تجاوز النظام، تثبت الخلل الذي يعتري فهمهم؛ الذي لم ينضج حقوقيا بعد، إذ ما زال يحمل ترسبات التعصب والفئوية، والفكر العشائري القائم على هرمية الرأي الجمعي الذي لا يبالي بآراء الأفراد وحقوقهم.
وهذا المثال يعيدنا إلى نقطة الصفر في مناقشة حقيقية الوضع الحقوقي في السعودية، ليس فقط من ناحية الكم، ولكن أيضا من ناحية النوع، وكيف أن بعض حقوقي السعودية باتوا صوتا للسلطة، في حين يوجد أناس يقمون بهذه المهنة أفضل منهم؛ إذن: ما الداعي لتقمص هذا الدور؟. أقول من باب إحسان الظن، أن مرد ذلك جهل بعضهم وقلة تدبره في المسألة، مع أملي ألا يكون هدف بعضهم التكسب من المواقف والصعود على أكتاف المظلومين، الذين يحتاجون الآن دعمهم أكثر من أي وقت مضى.
نشرت في مدونة الكاتب
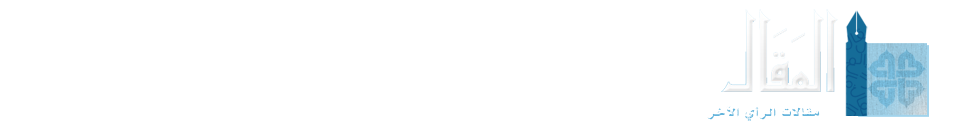











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك