
عن السلطة التي تعتقل الرأي!
 30 نوفمبر, 2012
30 نوفمبر, 2012  2 تعليقان
2 تعليقان
في معظم الأقطار العربية يستطيع معظم المواطنين -مهما اختلفت خلفياتهم و اهتماماتهم- أن يعد لك معتقلًا واحدًا على الأقل تخصصه السلطة لمن يقولون ” لا “، و ربما للذين يقدمون نصحًا وطنيًّا صادقًا، أو يدلي برأيه في مسألة عامة تعلو عن الحد المسموح به. على حين في العالم الغربي و غيره لا تظهر هذه الحالة ( اعتقال الرأي ) إلا في أفلام تعرضها السينما عن القرون الوسطى في روما أو أثينا أو الشرق!
حين تقيم دولة ما معتقلا للرأي وتديره فإنها تقدم نفسها بوصفها أكبر منتهكا لحرية مواطنيها داخل حدودها، الأمر الذي يعني أن الحرية في مثل هذه الأقطار مسألة سياسية بامتياز قبل أن تكون وجودية أو حتى دينية. إن ممارسة الحكم السياسي من خلال ( شخص الدولة ) هو التعين الأوضح والأشهر للسلطة في حياتنا بل قد يكون هو المعبر لممارسة سلطان روحي وأيدلوجي ( قوة ناعمة ) تستخدم فيه السلطة موارد معنوية ( كالدين ) ومادية ( كجهاز الأمن ) تعيد بها إنتاج ذاتها وتكريس نفوذها، نذكر جميعًا أن الأمويين دعموا ظهور الجبرية الأولى ( حيث يتنصل الإنسان من نتائج أفعاله بالحتمية والجبر ) بل شنوا حربًا على الصوت العقلاني الحر في عرض عقيدة الإسلام، الذي ظهرت بوادره على يد أمثال : الجعد بن درهم، وعمرو بن عبيد، وغيلان الدمشقي وغيرهم .
يقول الجابري راصدًا تقدم السلطة إلى ميدان الثقافة: (وإذا كانت الثقافة – أي ثقافة- هي في جوهرها عملية سياسية، فإن الثقافة العربية بالذات لم تكن يوما من الأيام مستقلة ولا متعالية عن الصراعات السياسية والاجتماعية، بل لقد كانت باستمرار الساحة الرئيسة التي تجري فيها الصراعات. إن الهيمنة الثقافية كانت النقطة الأولى وأحيانا الوحيدة المسجلة على جدول أعمال كل حركة سياسية أو دينية بل كل قوة اجتماعية تطمح إلى السيطرة أو تريد الحفاظ عليها ). إن السلطة التي تحضرُ الحرب على الحرية في ثقافتها لابد أن تكون معتقلات الرأي شاخصة في أرضها، إنه مقتضى الالتزام بالآيدلوجيا!
و لذا نسأل: ما حكاية الدولة العربية الحديثة حتى تظهر أكبر مهدد لحرية مواطنيها ( بقوتها المادية بالذات ) في حين تعد الدولة في الغرب نفسها مسؤولة عن صون هذه الحريات و رعايتها ؟!
عن السلطة :
عقلانية الإنسان دعته إلى البحث عن النظام والانضباط في حياته لجعلها أكثر إنتاجية وأقل فوضى، في الجانب السياسي أدى ذالك لفرز الناس لطبقتين: حكام ومحكومين. ليس من المعقول أن يكون الجميع حكاما، و ليس من المعقول أن يكونوا جميعًا محكومين. تنبه لذالك شاعر عربي قديم حين نظم:
( لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا )
للسلطة (أي سلطة) حدود ثلاثة:
1 ) آمر ( حاكم ): له الحق / الشرعية في إصدار أمر إلى مأمور / محكوم ما.
2 ) مأمور ( محكوم ) : عليه واجب السمع والالتزام.
3 ) وسيلة الاتصال بينهما ( أمر ) : و غالبًا ما يكون التزاما بسلوك ما ( سياسي، اقتصادي، خدمي … ) يرى الآمر أن تطبيقه يعود بالنفع للصالح العام.
و لأجل نجاعة هذه السلطة واستقرارها وخدمتها للصالح العام فنحن بحاجة إلى اعترافين متبادلين بين طرفي هذه السلطة ( الآمر و المأمور ) :
أولا: اعتراف من الطرف الأول ( الآمر ) بأن ما يصدر منه من أمر للطرف الثاني ( المأمور ) إنما حصل له من حق شرعي فيه. هذا الحق تطور حتى صار هو التفويض الممنوح للحاكم ( الآمر ) من قبل المأمورين ( المحكومين ) بأن يحكمهم عبر آليات ومؤسسات معينة ( أصل فكرة الديمقراطية ). وبخصوص الآمر ( الحاكم ) فالموضوع ليس مقتصرًا على هذا الحق بل يجب أن يمتلك الحاكم قدرة تجعل سلطته ذات معنى وفعل حقيقي يشعر به الناس وحضور في حياتهم لصالح حياتهم وليس مجرد سلطان رمزي ( يُعبر عنه بسيادة الدولة الوحيدة على أرضها). وحتى لا تتحول السلطة إلى تسلط لابد أن يعترف الحاكم ( صاحب القدرة الآمرة ) بأن الطرف الواقع تحت سلطته ( المأمور أو المحكوم ) يتمتع بالحرية وينقاد لأوامره مختارًا، فهو يختار لأنه حر. على العكس من السلطة ( القدرة الآمرة ) في حالة التسلط التي تنكر على المأمور حقه في الاختيار بل ربما تعده شيئا منزوع الإرادة والحرية.
ثانيا: اعتراف من الطرف الثاني ( المأمور ) بأحقية الطرف الأول في إصدار الأمر وتعهده بالتنفيذ وأن لا يكون اعتراضه – إن وجد – إلا تحت سقف النظام العام ( المتفق عليه سلفا) و عبر آلياته مؤسساته. من الطبعي أن فطرة الإنسان حين يكون مأمورا ستقوده إلى هاجسين اثنين:
الهاجس الأول: عن مصدر شرعية السلطة الحاكمة في ممارسة الحكم، أي عن تبريرها. لماذا أصبح هذا الطرف بالذات هو صاحب الحق في إصدار الأمر وليس أنا ؟! في التاريخ العربي تفاوتت مبررات منح الشرعية لجهة ما أو تبرير سلطة قائمة لشرعيتها، فمن التقديم النبوي للإمامة ( أبو بكر ) إلى المواكلة الحسنة والمشاربة الجميلة ( معاوية ) إلى إمام الرضا من آل بيت محمد ( العباسيين ).
الهاجس الثاني : مدى هذه السلطة ونطاقها. هل يحق لهذه السلطة حتى بعد نيلها الشرعية أن تأمرني بإنهاء حياتي مثلا أو تنهيها هي بنفسها أو تأخذ من مالي ما شاءت أو تمنعني من التنقل وتقيد حريتي… أم أن لذالك سقفا محددا!
تجاوزت الأمم التي حازت بنفسها على الديمقراطية إشكال المسألة السياسية ( أم المسائل ) بأن جعلت المحكوم ( متلقي الأمر والخاضع للسلطة) هو مانح الشرعية ونازعها ولهذا تتم بشكل دوري هناك ما يشبه الأعراس للديمقراطية تحضرها شعوبٌ عربية متابعةً فقط. و تقام لأجل ذالك هناك المؤسسات والأجهزة ( الإدعاء العام و القضاء مثلا) التي تُعنى بفحص مدى أحقية هذا الحاكم بهذا الحق في ممارسة السلطة وإصدار الأمر ومطالبة العموم بالالتزام والتنفيذ ومعاينته. يُضاف إلى ذالك أن للمحكومين ( عبر الأحزاب المعارضة والنقابات المهنية ووسائل الإعلام المستقلة … ) الحق في مساءلة هذا الحاكم على الملأ وأمام الناس.
إلا أن الحالة العربية الراهنة سياسيًّا طالما ذكرتني بمحطتين سوداويتين ( بمقياس الحاضر ) في الفكر السياسي … أعني الإيطالي نيكولا ميكافيلي والإنجليزي توماس هوبز.
نيكولا ميكافيلي .. ( الأمير ) قوياً مخادعا:
كان ماكيافيلي ( 1469 – 1527 ) ابن واقعه وزمنه وتجربته. لقد كتب ماكيافيلي كثيرًا ودوَّن من أجل إيطاليا التي مزقها الضعف والانقسام. لقد هاله ما أصاب بلاده وأراد أن يقدم لها ما كان يظنه طوق النجاة لها. كتب ماكيافيلي كتابه الأشهر ( الأمير ) في عزلته بعد حياة حافلة بالحركة والسياسة والدبلوماسية وأهداه إلى الأمير لونرزو دي ميديتشي حاكم فلورنسا وكأنه يقول له دونك هذا الكتاب إنه سيف في إحدى يديك ودرع في اليد الأخرى. و( الأمير ) سفر صغير يتنوع الحديث في فصوله من ” أنواع الإمارات ” إلى ” أنواع الجيوش ” إلى الدعوة لتوحيد إيطاليا”.
يقول ماكيافيلي في القسوة والرحمة في شخص الأمير/ السياسي : ( لذا يجب على الأمير ألا يخشى الاتتصاف بالقسوة بدعوى الحفاظ على إخلاص رعاياه ووحدتهم، لأنه بتقديم أمثلة قليلة يستطيع أن يثبت للناس أنه أشد رحمة من أولئك الذين من فرط رحمتهم يفسحون المجال لشيوع الفوضى التي تنجم عنها كل أنواع الجرائم والنهب ). أما حين المفاضلة بين المحبة والمهابة في قلوب الناس فيقول: ( وجوابي عن ذالك أن الإنسان يود لو يكون محبوبا ومهابا في الوقت نفسه، لكن مع استحالة الجمع بين كلتا الفضيلتين أرى أن الأكثر أمنا بالنسبة إلى الأمير هو أن يكون مهابا على أن يكون محبوبا). كما أنه ينصح الأمير بأن لا يثق بأقوال الناس في حبه والإخلاص له : ( فالأمير الذي يثق في أقوالهم دون أن يتخذ احتياطاته اللازمة إنما يحكم على نفسه بالدمار، لأن الصداقات التي تكتسب بالمال وليس بعظمة الضمير ونبله تُشترَى إلى حين، ولكن لا يمكن امتلاكها إلى الأبد، وثَم تتضح هشاشتها عند أول محك يعترضها. والناس عادة لا يترددون في الإساءة إلى الأمير المحبوب بقدر ترددهم في الإساءة إلى الأمير المهاب. و مرد ذالك هو أن الحب يكون مؤيَدا بالتزام سرعان ما يتخلى عنه البشر لسوء طويتهم عندما يجدون من مصلحتهم الشخصية القيام بذلك، لكن المهابة تكون مؤيَدة بخوف من العقاب لا يزول أبدا). أما حين يكون الأمير بين جيشه وقواته فإن ماكيافيلي ينصحه : ( فإنه من الضروري جدا أن يتصف بالقوة، لأنه من دونها لن يتمكن من الحفاظ على وحدة جيشه واستعداده للحرب ). أما حين يدخل الأمير في صراع فيشير عليه ما كيافيلي بالتالي : ( هناك إذن طريقتان للصراع: إما بواسطة القوانين أو بواسطة القوة. الطريقة الأولى من شيمة الإنسان في حين الثانية من طبيعة الحيوان، وما دامت الطريقة الأولى لا تفي بالغرض دائما فإنه من الملائم اللجوء إلى الوسيلة الثانية. لذالك يجب على الأمير أن يجيد استعمال أسلوبي الحيوان والإنسان على حد سواء)! ويقول داعيا إلى المكر والإرهاب: ( لذا ينبغي للمرء أن يكون ثعلبا للتعرف على مكامن الشَرَك، وأسدا لإرهاب الذئاب). أما الوعد والميثاق فليس على الأمير – حسب ميكافيلي – الوفاء به : ( ومن ثم فالأمير العاقل لا يستطيع كما لا يجب عليه أن يلتزم بوعد قد يعود عليه بالضرر… لقد كان الأمراء دائما يجدون الذرائع دائما لتبرير نقض العهود.). وماكيافيلي يدعو الأمير لإخفاء عيوبه وسقطاته مستغلا سذاجة معظم الناس : ( لكن من الضروري أن يتعلم المرء بالموازاة مع ذالك كيف يخفي هذه الطبيعة، و كيف يكون مخاتلا متصنعا بارعا، فمن فرط سذاجة الناس وانصياعهم للضرورات الراهنة ترى عديدًا من المخادعين يجدون من تنطلي عليهم أحابيل الخديعة ). ويدعوه للتظاهر أيضا وبالاستعداد للانقلاب على ما تظاهر به : ( إنه من الأفضل أن يتظاهر على الأخص بالرحمة والوفاء والإنسانية والنزاهة والتدين وله كذالك أن يتصف بجميع هذه الفضائل حقيقة شريطة أن يحافظ على درجة عالية من التأهب اللازم للتخلي عن كل تلك الصفات والعمل بضدها عند الاقتضاء). ويبرر ماكيافيلي مثل هذا التظاهر قائلا: ( فعموما يُصدر الناس أحكامهم من خلال ما تراه أعينهم وليس ما تلمسه أيديهم، بحكم أنهم جميعا ينعمون بحاسة البصر، لكن القليل منهم من يستطيع تلمس الحقائق بنفسه. وعليه فالجميع يرون مظهرك، لكن القليل هم الذين يستطيعون إدراك حقيقتك ). كذالك يدعو ماكيافيلي إلى بناء الجيوش وغزو العدو وتحقيق النصر وذالك في معرض حديثه عن الأعمال التي تجلب التقدير للأمراء وبسبب ذالك يثني على ملك إسبانيا فرناندو الذي طرد العرب بقسوة من غرناط : ( ولنا في وقتنا الحالي مثال في شخص فرناندو دي أراغونا ملك إسبانيا الحالي. فهو يستحق لقب الأمير بامتياز… ففي بداية حكمه هاجم غرناطة مدشنا بذالك الأساس الذي ستنهض عليه دولته لاحقا).
يُحسب لهذا السياسي الإيطالي أنه استمد أفكاره وتصوراته من التاريخ البشري والتجربة السياسية المحضة ( بذرة العلمانية سياسيا) وليس من تعاليم اللاهوت الكنسي المفارقة للواقع فبث بذالك ورح المواطنة حيث الولاء للوطن / الأرض ووضع لبنة كبيرة في طريق توحيد إيطاليا. لكن يُحسب عليه أيضا أنه حول الدولة إلى كائن مخيف من القوة والخديعة بشكل نزع عنها كل أخلاقية تجاه مواطنيها مما يجعل شرعيتها الأخلاقية محل تساؤل وشك كبيرين.
توماس هوبز .. الحاكم بسلطة مطلقة :
قد تبدو واضحة هي الظروف التي أحاطت بالفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز ( 1588 – 1679 )، التي أثرت عليه في عمله السياسي الكبير ( اللفياثان ). هذا العمل الذي أطلقه هوبز من تصوره التشاؤمي عن طبيعة الإنسان وسلوكياته العدوانية الغرائزية تجاه محيطه البشري الأمر الذي أدى بهوبز إلى صرامة في تكريس سلطة مطلقة ( شمولية بلغتنا السياسية اليوم ) يعتقد أن بها تتحق مصلحة الأفراد و تتم حمايتهم من بعضهم.
ففي بداية القرن السابع عشر اشتد الصراع في المملكة الإنجليزية بين التاج والبرلمان ثم تطور لاحقاً إلى حرب أهلية. كان وقف هذا الصراع والبحث عن أسس استقرار سياسي متين يشغل بال الفيلسوف الإنجليزي. أضف إلى ذالك أن هوبز في شبابه اشتغل بترجمة أعمال تروي عن الحرب البلوبونيزية التي دارت رحاها بين المدن اليونانية. لا شك أن هذه الخلفية بظرفيها ( الإنجليزي المعاصر واليوناني التاريخي ) ستلقي بظلالها على فكر الفيلسوف الإنجليزي وتصوره للسلطة التي لابد أن تكون مطلقة على هذه الجغرافيا من الأرض أو تلك حتى تعيد النظام وتمنع الإنسان من الطيش وخلق الفوضى باسم الحفاظ على بقائه.
رأى هوبز أن الحالة الطبيعية الأولى للمجتمعات هي حرب الجميع على الجميع، حيث إن كل واحد مسكون بهاجس البقاء والخشية على وجوده من تربص الآخرين فيلجأ للقوة والعنف من أجل أن يردعهم، وحينها تكون الفوضى. ومن الطبيعي في حالة كهذه أن تنعدم منظومة القيم التي تُعرف الظلم والعدل والإنصاف والاعتداء… فلا صوت حينها يعلو على صوت غريزة البقاء مما يعني حينها أن لكل واحد أن يرفع صوته عاليا مخبرا عن حقه في إرضاء غرائزه ورغباته مهما كانت تقوم على حساب الآخرين.
من الواضح أن عقلانية الإنسان لا تتحمل حالة الاجتماع البشري الأولى كما تصورها هوبز. إنها حياة غير منتجة ولا ذات معنى بل تحمل فناءها داخلها. إن تبادل الصراع بهذا الشكل مع الآخرين لا يحقق الأمن للإنسان ولا عيشه لنفسه ولا للأجيال التي ستعقبه. يقترح هوبز أنه بدل أن يتبادل الناس الخوف بهذا الشكل عليهم أن يتبادلوا التنازلات ويبذلوها لحاكم وحيد ( فرد أو مؤسسة ) صاحب سيادة على هذه الجغرافيا وعلى المجموع البشري الذي يسكنها. صاحب السيادة هذا ينزع من كل واحد الاستجابة لغريزته الأولى في التربص بالآخر والريبة فيه والنتيجة هي أن يحوز الناس على الحد الضروري الذي يأمنون به على حياتهم. من الواضح هنا أنهم لا يفعلون ذالك ليتعاونوا مع بعضهم بل من أجل اتقاء شر بعضهم، وكأنه عقد ( صريح أو ضمني ) ( مكتوب أو محفوظ في الصدور ) يتمسك به الجميع خوفا مما يهدد الحياة ويقوض مصالح الناس. الناس في نظر هوبز يجب أن يقوموا بهذه التنازلات لصالح الحاكم من أجل مصالحهم الخاصة، هذا الحاكم بدوره يستلم مقاليد الحكم بسلطة مطلقة لا يقيدها شيء وهو يحوز على ذالك ليكون وحده مسؤولا عن مصالح الناس وأمنهم فالتعدد هنا قد يعيدنا لحالة الفوضى الأولى. يشبِّه هوبز هذا الحاكم لأمر الناس بالوحش الأسطوري ” اللفياثان ” الذي يملك قوة مطلقة ( في إشارة لسلطته المطلقة ) وعدم خضوعه لإرادة من خارجه، جسم هذا الوحش الضخم يمثله الجمهور الغفير الذين تعاقدوا ورأسه هو الحاكم المطلق الذي يتنازلون له.
بالرغم من ازدهار الأفكار حول دولة المواطنين الأحرار والديمقراطية وفصل السلطات وتقييد التنفيذي منها بالقضائي والتشريعي وحفظ الحقوق و لحريات العامة إلا أن أعمال توماس هوبز في فلسفة السلطة تظل أساسية على الدوام.
هل الدولة العربية الحديثة ماكيافيلية عرجاء وهوبزية عوراء ؟!
لم يتوقف الزمن السياسي الأوروبي عند ماكيافيلي و هوبز بل تقدم إلى الأمام مهذبا التطرف في رؤية الرجلين للسلطة واقتراحاتهم لممارساتها. فعلى المستوى الفكري تراكمت أعمال الفلاسفة الأوروبيين منطلقة من حاجة الواقع الأوروبي لحل معضلاته السياسية الخانقة، و كان على رأس تلك الأعمال تلك التي مهدت للثورة الفرنسية : العقد الاجتماعي ( روسو ) وفصل السلطات من أجل تكريس الحرية وصونها ( مونتسكيو ) ولا وطن دون مواطنين أحرار ( فولتير ). أما على المستوى الشعبي فقد كانت الثورة الفرنسية ( وصداها في القارة الأوروبية الذي استمر حتى منتصف القرن التاسع عشر ) ذروة تحول هذه الأفكار إلى قوة مادية غير بها الناس واقعهم.
إن وجود معتقل الرأي ( المكان ) ومعتقل الرأي ( الإنسان ) هو الدليل الكافي وحده لإثبات تبني الدولة العربية الحرب على حق مواطنيها في الحرية. وكم تبدو الدولة دون حرية مواطنيها ضعيفة متداعية! و كم تبدو أيضا مجرد أداة لهيمنة طبقية و اجتماعية !
هذا ليس اتهاما باطلا حتى خارج السياق العربي، فهو السلوك المطرد للسلطة منذ أن أقامها البشر في واقعهم ما لم يُقبض على يدها بالقانون الذي يحمي حرية الأفراد. يقول جون ستيوارت مل ( 1806 – 1873 ) في كتابة عن الحرية : ( إن الصراع بين الحرية والسلطة هو أحد الصفات الأكثر وضوحا في أجزاء التاريخ المعروفة لدينا منذ القدم ). ويحضر مل الحرية إلى التعين السياسي لها : ( كان يُقصد بالحرية الحماية من طغيان القادة السياسيين، كان يُنظر إليهم – ما عدا بعض الحكومات الشعبية في اليونان – على أنهم في وضع عدائي بالضرورة أو في موضع الخصم من الناس الذين يحكمونهم ). أما عن النضال من أجل الحرية فهو يراه بالدرجة الأولى ضد السلطة السياسية : ( كان هدف الوطنيين هو وضع حدود للسلطة التي سيعاني المجتمع من ممارسة القائد لها، و هذا بالتحديد ما قصدوه بكلمة حرية وقد سُعِيَ إليها بطريقتين؛ الأولى من خلال الحصول على اعتراف ببعض الضمانات التي يُطلق عليها اسم الحريات والحقوق السياسية التي كان انتهاكها من قبل الحاكم يعد خرقا للواجب والذي اذا ما انتهكه الحاكم فإن المقاومة المحددة أو التمرد أو العصيان ستكون مبررة. أما الوسيلة الثانية، وهي متأخرة بشكل عام، فهي نقاط المراقبة الدستورية التي أصبحت من خلالها موافقة المجتمع شرطا ملزما لأفعال السلطة الأكثر أهمية). ويتحدث مل عن علاقة الناس بالسلطة التي تحكمهم: ( جاء زمن في تطور الشؤون الإنسانية أصبح الناس فيه لا يرون ضرورة طبيعية في وجوب أن يكون حكامهم سلطة مستقلة، مناهضة لهم في المصالح. و بدا لهم من الأفضل – أي الناس – بكثير أن يصبح الحكام المتعددون للولاية مجرد مستأجَرين منهم أو مندوبين لهم يمكن عزلهم وإلغاء صلاحيتهم في أي وقت. بهذه الطريقة فقط، كما يبدو، كان بوسعهم امتلاك ضمان كامل بأن سلطات الحكومة لن تتعرض لهم بسوء يضر مصالحهم ). ويتضح القول أكثر لدى مل حين يرغب في جعل الناس سلطة على أنفسهم لأنهم لن يطغوا على أنفسهم و لن تنزع أمة إرادتها من ذاتها : ( ما كان ناقصا آنذاك، هو أن يُعرَّف الحكام مع الشعب ووجوب أن تكون مصلحتهم و إرادتهم هي مصلحة الأمة و إرادتها. لا تحتاج الأمة ما يحميها من إرادتها، وليس هناك من خوف من طغيانها على نفسها ).
لقد كانت أفكار جون ستيوارت مل أيضا لحظات مهمة في تهذيب التصور وترشيده ( الميكافيلي / الهوبزي ) عن السلطة، فمل أراد أن يدافع عن الحرية في وجه السلطة بتعينها السياسي ( الدولة ) وذالك بأن سعى إلى إلغاء الحدود الفاصلة بين سلطة مستقلة مفارقة للجمهور تسوسه بالقوة حسب مصالحها وبين الناس الواقعين تحت حكمها. الفرد كي تُحمَى حريته لدى مل يجب أن يمارس الحكم ليس بشخصه بالضرورة و لكن بواسطة أشخاص آخرين، إنها حكومة ذاتية، من ذات الفرد و ليست من خارجة مفارقة له و مستقلة عنه!
أما في الزمن السياسي العربي فحدث ما يشبه التوقف التلقائي عن لحظتين : ماكيافيلية عرجاء حيث تمارس الدولة ( شخص السلطة ) القوة والخديعة ضد الجمهور العام من مواطنيها وليس ضد خصومها والنافذين فيها ( لاحظ أن ماكيافيلي امتدح الأمير الاسباني إذ حارب العرب)، ولحظة ثانية هوبزية حيث تصر الدولة العربية على سيادة داخل حدودها ضد مواطنيها ( وليست ممثلة لهم ) تصل هذه السيادة حد الغرائبية ( في بعض البلدان العربية تحتاج لمراجعة المخابرات حتى تزاول نشاط تجاري ) ولكنها تتنازل عن كل هذه السيادية العظيمة إذا ما تعلق الأمر بما يُسمى التزامات دولية ( معبر رفح بين مصر و غزة مثلا).
إن المطلوب ليس العفو أو الإفراج فقط عن معتقل رأي هنا أو هناك، المطلوب هو نفي هذه الظاهرة من الحياة العربية بحيث لا تتكرر ولا تحدث مرة أخرى و تصبح فقط ماضيا للاعتبار والذكرى. ولا بد أن يُعبر إلى ذالك بتفتيت السلوك ( الميكافيلي / الهوبزي ) المسخ في الدولة العربية الحديثة، هذا السلوك الذي لا تتعرف به الدولة كدولة لجميع مواطنيها بنفس القدر الذي أيضا جعل الدولة كائنًا قويًّا مخادعًا سلطويًّا ضد رعياها تحديدا!
إنه جذر المشكلة؛ غياب دولة المواطنين المتعاقدين الأحرار عربيًّا.
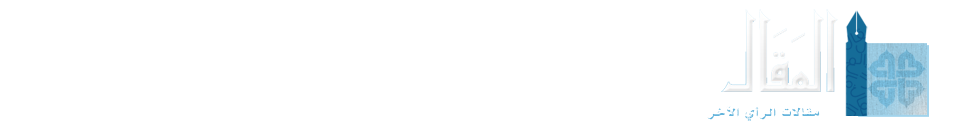











2 تعليقان إلى “عن السلطة التي تعتقل الرأي!”