
فضاؤنا ورفض العلم الحديث: قراءة لظاهرة عبدالكريم الحميد (1من 2)
 26 ديسمبر, 2011
26 ديسمبر, 2011  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
يشير مؤرخو العلم (الغربيون) إلى إنشاء الجمعية الملكية البريطانية في القرن السابع عشر باعتبارها أولى خطوات مأسسة العلم الحديث وتحوله من عمل مدفوع بالشغف الفردي وتشجيع حكام وأغنياء وأصحاب نفوذ إلى عمل احترافي يتم تبعا لقواعد تنظم إنتاجه. يدرس سوسيولوجي العلم روبرت ميرتون دوافع الانكباب على إنتاج العلم في تلك الحقبة (حقبة مأسسة العلم في بريطانية البروتستانتية في القرن السابع عشر) مستعينا بمنظور فيبر حول الأخلاق والإنتاج مفترضا (أي ميرتون) أن أولئك الرجال الذين شغفوا بالعلم بحثا وتنقيبا وإنتاجا ودفعوا العرش البريطاني لتحويل شفغهم لمهنة إنما كانوا يقومون بذلك العمل (أي العلم) بدوافع دينية. فالعلم بالنسبة لهم، وبحسب ماهو متوفر من شروحهم، إنما كان طريقا لعبادة الخالق عبر التأمل في بديع صنعه وكمال خلقه. فالنفس تزداد إيمانا وقربا إلى الله كلما عرفت أكثر عن إعجاز الخالق. تبدو هذه الصورة مختلفة عن الدوافع الأخلاقية والنظم المعتقدية لعلماء الزمن الحالي. وإذ يكن من المعروف أن العلم منذ القرن التاسع عشر بدأ يقترن شيئا فشيئا بالتقنية، وبالتالي بالبعد العملي الأداتي، ويفارق صومعته النظرية الخالصة، فإنه من المعروف الدارج أيضا أن العلماء المتأخرين، علماء القرن التاسع عشر وما بعده أقل إيمانا من أسلافهم وأكثر إلحادا. وفي دراسة إحصائية اطلعت عليها زمن الطلب عن حملة جوائز نوبل في العلوم والطب، يتبين أن أكثرهم كانوا ملاحدة صرحاء، في تناقض بيّن مع علماء عصر النهضة حتى القرن التاسع عشر الذين شرعنوا لـ”ممارسة” العلم بوصفه فعلا تعبديا وبحثا عن الحقيقة الإلهية بعيدا عن خرافات الكنيسة. لقد كانت الدوافع الفلسفية والأخلاقية للعلم الحديث مغروفة من الدين ومستمدة منه، بوصفه النسق الكبير للحقيقة. لكن ومع اكتساب العلم سلطته الخاصة وبنائه لمجاله الذاتي البحت كنتيجة لتطور مناهجه ونظرياته وظهور الإمكانات الأداتية له، خلق العلم شرعيته من داخل ذاته أولا ثم أصبح، في مجتمعات الحداثة، مصدرا للحقيقة، وبالتالي للشرعية، في كافة مناحي حياة الإنسان الحديث. في التجربة الغربية التاريخيةـ قام العلم بإزاحة الدين من ما يسميه فوكو مجال “تدبير الحقيقة”.
لقد اخترت المقدمة أعلاه مسلطا الضوء على علاقة العلم الحديث بالدين في منبع العلم الحديث والحداثة، أي أوروبا، وتحولات هذه العلاقة، من استتباع الدين للعلم إلى استقلال العلم، بوصفه نسقا للحقيقة، ومزاحمته علماء العلوم الطبيعية لرجال الدين في المجالات التي كانت تاريخيا حكرا على رجال الدين. لكن ماذا عن علاقة العلم (الحديث) بكل من الدين ومجالات الحقيقة لدينا نحن المسلمين، إذ نشكل، بحيزنا الجغرافي (أي جغرافيا المجتمعات المسلمة) القسمة الأخرى (غير الغربية) من جغرافيا الديانات السماوية من ناحية ومن ناحية ثانية فإن العلم الحديث لم ينبنِ تاريخيا عندنا، بل كان حين وصلنا في حالة من النضج واشتداد العود بما أهله ليكون مستقلا حرا متعاليا عن المجال الديني بل وحتى هجوميا مكتسحا. سأتناول في هذه الورقة ظاهرة الرفض المطلق للعلم الحديث بمسوغ ديني في مجتمع إسلامي. منطلقا من إطار تحليلي يرى أن “الحكاية” العلمية فُهمت بوصفها تهديدا لـ”الحكاية” الدينية. سيتم هذا العمل من خلال تناول ما تيسر لي الاطلاع عليه من أعمال الشيخ عبد الكريم الحميد في هذا الخصوص محاولا رسم قبة العمومية والذيوع من هذه الظاهرة الشديدة الفردية و الفرادة.
الدين والعلم لدى المسلمين
ليس من السهل تاريخيا رسم خيط واضح لعلاقة المسلمين بالعلم خلال القرون الخوالي. ولئن تميزت الحضارة الإسلامية بحملها للعلم اليوناني وترجمته والاشتغال عليه والإضافات إليه ما يجعل المسلين هم حملة العلم وأهله في القرون الوسطى والذين وقفوا به على تخوم الثورة العلمية، فإن ذلك تم في سياق من المناكدة الدائمة مع تيارات مختلفة من الفقهاء. وبينما كان بعض الخلفاء والسلاطين يشجعون العلم ويبذلون المال في دعمه، فإن ذلك كان يتم دائما باعتباره نشاطا ثانويا تميزت به بعض الفئات الاجتماعية والأقليات الدينية فحسب. ويلاحظ مؤرخا العلوم الاسلامية سيد نصر وجورج صليبا[i] نسقا متشابها لنمو العلوم في الحضارة الاسلامية: سلاطين متحمسون يدعمون أفراد أقليات (مسيحيون أولا ثم إسماعيليون لاحقا) للاشتغال على العلم وإنتاجه ويتعهدون بعزلهم عن المجتمع من ناحية وحمايتهم منه من ناحية أخرى. وتفصح كتابات أهل الحديث، خاصة ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي، وتراث أوسع من هذا يطال الأشاعرة عن جدال وسجال حول تعريف “العلم” و”العالِم”. يقول بن تيمية ” العلم خشية الله يبين ذلك قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء( وكل من خشيه وأطاعه وترك معصيته فهو عالم“. ويقول” العلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر“. كما يقول رادا على الفلاسفة “العالِم في الحقيقة ذو العلم ـ سواء كان العلم علم الشريعة والدين أو غيره من العلوم ـ وإذا أطلق مطلق فقال: رأيت العلماء، أو جاءني عالم فلا يفهم من إطلاقه أصحاب الحرف والصناعات، بل لا يفهم منه إلا علماء الشريعة“. حتى في المجال الاسلامي ما قبل الحداثي وفي أوج الحضارة الاسلامية، كان موضع العلوم غير الدينية قلقا ومصدر أزمة أخلاقية ودينية عفوا عن ارتباط سمعة جل المشتغلين به بالوصم العقدي والمذهبي.
وإذا ما انتقلنا إلى الكيفية التي اُستقبل بها العلم الحديث في عالمنا الإسلامي، فإنه يمكن الإشارة إلى أن بعض مشايخ الأزهر عارضوا تعليم الجغرافيا والطبيعة في مدارس الأزهر، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. يقول الدكتور عبد اللطيف عبد الله في روايته لتأسيس كلية دار العلوم على يد علي مبارك أن الأزهريين “كانوا يرون أن كل علم خرج عن تلك العلوم التي تلقوها في الأزهر، إنما هو كفر بواح وضلال صريح، وأن الاشتغال به عبث لا طائل من ورائه، فكانوا يرمون مدرسي العلوم الأخرى كالجغرافيا والكيمياء والطبيعة وغيرها بالكفر والإلحاد”. ورغم مافي هذا القول من مبالغة، فإنه يصلح كدلالة على الهوة بين مؤسسة عريقة للعلم الشرعي والعلوم الحديثة حين “غزت” ديارنا.
وفي تجربتنا المحلية، فإن التعليم الحديث لم يمر دون تشكك مجتمعي بسبب تدريسه ماهو غير ديني ولغوي من العلوم والفنون. وحضيت الجغرافيا، ربما بسبب ادعاءاتها “الوقحة” والصريحة والمبنية على ثورة كبرينيكوس العلمية، برفض ديني صريح وعنيف. ولعل كتاب الشيخ عبدالعزيز بن باز والموسوم بـ”الأدلة النقلية والعقلية على ثبوت الأرض وجريان الشمس” خير معبر عن هذه الروح المصدومة بمقولات العلوم الحديثة.
لقد شهدت مسألة الدين والعلم لدى المسلمين في العصر الحديث وما زالت تشهد فصولا تتعاقب صفحاتها. ويمكن تقسيم الموقف “الديني”[ii] إلى تيارين عريضين. التيار الأول؛ هو الرافض بشكل جذري للعلم الحديث ومقولاته وفروعه وموقفه من العالم والكون، ولأسميه تيار “الرفض”. أما التيار الثاني فهو ذاك الذي بحث عن طرق لـ”الموائمة” بين المعتقدات الدينية ومقولات العلم الحديث، وأشهر أوجهه خطاب “الإعجاز العلمي” في القرآن والسنة، ولأعطيه اسم تيار “الإعجاز”. لقد مثل التياران، فيما أزعم، ردتي فعل على ظاهرة واحدة هي “غزو” العلم، غزوه لفضائنا الثقافي. وهو غزو تجاور مع غزو الغرب العسكري والسياسي لديار الإسلام، لقد كان غزوا كاسحا ومستمرا. فنابليون الذي اكتسح مصر بالمدافع وقوة النار اصطحب معه العلماء والعلوم أيضا.
اتسمت ردتي الفعل أعلاه، رغم تناقضهما، بالإحساس بالجرح والدفاع. وفيما اتسم تيار الإعجاز بمحاولة الاحتواء وادعاء التعالي، عبر القول بأن كل ما يقوله العلم الحديث موجودا لدينا من قبل، فإن تيار الرفض كان راديكاليا في التعاطي مع مقولات العلم الحديث ومنطقه. وفيما يحمل منطوق العصر على تفوق تيار الإعجاز وتوسعه وانتشاره لدرجة إنشاء المؤسسات له والقنوات الإعلامية واكتساح مقولاته الخطاب اليومي لمسلمي العصر، فإن تيار الرفض محتوم بالهزيمة والانزواء. ويمكن النظر لخفوت معارضة الشيخ بن باز لمقولة دوران الأرض باعتباره علامة على الذبول الحتمي لتيار الرفض. فكلما تحدثن المجتمع كلما ضعف رفضه للعلم الحديث.
وبرغم هذا الذبول والاندحار، ما زلت أعتقد أن ثمة امتداد وجداني ما لتيار الرفض في نفس إنسان المجتمعات المسلمة. أعني، أن هذه الموقف الصادم براديكاليته لتيار الرفض يعبر عن موقف عام في مجتمعاتنا التي ما تزال مأزومة العلاقة بالحداثة. بل إن التأكيد على شرح العلم الحديث وتناول مقولاته من خلال خطاب الإعجاز ليس إلا وجها لهذا الموقف غير المستعد بعد للتسليم للعلم الحديث بتسيد خطاب الحقيقة والسيطرة على مشروعياتها. لذا، أزعم أن ثمة فائدة “واقعية” بدراسة تيار الرفض بوصفها معبرا عن نزوع مكبوت لإنسان التضاد مع الحداثة. وبناء على ذلك، فإن دراسة مؤلفات عبدالكريم الحميد ضد العلم الحديث قد تعبر عن مكنون ما في سائر النفوس التي لم “تقطع” مع أزمنة ماقبل الحداثة[iii]. (يتبع)
خاص بموقع “المقال”
[i] كلاهما ينتمى لأقلية، فنصر إسماعيلي وصليبا مسيحي. لكن هذا لا يكفي لنزع الشرعية عن نتائجهما المثيرة.
[ii] آثرت وصف الموقف بالديني رغم أنه لا يلزم أن يكون صادرا عن رجال دين بل قد يصدر عن رجال علم حديث متدينيين.
[iii] أحب أن أوكد على الموقع الذي أقف فيه من العلم الحديث بوصفه خطاب يُنشأ اجتماعيا وليس بوصفه دائما إجابات الطبيعة على تساؤلاتنا. وبناء على ذلك، فإن رفض العلم الحديث ليس محل إدانة من جانبي.
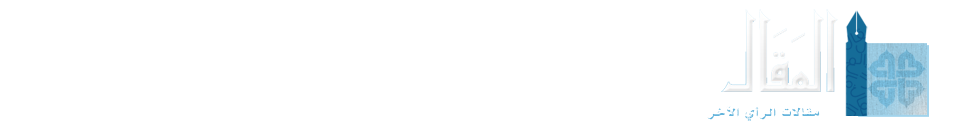











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك