
عبدالرحمن منيف في زمن الثورة
 31 يناير, 2012
31 يناير, 2012  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
“أعرف أن أسلحتي شديدة التواضع، لا يمكن أن تغيِّر أو تقلب، لكن هذا ما أملكه، هذا ما أقدر عليه الآن”.
“إذا كانت رحلات العرب والقدامى، وراء الماء والكلأ فإن رحلة العرب المعاصرين تقوم بحثا عن الحرية والأمن ومحاولة قول كلمات قبل أن ينقضي العمر وتنطفئ الحياة”.
عبدالرحمن مُنيف
تحلّ هذه الأيام ذكرى انطفاء مشعل من مشاعل الحرية العظمى، عبدالرحمن مُنيف، لفتيلٍ ثامن من الغياب.
أبعد من النبوءة، ولا يشبه التوهم، أن يقول عبدالرحمن مُنيف، مشحونا بالأمل، في تسعينيَّات اليأس: “يجب أن يتصدى الجميع لظاهرة القمع، ويجب حشد كل القوى لمقاومتها وإسقاطها، وإلا تحول الوطن إلى زريبة للعزل، وأصبحنا جميعا في حلقة النار الرهيبة، هذه النار التي ستأكل الكثيرين، بما فيها الأنظمة الحاكمة”. كل ما في الأمر، أن مثقفا عجن عصره، وتعب في مجاهله، سابرًا أنينه وصراخه، مؤمنا أن الكلمة هي مَن يمكن أن تكون الرصاصة، التي ستهدم بتوالي طلقها هذه الجدرانَ العالية، حاجبة كل ما هو حرّ وكريم.
ولأنه لم يكن له وطنٌ؛ اتخذ البقعة الكبيرة من الخليج إلى المحيط، من القمع إلى القمع، وطنًا حكاه ورواه، قصّه واقتصّه. إذ هتَكَ منيف مدينة اسمها غريب، لا يفتح الناس خريطة، فرائحة الاستعمار والاستبداد، الذل والتعذيب، واحدة تفوح من أماكن عديدة، فكلنا في الشرق قهر.
قال: “المثقف يصدر عن ضميره، ويفترض أنه يتعامل ضمن رؤية أخلاقية، وإن ما يوجهه قيم التاريخ ورؤى المستقبل، وبالتالي فإن عليه واجبات والتزامات تتجاوز الآني والعارض، ويجب أن يكون شاهد عصره”. ويقول بريخت في إحدى قصائده: “إنهم لن يقولوا: كانت الأزمنة رديئة. وإنما سيقولون: لماذا صمت الشعراء”. فيعلّق منيف: “نعم سيسألون لماذا صمت الشعراء، ولماذا غاب المثقفون، ولماذا امتلأ الوطن بهذا المقدار الهائل من الصمت والسواد؟ إلا إذا تكلم المثقفون، وقالوا بصدق، ما يجب أن يقال، فعندئذ سيتغير السؤال”.
وليس أكثر من كلام منيف وأكبر. ترك آماله وآلامه، حكاياه وتنظيره، على ورق قاله بصدق، دون مواربة أو خوف، لا آكلا على مائدة معاوية، ولا مصليا وراء علي في مكتبة عريضة، عرض مصائبنا وفضائحنا على ورق؛ لأن الكلمة الصادقة كالنجمة في السماء – يقول منيف.
ليس هذا رصدًا لما قاله وحدث، أو لم يقله ثمّ حدث، كما يفعل كثير اليوم، يظن أن هذه الجموع دوتْ في أسماعها مقولة قالها في زمن مضى، والآن يدوي صداها في الهتافات هذه، ثم يمضي في عدّ مآثره الثورية، قبل أن تثور الناس. لا منّة لأحد في أن يثور إنسانٌ لحريته، حين يخرج الإنسان معرضا حياته هدرا، لأدنى رصاصة شبيح، وجسده دهسا لجمل بلطجي مفزوع، فإنه خرج لحرّيته هو، كرامته هو، والمجد له وحده. بغضّ النظر عن استثناءات هذا الكلام، أن كرامة جاري البعيد، من كرامة جاري القريب، التي هي كرامتي قطعا.
لكن الحديث عن المثقف في لحظته الحالية، بكل ما يعتريها مِن … ومِن … وما يعتري المثقف إزاءها من صدق ومقاومة ونضال، هو ما يذكّر بمنيف، الواقف في أعالي لحظته، مذكرا بما كان، غائصا فيما يكون، ومستشرفا ما سيكون، بكل إخلاص، لا يوهنه الخوف والإبعاد، ولا تدهنه المجاملات والتملقات.
مشكلة منيف أنه رحل قبل سبعة أعوام، قبل أن يشهد أبطاله البسطاء أنفسهم يملؤون الميادين، شاهرين قبضاتهم وسلمهم؛ لإسقاط كل ما هو قمعي وقاهر. هؤلاء الأبطال الذي طالما همس لهم عن الحرية والكرامة المفقودتين، والزيف والعار المطبقين، أعلن لهم: “الأنظمة الديكتاتورية مهما بدت قوية ومسيطرة فإنها ذات أرجل طينية وتحمل بذرة فنائها في داخلها”، وحكى لهم السجن الكبير الممتد، وأن الوجود خارجه “شكلي ومؤقت”. “رجب إسماعيل”. صحيح أنه مات مكمودا، لكن بزغ “حامد” من ورائه، “حامد” الآن قد يكون متبوءا منصب رئيس الوزراء. “زكي النداوي” كان بالفعل مهلوسا ومجنونا، جراء الهزيمة، لكنه الآن يفتح عينيه ولا يصدق، فقام فزعا يتوكأ على خيباته، يستدرك ما مضى، ويلحق مصطادا طرائد النصر الممنوحة، لاعنا “الملكة” التي لم يصطد في المستنقعات. “منصور عبدالسلام” عاد للوطن بعد أن تحرر، مجيدا عزيزا في جنانه، يودّ أن يعمل بما مات لأجله “مرزوق”، شهيد رأيه وحريته، ولا ينبغي أن يتكرر “إلياس نخلة”، إنسان الهامش واللاعتناء، حزين من اجتثاث الأشجار من بستانه وقلبه. “عمورية” و”طيبة” و”حران” مدن الصمت الكثيف والخوف، صفيح الفقر المدقع، وواجهات الثراء الفاحش تنتفض وتستدرك وتتنفس هواء لم تشهقه من قبل. ينزل البسطاء والعاديون، من لم نعرف سيماهم من قبل، ولا من بعد، لا تتكرر أوجههم، لكن تتشابه علينا، كما أبطال منيف، اللاأبطال، لا ندري من أين أتوا، لا يعرفهم أحد، لا تكون لهم أسرة أحيانا ولا ماضٍ، يبدؤون هكذا، من المعتقل، أو من سرير المشفى، ثم تبدأ الحكاية، لما يمكن كلنا أن نكونه، أنهى منيف “السوبر مان”، أبطال اللقطة والقوة والصفحات الأولى، يقول منيف: “البطل هو الشخص الضروري، في الوقت المناسب، والذي لا يغني عنه أي شخص آخر، أيا كانت المساحة التي يشغلها، أو الوقت الذي يستغرقه وجوده… وليس البطل ذلك “المخلوق المصنوع” الذي يبدو حكيما وقويا وقادرا في كل وقت، ولا مانع من أن يتصف بخفة الدم واللباقة عند الحاجة”.
قد يختفي أبطال منيف فجأة، بلا مصير نعرفه تماما، كما لا نعرف ألوف الميدان الهادرة ذهبت إلى أين. قد تخرق بطل منيف رصاصة ظالمة، ونتركه مسفوحا في منتصف الرواية، قد يصرخ ويتألم، قد يجبن ويبكي، في “شرق المتوسط” حين كنا نظن الرجال أبطالها، علق منيف لاحقا، أن بطلته الأم، وإن عبرت بسرعة، هذه التي أماتوها بالقهر والصبر على ابنها أمام المعتقَل. قال بطل منيف صارخا: “الجلاد لم يولد من الجدار، ولم يهبط من الفضاء، نحن الذين خلقناه”، وأتى أبطاله اللاحقون ليطردوا الجلاد، وليحرقوا تماثيله دون خوف مخبريه، الجلادون الصغار. “طالع العريفي”، مُطلِق الصرخة، لم يتوقف نبضه هدرا إذن، كما ودعناه في غرفة المشفى الكئيب.
قضى منيف عقدين في العمل السياسي اليومي ثم تركه. خبير النفط هذا، اختار أن يروي ما خبر، مزيحا ما ترك إلى جانبه قليلا، ليقول: ليبلّغ المُصاب بالنفط، صدفة الطبيعة الوفيرة. أشّر منيف على بقعها الدبقة على السياسة والثقافة والمجتمع، والدين، ولأن “النفط هو لغة العصر العربي الراهن، ويجب على الكثيرين – إن لم أقل الكل – أن يلعنوا هذا العصر بأصوات واضحة وبدون خوف”، شيّد منيف “مدن الملح”، ملحمة الضحك والبكاء، أحد أجمل منحوتات العرب الروائية.
منيف الذي رأى لم يكن مستحقِرا ولا داعيا إلى صفق الأيدي يأْسا: “الرداءة هي حالة وليست طبيعة، وهي تحديات وصعوبات ليست قدرا”، ولم يكن متشائما إطلاقا: “برغم الكثير من المرارة والسواد والتشاؤم أحيانا، فإن هنالك نورا في نهاية الدهليز. قد لا أستطيع أن أصل إليه أنا، ولكن المطلوب هو الوصول إليه، والجميع معنيّون”، لم يصل إلى نهاية الدهليز منيف، لكن في عتمته تحمّل حمل الشمعة، حتى آخره -آخره هو، لا الدهليز – مؤمنا كالفجر بمهمته: “مهمة الأدب أن يجعل الناس أكثر وعيا لواقعهم وأن يجعلهم أكثر حساسية وجرأة، وذلك فإن الوعي إذا ارتبط بالحساسية والجرأة يمكن أن يفعل الشيء الكثير”.
منيف المتنبي، ليس تشبيها بـ”المتنبي” القديم (تذهب همزة “المتنبئ” لدواعي التسهيل والحياة) شاغل الدنيا وطالبها. يتشابهان صحيح في البيان وفتنة الانسياب، إلا أن الأخير كان لسان البلاط، زينته وتزجية وقته، القائم بشجاراته التافهة، النافخ أمجاده الوهمية، من يؤلّف وهو يتخيل الأمارات والصرر، ثم إن لم تأتِ، إن تأخرت قليلا، فما أكثر الأسياد المرجوين، وجوائزهم ومجالسهم، وما أكثر الكلام الرخيص المكرر، والولاء البارد، الذي تقصّ على غيرهم وتلصقه بهم.
هذه الفروقات تعدّ ضحكة عند تشبيه المتنبي من هذه الناحية بمُنيف المُنيف.
خاص بموقع “المقال”.
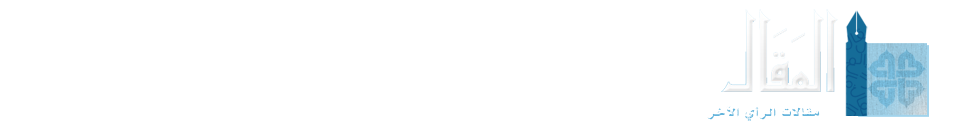











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك