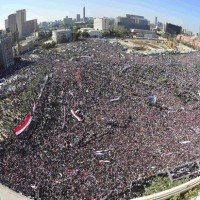
سيادة الأمة مُقدِّمةٌ لضمان نجاح تطبيق الشريعة!
 16 نوفمبر, 2011
16 نوفمبر, 2011  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
ليس هناك تقابل ولامعاندة بين المطالبة بسيادة الأمة وتطبيق الشريعة ..
سيادة الأمة مقدمة ضرورية لضمان (نجاح) محاولات تطبيق الشريعة ..
سيادة الأمة تقوم مقام المطالبة بإنشاء الدولة المستقلة حتى تتمكن من تطبيق الشريعة على وجهٍ أكمل ..
سيادة الأمة في المجتمع الإسلامي درجةٌ في سُلَّم توفير الإمكانات ووسائل الاستطاعة التي تضمن تأثير تطبيق الشريعة ورسوخه ..
يكتسب مطلب إنقاذ الأمة من مزاجية الحكام والمستبدين أولويةً بغرض حفظ الشريعة والشعوب من مظالم ومثالب حكم الفرد المستبد الذي تتلاعب به الأهواء والمصالح الخاصة، وعندما تتم التخلية بين الناس والشرع، ويتبين للناس محاسن الشريعة بالنقل والعقل، سيعود الناس للشريعة ويعرفون قيمتها ويبادرون للإيمان بها بالإقناع، وحينها سيحافظ (مجموع الأمة) على الشريعة من أهواء الأفراد و الخارجين عليها، المجموع هو الأقدر على الحفظ والأكثر أمناً من الوقوع في الزلل والهوى.
إن نوع الاجتهاد في هذا الباب هو من قبيل تحقيق المناط ! فليس الخلاف في وجوب تطبيق الشريعة ولافي لزومها على المستوى الشخصي بل في كيفية تحصيل الضمانات اللازمة لتحقيق تطبيق قانون الشريعة على مستوى النظام العام في الدولة!.
ومن تلك الضمانات :
– المطالبة بسيادة الأمة واستقلال دولتها!.
– السعي لإصلاح الأمة دينياً وفكرياً.
وكلاهما درجتان في تحقيق حالة الإمكان والاستطاعة المناسبة ومن هذا الوجه يظهر أن بحث (كيفية التطبيق) وضعٌ اجتهادي تتنازع فيها الآراء الظنية.
وهذا المطلب يندرج تحت (فقه التدرّج) وهو منهج شرعي يهدف إلى توفير ضمانات نجاح التطبيق، فحينما تسود الأمة المسلمة، وتعرف قيمة الشريعة ستسعى – باللزوم– لتطبيق الشريعة، لأن الشريعة بدورها تسعى لتحقيق مصالح الأمة الدينية و (الدنيوية)!.
وتتوفر جملة من الشواهد الشرعية التي تؤيد هذه المعاني ومن ذلك ملاحظة حال المسلمين في المجتمع المكي حيث لم تكن لهم سيادة ولم تكن لهم دولة لذلك توجّه العمل إلى الدعوة إلى أصل الإسلام وتكوين المجتمع المسلم، ولم تُستكمل الأحكام الشرعية ولم يُفرض سوى اليسير منها؛ لأن الأمة لم تكن لها استقلال ولاقوة ولامَنَعة من الأعداء، كما أنه مجتمع ناشئ يحتاج إلى ترويض نفسي حتى يتقبل الشرائع، ثم لمّا تهيأت الفرصة لإنشاء الدولة المسلمة في المدينة بادر المسلمون بالتحرك لتحقيق مطلب الاستقلال والسيادة كدولة، ثم مع تكوّن الدولة، واجتماع المسلمين وقوّة إيمانهم؛ لم تُنزّل الأحكام كُتلةً واحدة بل تدرّج النزول وتدرّج معه التطبيق، لأن المجتمع المسلم لم يزل في حاجة لمزيد من التهيئة والترويض لتقبّل الشريعة، ولم يزل المسلمون منشغلون ببناء الدولة وتحصينها من الداخل والخارج.
وفي هذا السياق تقول عائشة –رضي الله عنها- (إنما نزل أول مانزل سورة من المفصَّل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام.. ولو نزل: لاتشربوا الخمر، لقالوا: لاندع الخمر أبداً .. ولو نزل : لاتزنوا، لقالوا: لاندع الزنا أبداً). [أخرجه البخاري رقم 4707]
ويشهد لذلك أيضاً المثال المشهور في تدرّج الشريعة في تحريم الخمر، وفي هذا كلّه اعتبار لردة فعل الأمة ولرأيها.، ليس في أصل الشريعة بل في مرحلية التطبيق! ومع كونهم مسلمين إلا أن الشرع راعى أحوالهم في تنزيل الأحكام وإلزامهم بها.
وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن تأكيدٌ لمراعاة موقف الأمة والناس .. وتأكيدٌ لفكرة ترتيب الأولويات في الإلزام بالشريعة، حيث ورد فيه (… فادْعُهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. فإن هم أطاعوك لك بذلك فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) . [ أخرجه البخاري ومسلم] .
ويظهر في هذا الحديث عدم الإلزام بالشريعة (مرحلياً) لأنهم بعد الشهادتين سيكونون من أهل الإسلام، ولم يتم إلزامهم بما بعدها في نفس المرحلة بل يتم الانتظار و استقراء موقفهم وحالتهم؛ فإن ظهرت بوادر الاستجابة تمَّ فرض الأحكام بالتتابع والأهمية، و يلزم من هذا أنه ربما يطول الفارق الزمني للمراحل بحسب اختلاف الأحوال ومدى تطبيع نفوس الناس لتقبّل الشريعة، كما تفترق درجات التطبيق بحسب الأمصار كذلك فبعض البلاد يكون فيها من التهيؤ والتقبّل أكثر من غيرها فيمكن استكمال مراحل التطبيق فيها بشكل أشمل وأسرع.
وتشهد مجموعة من المواقف النبوية العملية على اعتبار رأي الناس في (مرحلية التطبيق) كما في حادثة عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم البيت وإعادة بناءه على قواعد إبراهيم ، مع وجود السلطة والقدرة على الفرض بالقوة – ومع كونهم مسلمين- لكن النبي عليه السلام ترك تطبيق هذا الحكم الشرعي حتى لاتكون فتنة؛ لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام!.
وكذا كان الحال مع وفد ثقيف حينما اشترطوا على النبي – صلى الله عليه وسلم- ترك الجهاد والزكاة والصلاة، فلم يأذن لهم في ترك الصلاة، وأذن لهم في ترك الجهاد والزكاة، ولما سُئل جابر -رضي الله عنه- عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي أنه لاصدقة عليها ولاجهاد، وأنه سمع النبي عليه السلام بعد ذلك يقول: (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا). [رواه أحمد وأبوداود وغيرهما].
والمقصود إذا توثّق إسلامهم وقوي إيمانهم، فلم يلزمهم النبي – صلى الله عليه وسلم – مرحلياً ببقية الشرائع، وبنحوه ماورد في مسند أحمد [رقم 21187] عن رجل أنه أتى النبي عليه السلام فأسلم على أنه لايصلِّي إلا صلاتين فقَبِل منه .
وفيما تقدّم إشارة وتنبيه إلى أنه متى ما تكررت هذه الأحوال فإن المنهج الشرعي في التدرج التشريعي والدَّعوي يجيز إعادة الكرَّة، ولادليل على النسخ أو التخصيص في الكافر الأصلي دون المسلم ضعيف الإيمان أو المجتمع المسلم الذي ابتعد عن تطبيق الشريعة سنين بل قرون عديدة، وتكالبت عليه أسباب الضعف والهوان ونقصان الإيمان، بل هي أحوال نفسية وطبائع بشرية عادةً ما تتكرر بحسب العصور والمجتمعات، ومقتضى الفقه القياسُ على التجربة النبوية التي سمحت بالتدريج في الإلزام بالشريعة مراعاة لأحوال الناس، وحرصاً من الشريعة على تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الأحكام، وليس مجرد إعلانها والإلقاء بها بين أظهر الناس دون الحرص على ممهِّدات التطبيق والتفعيل العملي حتى يطابق القول العمل، لا أن يكون قول بلاعمل، أو رياءٌ بالعمل مع إبطان الكراهية له!.
وقد استوعب هذا المعنى الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ؛ فقد روي في حواره مع ابنه عبدالملك وكان شاباً تقياً متحمّساً، ويرغب من والده أن يسرع في الإصلاح، ويقيم الحق والعدل دفعة واحدة مهما كانت النتائج والعواقب، فيقول لأبيه: (يا أبتِ، مالك لا تنفذ الأمور؟ والله ما أبالي لو أن القدور غَلتْ بي وبك في الحق) فيجاوبه والده بحكمة، ويرشده إلى المنهج الإلهي في التغيير والإصلاح، فيقول له: (لا تعجل يا بني، فإن الله ذمّ الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الحقّ على الناس جملةً فيدعونه جملةً، ويكون من ذلك فتنة( . مع ملاحظة أن عمر كان يملك السلطة والقدرة على الإجبار والإكراه بالقوة على الشريعة .. وكان في مجتمع مسلم .. وليس مع كفار حديثي الإسلام، مما يشهد بأن هذا التدرج والترتيب الإصلاحي محكم وليس منسوخاً ولامُخصَّصاً!.
ويؤكد عمر بن عبد العزيز على ضرورة المسلك السِّلمي في التدريج والتغيير حتى ولو طالت المراحل وتباعد الزمن في إعادة تأهيل الناس للشريعة، فيقرر في جولة أخرى من الحوار مع ابنه حيث أورد على أبيه قوله : (يا أمير المؤمنين، ما أنت قائل لربك غداً إذا سألك: رأيت بدعة فلم تُمِتْها، وسنّةً فلم تحيها؟!) فيجيبه عمر بقوله: (يا بنيّ، إنّ قومك قد شدّوا هذا الأمر عقدةً عقدة، وعروةً عروة، ومتى أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا عليَّ فتقاً تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يراق في سببي محجمة من دم .. أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة، ويحيي فيه سنة، حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق، وهو خير الحاكمين (. [حلية الأولياء لأبي نُعيم، وصفة الصفوة لابن الجوزي].
ثم في حالة إقرار الشرائع والقوانين فلايحق لأحد الخروج عليها، ويستوجب الخارج على القانون العقاب في الشريعة وحتى في القوانين الوضعية، وفي هذا تفسير لموقف الصحابة من عقوبة المخالفين بناء على خروجهم على الشريعة واستحقاقهم للعقاب بعد أن اسُتكمل التشريع واستقرت الأحوال ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ومن تلك المواقف قتال أبي بكر الصديق للمرتدين الذي اجتمع فيه سبب ديني وهو منع الزكاة، وسبب سياسي وهو الخروج على سيادة الدولة ولذلك حصل خلاف بين الصحابة أول الأمر على فرض أن باعث القتال هو العامل الديني وحده ثم اجتمعوا لما تبيّن لهم ما في موقف المرتدين من مفسدة كبرى تتجاوز ترك الحكم الشرعي إلى زعزعة سيادة الدولة المسلمة، بل ربما اجتثاث الدين من أساسه ومن وجه آخر؛ فإنه لايصح التشبيه بين حال المرتدين الذين رجعوا من الإسلام إلى الكفر الصريح، وحال المسلمين الذين يتأولون في الاعتراض على بعض الأحكام لظنّهم عدم لزومها أو عدم صحة الفهم السائد عنها.
إن من مثارات الغلط في بحث هذا الباب الخلط بين ثلاث مستويات :
– الشريعة وما تتضمنه من أحكام ونظم قيمية.
– تطبيق الشريعة بعد الاتفاق على المحكمات وما يترجّح تطبيقه من الظنيات.
– تطبيق مذهب معين في الشريعة.
أما ذات الشريعة بما تتضمنه من قيمٍ عُليا وأحكام سامية فهي مطلبٌ واجب يتفق عليه المسلمون لكونه لازم إسلامهم.
ومحل النزاع في كيفية تحقيق الإمكان الأكثر نجاعةً في استدامة وضمانة تطبيق الشريعة وذلك عندما يقع التقابل بين حالتين.. حالةٌ يمكن فيها تطبيق الشريعة أو أجزاء منها في ظل حكم مستبد متفرّد، وحالة أخرى في ظل نظام تسود فيه الأمة وتستقل بنفسها مع احتمالية عرقلة أو تأخير تطبيق الشريعة، والمطلوب إيجاد المعادلة التي تتضمن الموازانات والضمانات (لنجاح) تطبيق الشريعة مراعاة لأحوال الموافقين ودرءاً لمفسدة استعداء واستفزاز المخالفين من الداخل أو الخارج ومن أبرز تلك الضمانات نزع هيمنة الفرد المستبد وترسيخ سيادة الأمة! فالشريعة تحتاج إلى تشكيل الأمة وكينونتها المستقلة كما تحتاج إلى أن تقوم دولة الإسلام المستقلة في نفسها وعلى أرضها! فالدعوة لسيادة الأمة يتضمن تحقيق ضمانة لتهيئة بيئة تنجح فيها محاولة تطبيق الشريعة، فسيادة الأمة عامل نجاح وليست عائقاً كما يتصوره البعض.
إن المطالبة بتقديم سيادة الأمة يقع في سياق توفير الشروط والأسباب (السِّلمية) المؤثرة والضامنة لإنجاح التحركات نحو تطبيق الشريعة، وتتأكد المطالبة بالتطبيق السِّلْمي لكونه الأقل مفسدة، ولكونه الأكثر إقناعاً حيث يخلق مساحة من التوازن النفسي والمجتمعي حتى تتهيأ النفوس لمطالب الشرع، وتتفهّم الشريعة بعد طول تخلّف وبُعدٍ عن تطبيقاتها، بخلاف الفرض عن طريق القوة والتي تغلب مفسدتها وتخلق – ربما- حالة من النفاق العملي في داخل المجتمع، كما أن وسائل القوّة والإكراه ستخلق أعداءً ومحاربين على المستويين الداخلي والخارجي مما سيُعرّض تجربة التطبيق – بالقوة- لاحتمالات الفشل والإخفاق!.
أما السعي لفرض مذهب معيّن فليس بلازم، بل هو قدر زائد على محكمات الشريعة، بل ربما كان فرض الرأي والترجيح الخاص مجلبة للمفسدة والخلاف ومُضرِّاً بقبول الناس لتطبيق الشريعة فيكون من المُستحسن تأخيره، أو فتح المجال فيه للتعددية الاجتهادية بأدلتها المعتبرة.
كما أن من المغالطة في معالجة هذه المسألة صنع الثنائيات المتعاندة بين الشريعة والأمة أو طرح الأسئلة الخاطئة التي توجّه العقل المخالف نحو المنافرة بين الشريعة والأمة أو الشريعة والديمقراطية كنظام إجرائي هو أحسن الموجود لكسر شوكة الفساد والاستبداد.
يبقى أن هذه المسائل من النوازل الكبرى التي تتطلب قدراً من الاجتهاد والموازنة الدقيقة من أجل تحقيق مصالح الدين والدنيا ومن غير إحداث فِصام وتعاند بين المطلب الديني والدنيوي، فالدنيا لايكمل صلاحها إلا بالشريعة الصحيحة، والشريعة تهدف لتحصيل المصالح الدينية والدنيوية وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وثمّة معادلات عديدة تدور في الواقع بما يحمله من تعقيدات تتطلب مرونة اجتهادية وفقهاً أكبر ولذلك كان باب (المصالح المرسلة) الذي قرره علماء أصول الفقه يسعى إلى استيعاب وشرعنة الأنظمة والتطبيقات المصلحية التي لم يأت فيها نص تفصيلي خاص ولاتعارض محكمات الشرع.
إن التطبيق المرحلي للتشريعات المستند على فقه التدرّج هو فقه واقعي يحترم الواقع بما فيه من تداخلات وصراعات، ويراعي الترسُّبات التاريخية المتراكمة التي أنتجت الواقع المُعقّد، و يُقدِّر تأثير التصورات المشوّهة والدعوات المنحرفة ضد الإسلام التي أبعدت الناس عن أجواء الشريعة. إن هذا النوع من الفقه يستدعي اجتهاداً تجديدياً يتفوق على النسق التقليدي المكرر، ربما لايستوعبه مَنْ ينزع نحو المثالية في التنظير أو مَنْ لايعاني آلام الواقع!.
إن فرض التعاند بين مطالب الدين والدنيا، وبين النص والواقع، وبين العقل والنقل، وبين الحرية والعبودية، سيُنتج مزيداً من التأزّمات في التصور عن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان.
وحينما يعجز المتدينون عن إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، سيثبت العلمانيون صلاحية العلمانية للتعايش والتسامح والتنمية والحضارة والإبداع والاستقلال!.
وحينها سيشتغل بعض المتدينين بالعزلة وجاهلية المجتمعات، والتكفير وصناعة الموت، وتعجيل الآخرة في الدنيا!!.
خاص بموقع “المقال”
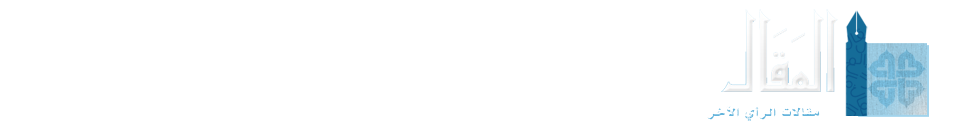











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك