
الخصوصية السعودية
 25 أكتوبر, 2011
25 أكتوبر, 2011  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
الأمة تمر بمنعطف تاريخي، هذه الجملة التي ربما ترددت آلاف المرات على مدى عقود من الآن، والمرة الوحيدة التي يصدق فيها هذا الوصف هو هذا العام 2011 م، فمستوى التغيرات التي حدثت بعد سكون السنوات العجاف لم يكن التنبؤ بها إطلاقًا، أو كما يقول البعض كانت لحظة إحراق محمد البوعزيزي نفسه هي البجعة السوداء للتغيرات في المنطقة العربية.
على مستوى حداثة الأنظمة العربية الحالية، السعودية هي من البلدان التي تعيش في حالة جمود سياسي لا يمسه التغيير منذ لحظات التأسيس، وربما كانت الدولة على وشك الانفتاح على شكل متقدم نسبيا من المشاركة الشعبية لكن تم إنهائه مع بداية عصر وحقبة التنمية في البلاد. وكأن التنمية هي على علاقة عكسية مع مستوى الحريات السياسية.
ومنذ عقود والمطالبات الإصلاحية في السعودية في صعود ونزول، ولطالما جوبهت مطالب الإصلاح السياسي بتجييش علماء الدين على الإصلاحيين، ولطالما كافأت الحكومة العلماء الحلفاء على دفاعهم عنها وتشويه سمعة الإصلاحيين وتضليل الرأي العام في الشارع عن أسس ومبادئ وأفكار الإصلاح السياسي المتعلقة بالمشاركة الشعبية وتأسيس برلمان منتخب وفصل السلطات عن بعضها وغيرها.
بطبيعة الحال لا تتحمل المؤسسة الدينية الرسمية جريرة هذا التضليل من الأساس، وليس من الدقيق أيضًا القول أن المؤسسة الدينية تابعة في كل صغيرة وكبيرة للسلطة السياسية، ومع ذلك فوجود الهيئات الدينية لم يكن ليمتلك شرعية لولا السلطة السياسية، فالعلماء لا يمكن أن يتولوا هذه المناصب من دون مراسيم ملكية بتعيينهم، ومن البديهي أن السياسي لم يكن ليختار عالما ينطلق من رؤية سياسية تختلف مع السلطة السياسية الحالية. هذه الحالة ليست حكرا على المؤسسات الدينية، بل حالة عامة على كافة المنابر الثقافية التي تخاطب الناس، والمؤسسات الدينية لها شأنها الخاص بحكم التدين الشعبي الذي كان ومازال نسبة من الناس يثقون بعلماء المؤسسات الرسمية.
لطالما كانت السلطة السياسية المستبدة توجد لها مشروعية عبر إقناع الناس بشكل دقيق وبطرق مباشرة وغير مباشرة أنها هي الوحيدة القادرة على إدارة البلاد، وأن المصير أسود ومظلم من دونها، فهي السلطة الشرعية الوحيدة في الماضي والحاضر والمستقبل القادرة على تأمين الناس من خوف وإطعامهم من جوع. باختصار السلطة المستبدة تقول للناس: أنا أو الدمار.
وكما أنه ليس بغريب على أن تتكون أساطير حول إمكانية الثورة الشعبية في مصر، كانت تقول أنه من المستحيل قيام ثورة وأن ذلك يعني أن الأحياء العشوائية المحيطة بالقاهرة ستغزو بطريقة همجية على العاصمة وتنهب وتسرق وتخرب وتعيث في الأرض فسادًا. وبالطبع فإن ما حصل هو الكفيل بدحض هذا الخيال الدرامي المرعب. ونفس الأمر يُقال عن حال أكثر البلدان العربية التي تبدأ السلطة بث المخاوف في حال سقوطها ثم تتحول إلى تنظير فكري يرسخ هذه الخيالات، وحالة سوريا في الأوضاع الراهنة شاهدة على ذلك.
على مستوى مختلف من الحالة السياسية يمكن قول ذلك عن الحالة في السعودية عندما نتحدث عن مطالب إصلاحية واضحة تتزايد يوما بعد يوم وتتخذ شكل حراك شعبي عفوي من قطاعات الشباب خصوصا، وهي تضع يدها على جراح البلد وتصوب أصابعها على منابع الفساد وتلوح إلى سبيل النجاة والفلاح. ولا ريب أن مثل هذه النزعات الإصلاحية لابد أن تُقابل بالقوة، فيعتقل شاب مبدع اسمه “فراس” وفريقه وجريرته أنه تحدث عن فقراء مدينة الرياض! وهذا جزء من الخصوصية المحلية التي تواجه كل المطالب الإصلاحية.
تشكلت أسطورة الخصوصية السعودية منذ عقود ومازالت حتى اليوم تردد على المنابر الرسمية، بل من دون شك أصبحت في مخيال كثير من الناس. واتخذت الخصوصية مبررات عدة تجاه مطالب الإصلاح السياسي، سواء كانت هذه المبررات نابعة من نخب أكاديمية وإعلامية وثقافية، أو كانت مبررات في هوس الشارع والعقل الشعبي.
الخصوصية صوّرت أنها أمر حتمي في جينات الشعب، فقدر الشعب ألا يشارك في الحكم وفي إدارة شؤون البلاد وفي استحقاقه لمراتب عالية في الشفافية وإدارة المال العام، إنه أمر حتمي لهذا الشعب أن يعامل بأنه غوغاء ودهماء وأنه بحاجة دوما إلى من يقوده كما يقاد القطيع. وهذه الصورة القاتمة ليست من خيال الكاتب، بل هي ما يردده الكثير من الممانعين لأي إصلاح سياسي في البلاد.
من المضحك مثلا أن يتحدث أستاذ في العلوم السياسية من جامعة عريقة عن حكم الانتخابات في الإسلام، ويتحدث بلغة أستاذ التاريخ وعلوم الشريعة أن سياسية الوراثة هي الطريقة الشرعية في الإسلام ويستدل على ذلك بأن الخلفاء الراشدين تولّوا السلطة بالوراثة! وأن الانتخابات ليست طريقة إسلامية بل تشرّع للحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الانتخابات غير شرعية عند أستاذ العلوم السياسية فماذا أبقى لشيخ حرّم الانتخابات لأنها تشبه بالكفار، وشيخ حرمها لأنها فتنة، وآخر حرمها لأنها أخذ برأي الغوغاء والدهماء.
وإلى نفس النتيجة يصل من يقول أن الانتخابات تجلب للحكم الأصوليين الإسلاميين المتشددين، وأن الانتخابات في السعودية هي قنطرة الحكم الطالباني! وهي الوجه الآخر لجملة قالها سَلَفي محافظ لأحد الإصلاحيين بأن الديمقراطية قنطرة العلمانية، ومن يقول أن المطالبة بالإصلاح السياسي في السعودية هي دعوة للفتنة، لأن الكاسب منها الشيعة والعلمانيين! صوت الممانعة للإصلاح السياسي في السعودية واحد، سواء صدر من شيخ دين أو من صحفي ليبرالي. فالجامع بينهما هو المحافظة على الأوضاع السياسية الحالية من دون تقدم في الإصلاح والتغيير الحقيقي.
هذه الخصوصية نفسها التي تجعل من هذين الطرفين المتناقضين المتفقين يتفاعلان مع الثوار في البلدان العربية، بل لا يجد أحدهم حرجا في أن يكتب عن استبداد طاغية عربي وبسالة الثوار في التصدي له، ولا يجد جرحا في الحديث عن الديمقراطية والمدنية والحرية والعدالة، وفي نفس الوقت يمانع ويقاوم أي حديث عن الإصلاح في البلاد، والعلة هي نفس العلة التي يرددها ذلك الحاكم العربي الذي يشتمه ليل نهار “المؤامرات على البلاد”. الخصوصية التي تجعل من التغيير في بلد عربي آخر أمرا مشروعا، بينما التغيير في هذا البلد أمرا محظورا وفتنة ومغامرة غير محسوبة.
ورغم العقود التي مرت على توحيد البلاد تحت راية واحدة، ورغم العقود التي مرت على التعليم النظامي في السعودية فإن الهواجس والتخوفات من التنوع القبلي والإصرار على التمسك بتقاليد القبيلة لا يزال قائما. والخطر المتصور هنا أن كل قبيلة ستحمل سلاحها وستعلن لنفسها حكما ذاتيا في كل إقليم من أقاليم البلاد. ويتضخم هذا الخطر وتخيلاته في كل تفاصيل اختلاف المجتمع السعودي حتى يُخيّل للبعض أن كل قرية ستهجم على جارتها ومدينة على أخرى! هذا بالإضافة إلى شبح الحرب الطائفية والتطهير المذهبي. كل هذا الخيال يصوّر لك عندما تدعو إلى أدنى تغيير على مستوى المؤسسات السياسية الحالية، والمثال عليه البيان الذي وقع عليه آلاف السعوديين “دولة الحقوق والمؤسسات” الذي ينص على انتخاب مجلس الشورى وصلاحياته الرقابية، وأن يكون رئيس الوزراء متفق عليه بين طرفين هما الديوان الملكي ومجلس الشورى.
ولنتماشى قليلا مع هذا الخطر المزعوم، وليكن هذا المستقبل المحتوم فيما لو تغيرت الأوضاع السياسية للأمام بدرجة واحدة! السؤال هنا ليس عن هذا الخطر، السؤال عن ماذا فعلت الدولة طوال هذه العقود لمعالجة هذه المشاكل؟ السؤال الحقيقي هو عن هوية الدولة بمختلف مناطقها؟ السؤال الذي إجابته ليست محل اتفاق بين مختلف مناطق المملكة، وهو نفسه ما جعل طبيبا نفسيا يتخبط في حديثه عن وجوب ولاء إنسان الشمال والجنوب لإنسان الوسط! وهو ما لم يكن بحاجة إليه لو كانت الهوية جامعة بين أفراد الوطن ومختلف مناطقه.
إن كل التخوفات التي تصدر عن مقاومي الإصلاح والتغيير في السعودية هي أولا وقبل كل شيء تسيء إلى الحاكم السياسي، فالمعنى من هذه المخاوف فيما لو كانت حقيقية أن الحكومة لم تكن تؤمّن المستقبل عبر السنوات الطويلة من دعم التعليم والإعلام والثقافة والتنمية، بل كل ما فعلته عبر هذه السنين الطويلة أن حافظت على نزعات التمرد والانفلات الأمني في حالة جمود ينكسر عند أدنى تغيير. وكأن التغيير ليس أمرا حتميا في هذه الحياة، وكأنه شيء منذ الأزل في هذه الحياة! لذا يتحول الأمر إلى أن طرح سؤال الخوف من المستقبل بشفافية ووضوح إلى أمر محظور يُحبس من يطرحه وتقيد يديه بالسلاسل.
ولطالما كان الحديث عن جهوزية المجتمع للتغيير، وهو ما يخفي السؤال الحقيقي هنا، وما سماه البعض “هل الحكومة جاهزة للتغير؟”. إنه من الواضح أن المجتمعات العربية جاهزة للتغيير والذي كان في حالة جمود ومايزال هو الأنظمة نفسها، الأنظمة بحاجة إلى تطوير وإلى تجديد الدماء في جسد الدولة يبعث فيها الشباب والحياة والأمل.
خاص بموقع “المقال”
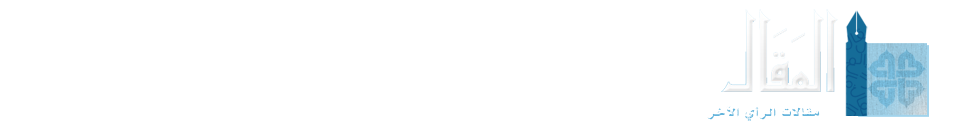











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك