
الإصلاح الديني والإصلاح السياسي.. الارتباط والتزامن
 10 أكتوبر, 2011
10 أكتوبر, 2011  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
لا يمكن إصلاح النظام السياسي لأي مجتمع كان ما لم يتم إصلاح المنظومة الثقافية والدينية المهيمنة في ذلك المجتمع، بل لو قلنا بأن طبيعة النظام السياسي هي انعكاس للمنظومة الثقافية والدينية لن نكون مبالغين في هذا التحليل، وبالتالي فبقاء الفساد والظلم والاستبداد في أي منظومة سياسية إنما يعتمد على المشروعية التي يكتسبها عبر المنظومة الثقافية والدينية. والدينية على جه الخصوص!
لماذا الدينية على الخصوص ؟
لاحظ علماء الأنثروبولوجيا أن السلطة الاستبدادية القهرية عبر التاريخ البشري، لا تستطيع أن تستمد مشروعيتها عبر الأسباب الطبيعية، أي عبر شواهد مادية محسوسة، ويعنون بذلك: موافقة الشعب واختيارهم الحرّ، لأن موافقة الشعب أمر طبيعي محسوس، يمكن اختباره ورصده . إنما يستمدون مشروعيتهم مما وراء الطبيعة؛ من خلال الغيب والسحر والخرافة. والحديث هنا ليس عن مجرد فرض السلطة وإنما عن (مشروعية) السلطة، وإلا فمجرد السلطة يمكن أن تتحقق لمن تغلّب واستطاع أن يفرض سلطانه على الشعب بالقوة، ولكن مبدأ التغلّب لوحده لا يكفي لمنح المشروعية، لابد للمتغلّب من تحصيل المشروعية. وبطبيعة الحال لا يمكن للمستبد أن يستمد مشروعية سلطته من الشواهد والأدلة الطبيعة = اختيار الشعب وإلا لما كان مستبدا، فليس أمامه إذن إلا الغيب والأسطورة والسحر.
كيف يمكن للسلطة القهرية استمداد المشروعية عبر الغيب والأسطورة والخرافة ؟
لم تخلو سلطة قهرية عبر التاريخ (تقريبا) إلا وحولها رجال دين أو كهنة أو سحرة، بحسب الديانة أو الخرافة السائدة في ذلك المجتمع. هؤلاء الأحبار أو الكهنة أو السحرة يأخذون مكانة عالية ومرموقة في المجتمع وحظوة لدى ذلك المستبد شريطة أن يُقنعوا عامة الناس بأن سلطان ذلك الحاكم المستبد هو سلطان مشروع يستحقه دون غيره من البشر، ومصدر استحقاقه ليس من قناعة الشعب أو موافقته له (المصدر الطبيعي المحسوس) وإنما لأن الآلهة اختارته من دون البشر لكي يكون حاكما، وبالتالي منازعة هذا الحاكم في سلطانه هو منازعة لسلطان الآلهة وقدح في اختيارها.
هذا الدور الماورائي الخرافي لا يمكن أن يقوم به أحد من الناس سوى رجال الدين أو السحرة أو الكهنة . ولهذا كان ارتباط الحاكم ضروريا بهذه الطبقة التي تمتلك (الرأسمال الرمزي). بل قد تفرض الحاجة السياسية إلى أن يمتد ارتباط الحاكم بذات المعبد أو بالهيئة الدينية أو بمجالات السحر لأجل استمرار المشروعية، فلا بد للحاكم أن يكون إما عضوا في المعبد، أو رئيسا فخريا للكهنة أو المجمع الديني، أو منتسبا للمذهب أو الطائفة السائدة في ذلك المجتمع أو حتى رئيسا لها، أو يكون ممارسا بارعا متمكنا في السحر والخرافة كما هو الحال في المجتمعات البدائية، كل ذلك لكي يكتسب المشروعية السياسية من خلال (الرأسمال الرمزي) الذي له تأثيره العميق وسيطرته الروحية على نفوس أفراد المجتمع.
من هنا كان التحالف التاريخي بين السلطة السياسية القهرية المستبدة والسلطة الدينية الروحية بمعناها الرمزي. فالسلطة القهرية المستبدة مهما كانت قوتها وسيطرتها ونفوذها واستغناؤها إلا أنها بحاجة للمشروعية السياسية ولو بصورة معنوية. وهذا المشروعية -كما قلنا- لا يمكن أن تكون مستمدة من الشعب مباشرة وإلا لأصبح الحاكم مفتقرا للشعب، ولأصبح سلطانه مرهونا بإرادتهم واختيارهم وبالتالي يملكون الحق في نزع سلطانه متى ما أرادوا. حينها ليس أمام الحاكم المستبد إلا أن يقنع الشعب -عبر الأحبار أو الكهنة أو السحرة- بأن سلطانه امتداد للآلهة المقدسة التي يعظمونها، وبالتالي يكون تعظيمه جزء من تعظيم تلك الآلهة، ومحاربته محاربة لتلك الآلهة. هذه الحكومات القديمة أصبحت تعرف الآن في علم السياسة بالحكومات (الثيوقراطية) أو حكومة الآلهة، وهي على ثلاثة أصناف :
1) صنف يعتقد بالطبيعة الإلهية للحكام، أي أنهم آلهة تمشي بين البشر وتحكمهم وتصرّف شؤونهم، وهذه النظرية كانت موجودة في الإمبراطوريات القديمة في : مصر والصين وفارس والهند، ووجدت كذلك في التاريخ الإسلامي عند الفاطميين حيث كانوا يعتقدون في الحاكم بأنه ذو طبيعة إلهية. وقد استمرت هذه النظرية إلى نهاية الإمبراطورية اليابانية في الحرب العالمية الثانية.
2) والصنف الثاني ينطلق على أساس أن الحكام ليسوا من طبيعة إلهية، وإنما هم من جنس البشر، ولكن (الآلهة) اختارتهم بطريقة مباشرة وخصتهم لوحدهم بممارسة السلطة دون غيرهم البشر، وبالتالي فعلى الرعية طاعة أولئك الحكام، لأن طاعتهم هي طاعة للآلهة ومعصيتهم معصية للآلهة بصورة مباشرة. وقد اعتنقت الكنيسة هذه النظرية ونادى بها القديسون بأن (الإرادة الإلهية) هي مصدر كل سلطة على الأرض، وما زلت هذه النظرية تحكم الفاتيكان، كما استخدمها ملوك فرنسا، وخاصة لويس الرابع عشر الذي كان يقول: (إن سلطة الملوك مستمدة من الخالق، فالله مصدرها، وليس الشعب. والملوك وحدهم هم المسؤولون أمام الله عن كيفية استخدامها) .وقد وجدت أيضاً هذه النظرية في تاريخنا الإسلامي لدى فقهاء الشيعة في نظريتهم حول (الإمامة) أو في نظرية (ولاية الفقيه) المعاصرة، والتي عبرت عنها المادة الخامسة في دستور الجمهورية الإيرانية الإسلامية حيث تقول: (في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر الشجاع القادر على الإدارة والتدبير …) . وهذا الفقيه العادل هو نائب عن الإمام الغائب المعصوم، والذي بدوره معبّر عن إرادة الله تعالى في الأرض.
3)الصنف الثالث، لا يعتقد بوجود اختيار إلهي مباشر للحكام لأن ذلك أشبه بالمعنى الخرافي والأسطوري، ولكنه يعتقد بأن الحق الإلهي يتجلى للحاكم من خلال هداية الله للشعب حين خضعوا لسلطان ذلك الحاكم، ولولا مشيئة الله لما خضع الشعب للحاكم، ولو مشيئته تعالى وقدرته الخيّرة لما انتصر وفرض سلطانه عليهم بالقوة والتغلّب، وبالتالي فمنازعة هذا الحاكم هو منازعة لله في قدرته ومشيئته الخيّرة. وهكذا يتم اعتبار هذا الحاكم هو مبعوث العناية الإلهية وأنه ملهم لا يخطئ، ثاقب الرأي حادّ البصر والبصيرة، يدرك مصلحة الشعب أكثر من الشعب نفسه، عليم بدقائق الأمور وخبير بمتاهات السياسة، موّفق في كل قراراته بتوفيق الله له، ولهذا لا يعارضه إلا الجهلة أو الحاقدون ممن يريدون شرا وفسادا بالبلاد. وإذا ثمة أخطاء في سياسات حكومته فهي ليست بسببه هو؛ وإنما بسبب أعوانه وولاته ووزرائه الذين لم ينفذوا قراراته وفق كمال إرادته التي لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها!!
هذا الصنف الأخير من نظرية (الحق الإلهي) وجدت في ترثنا الفقهي، أقصد تراث أهل السنة والجماعة، وحينما أقول (وُجِدت) فلا يعني أن كل تراثنا الفقهي السياسي مبني على هذه النظرية، ولكن جزء ليس باليسير من هذه النظرية تسرب بين خطابات بعض ولاة السنة وبالتالي وجدت لها تشريعا وتبريرا لدى بعض الفقهاء.
علما بأنه ليس في الإسلام؛ لا في القرآن ولا في تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في سياسة خلفائه الراشدين ما يشير ولو من بعيد؛ بأن المشروعية السياسية سواء للرسول صلى الله عليه وسلم أو لخلفائه الراشدين اقتضها الحق الإلهي، إنما تحققت لهم المشروعية من خلال بيعة الأمة لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصبح رئيسا للمدينة إلا بعد بيعة أهل المدينة له في العقبة الأولى والثانية، وليس بمقتضى النبوة أو من خلال الحق الإلهي، بل حين قدم إلى المدينة لم يكتف بموجب تلك البيعتين لأن النقباء الذين بايعوه كانوا يمثلون الأوس والخزرج فقط ولا يمثلون كافة شرائح أهل المدينة كاليهود ومواليهم وغيرهم، فقام بوضع أول وثيقة دستورية متكاملة عرفها العالم؛ تقوم على مبدأ المواطنة لكل من يعيش على أرض المدينة، سواء المسلمين من المهاجرين والأنصار، أو غير المسلمين من يهود المدينة ومواليهم ونحوهم. كما تؤكد على مبدأ المساواة في كافة الحقوق والواجبات دون تمييز أو ظلم.
باختصار: أهل المدينة هم الذين منحوا النبي صلى الله عليهم وسلم السلطة عليهم، أي بمقتضى الاختيار والتراضي من قبل الشعب وليس بمقتضى النبوة ولا بمقتضى الحق الإلهي، علما بأن النبوة كافية في استحقاقه للرئاسة، ولكن لم تتحصل له إلا بعد عقد البيعة، ولولا عقد البيعة لما انعقدت له حتى وإن كان مستحقا لها في نفس الأمر بمقتضى النبوة، ولو كان مقتضى النبوة كافٍ في استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للولاية السياسية لكان رئيسا في مكة قبل هجرته إلى المدينة، فاستحقاقه للولاية في مكة أولى من استحقاقه بالمدينة، ولكن لم تتحصل له إلا في المدينة بموجب عقد البيعة. فكان صلى الله عليه وسلم (نبيا ورئيسا) في ذات الوقت: نبيا باصطفاء الله له بالرسالة من جهة، ورئيسا مدنيا باختيار أهل المدينة له من جهة أخرى. ولهذا كان الفقهاء يقسّمون تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: تصرفات بمقتضى النبوة، وتصرفات بمقتضى السياسة. وهذا المركّب المختلط من (النبوة والرئاسة) لم يجتمع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأما الحاكم الذي يأت من بعده فليس له إلا الرئاسة المدنية التي لا تنعقد إلا برضا الأمة واختيارها، فأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ -رضوان الله عليهم أجمعين- لم تنعقد لهم الولاية إلا بموجب عقد البيعة المبني على الاختيار والتراضي، لا بموجب نص المقدّس أو وصية إلهية .
هكذا كانت المبادئ التي تحكم الواقع السياسي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ولكن مع مجيء أمراء بني أمية بدأ يتشكّل واقع سياسي جديد يسمح بتسرّب نظرية (الحق الإلهي) في الفكر الإسلامي القديم، حصل هذا مبكرا مع بداية تحول الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض، وهذا التحوّل الكبير كان يتطلب خلق مشروعية دينية تسمحله بالقبول والتجذر في الوعي الجمعي، كالتوظيف السياسي لمسألة أفضلية قريش واستحقاقهم للخلافة دون غيرهم، علما بأن أفضلية قريش بالخلافة كانت أفضلية تاريخية في ذلك الوقت وليست أفضلية مطلقة تعبر الزمان والمكان، وقد علّل هذا أبو بكر رضي الله عنه حين قال: “إن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قـريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا”
ثم استتبع أفضلية قريش أفضلية بني أمية من حيث الشرع واستحقاقهم للخلافة دون البطون الأخرى من قريش، إضافة إلى إشاعة القول بأن خلافة بني أمية (قدر إلهي) ونحو ذلك من المفاهيم الدينية. وقد أُثر عن معاوية رضي الله عنه -حين أراد توريث ابنه يزيد وعارضه كبار الصحابة وأهل المدينة -قولته الشهيرة: “إن أمر يزيد قضاء وقدر، وليس للعباد الخيرة من أمرهم” (ابن كثير 8/126).
وبعد كارثة مقتل الحسين رضي الله عنه، ثم واقعة (الحرة) والتي انتهكت فيها حرمة مدينة رسول الله صلى الله وسلم وقتل فيها عشرة آلاف من أهل مدينة رسول الله، ثم مقتل ابن الزبير وانتهاك حرمة الكعبة وقصفها بالحجارة، ثم جاءت واقعة (القراء) والتي انهزم وقتل فيها خيرة فقهاء ورجالات الأمة الذين خرجوا مع الأشعث ضد الحجاج بن يوسف، وقد عرفت فيما بعد بواقعة (القرّاء) لكثرة الفقهاء والعلماء الذين خرجوا فيها وقتل منهم كثير. هذه الحوادث المؤلمة والمحبطة كانت بمثابة المنعطف التاريخي الحادّ للوعي السياسي السني، حيث بدأ يتشكل في وعي الناس بأن سلطان بني أمية قَدرٌ إلهي، إما قدَرُ خير وبالتالي يجب الخضوع والتسليم له، وإما قدَر عقوبة لأجل ظلمنا وبعدنا عن الله تعالى وبالتالي يجب إصلاح أنفسنا قبل إصلاح بني أمية، وقد سئل الحسن البصري -رحمه الله- بعد واقعة (القراء): ألا تخرج على الحجاج فتغيّر؟ فقال: “أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادّي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين” (ابن سعد 7/127) .لهذا تفشى القول بوجوب السمع والطاعة للحاكم حتى وإن كان مثل الحجاج بن يوسف، وأخذ يتشكّل مفهوم (الجبر السياسي) والذي يقتضي بأن السلطان المستبد هو (قضاء الله)؛ فإما أن يكون قضاء بلاء وحينها يجب الصبر على هذا البلاء، وإما أن يكون قضاء خيرٍ وحكمة وحينها لا ينبغي منازعة الله في قضائه وحكمته، إضافة إلى تشكّل مفهوم (الإرجاء السلطاني)، وهذا المفهوم هو امتداد وتوظيف لمفهوم (الإرجاء الكلامي) الذي تشكّل قبل حادثة (القراء) وبدوافع فلسفية في الغالب، لكن بعد حادثة (القراء) تم توظيف المفهوم الكلامي (للإرجاء)توظيفا سياسيا يقتضي أن كل ما يفعله السلطان مغفور له، وقد قال قتادة: “إنما أُحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث”، وقال الشافعي: “ظهر الإرجاء بعد هزيمة القراء” .
وقد كان لبني أمية فقهاؤهم الذين يقومون بخلق ونشر هذه المفاهيم الدينية، حيث يذكر ابن تيمية “أن من أهل الشام من كان يعتقد بأن طاعة الخلفاء جائزة في معصية الله !! وأن الله يغفر لهم ذنوبهم مهما فعلوا وتجاوزا” (منهاج السنة 1/232) . ويبدو أن هذا الرأي الشنيع لم يكن شاذا ونادرا، حيث سأل أبو جعفر المنصور وزيره أبي عبد الله: ما كان أشياخك الشاميون يقولون؟ فقال: أدركتهم يقولون: إن الخليفة إذا استُخلف غفر الله له ما مضى من ذنوبه. فقال له المنصور : إيْ الله وما تأخر!!” (السير 6/76) .
هذا التبرير (الإرجائي) يأتي في ظل تشكّل مفهوم ديني آخر جديد لم يعرفه المسلمون من قبل، وهو أن (السلطان ظلّ الله في الأرض)، وبالتالي فطاعته طاعةٌ لله تعالى، ومعصيته معصيةٌ لله تعالى، وهذا المفهوم من المفاهيم التي تسربت إلى الفكر الإسلامي القديم عبر الثقافات والحضارات القديمة، ففي الثقافة الآشورية كان يُقال: “الإنسان ظلّ الله في الأرض، والإنسان هو الملك الذي يشبه مرآة السماء” . وقد اختلقت الأحاديث الموضوعة لأجل ترسيخ هذا المفهوم، كحديث: “السلطان ظل الله في أرضه، من نصحه هُدي، ومن غشّه ضلّ” (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة- للشوكاني :623) وحديث:”السلطان ظلّ الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله” (السلسلة الضعيفة والموضوعة – للألباني 4/160) .
وقد كان لهذا المفهوم الديني الجديد انعكاساته ولوازمه الخطيرة، ولعل خطبة أبي جعفر المنصور الشهيرة في يوم عرفة تبرز لنا هذه اللوازم الخطيرة، حين قال: (أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازنه على فيئه، أعمل بمشيئته، وأقسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، قد جعلني الله عليه قفلا، إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يقفلني أقفلني، فارغبوا إلى الله أيها الناس، وسلوه في هذا البلد الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله أن يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم، ويفتحني لأعطياتكم وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم إنه سميع قريب” (الطبري 4/533) .
فالسلطان وفق هذا التصور الديني، هو نائب عن الله تعالى في الأرض، وبالتالي فهو يمارس سلطته السياسية وفق إرادة الله تعالى ومشيته، سواء كانت خيرا أم بلاء، وبالتالي فعلى الشعب أن يرغب إلى الله تعالى بالدعاء والتوبة إذا أراد استصلاح سياسة الحاكم. ومن هنا نفهم تلك المقولة الشهيرة التي تروى على ألسنة بعض الفقهاء : “لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان”، وقد فسّر الإمام الفضيل رحمه الله سبب تخصيص الدعوة المستجابة للسلطان، فقال: “إذا جعلتها في نفسي لم تتعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلُح فصلُح بصلاحه العباد” .
إذن السلطان هو الأصل، وليس الأمة، وبالتالي فصلاحه سيؤدي إلى صلاح الأمة، وليس صلاح الأمة سيؤدي إلى إصلاح الإمام، لأن الأمة -وفق هذه المقولة- ليست مصدرا للسلطة والسيادة فكيف يمكنها أن تُصلْح حكّامها وتقوّم اعوجاجهم، بل هي تابعة مملوكة لحكّامها، إذا صَلَحوا صلُح أمرهم وإذا فَسدَوا فسد أمرهم. من هنا نفهم لماذا قال الفقيه: “لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان”، لأن حاضر الأمة ومستقبلها ومصيرها أصبح بيد هؤلاء السلاطين . ولا معقّب لحكمهم!
هذا هو البعد الديني المضمر لهذه المقولة الخطيرة .
بعبارة أخرى: لو كان هذا العقل الفقهي الذي أصبح يتماهى ويتشكّل مع الملك العضوض ينظر إلى السلطان على أنه مجرّد (وكيل وأجير) وأن الأمة هي الأصل، وأنها تملك الحق في اختياره وتعيينه وخلعه، وبالتالي فصلاحها هو صلاح أجيرها ووكيلها؛ لو كان هذا العقل الفقهي ينظر إلى الأمة بهذه النظرة لجعل دعوته المستجابة للأمة مباشرة وليس للسلطان. فالشعب أولى بالدعوة المستجابة من السلطان، لأنه الأصل، ولأنه مصدر السلطة والسيادة، وبالتالي فصلاحه ينعكس على صلاح الحاكم والدولة والسياسية والبلاد.
في كلمة واحدة:الأمة هي الأصل، وهي مصدر مشروعية السلطة . وليس الغيب أو الخرافة أو الأسطورة.
خاص بموقع “المقال”
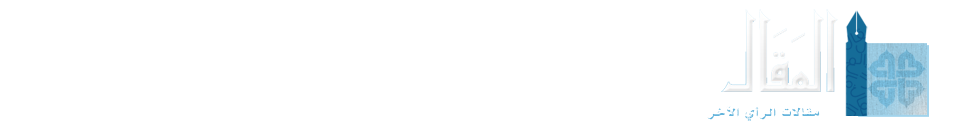











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك