قطاع غزة: حكاية مقاومة
 13 يوليو, 2014
13 يوليو, 2014  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
قطاع غزة، هو ذلك الشريط الممتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والذي يُشكل 1.33% من أرض فلسطين التاريخية، ويُعتبر نسل اللاجئين، الذين فقدوا أراضيهم بعد حرب 1948 الغالبية العظمى من سكانه، ويُعد من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم؛ إذ يعيش على أرض القطاع البالغ مساحتها 360 كم مربع، ما يقارب المليوني نسمة. وُضع القطاع تحت الإدارة المصرية، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية – الإسرائيلية عام 1949، والتي حددت خط الهدنة بين الجانبين، وفي عام 1950، وُقّعت اتفاقية تسوية مؤقتة بين مصر والكيان الصهيوني، تُعرف بـ “اتفاقية التعايش“، تم بموجبها إعادة ترسيم خط الهدنة، وبالتالي استيلاء الصهاينة على ما يقارب 200 كيلو متر مربع من أرض القطاع. بعد حرب 1967، تم احتلال القطاع كاملاً -إلى جانب سيناء والضفة الغربية-، فأُعيد ترتيب الهياكل المدنية والإدارية، وصودرت الأراضي الفلسطينية، وخُصِّصت لبناء المستوطنات والطرق والمنشئات العسكرية الإسرائيلية، إذ أُنشئت بين (يونيو/حزيران 1967، وسبتمبر/أيلول 2005) 21 مستوطنة، تؤوي 8000 مستوطن، على 20% من أرض القطاع، مما سبب نزوح داخلي لأعداد كبيرة من الفلسطينيين. كما تم باسم حماية مناطق الاستيطان، حرمان الفلسطينيين من حيازة 30% من ممتلكاتهم، لما يقارب الأربعين عاما، بالإضافة لتجريف الأراضي الزراعية.
في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1987، قام سائق شاحنة إسرائيلي، بدهس عمال فلسطينيين، عند حاجز “إريز” في جباليا، الذي يفصل قطاع غزة عن باقي فلسطين، مما أدى إلى وفاة أربعة وجرح سبعة آخرين. أثناء الجنازة، قام المشيعون بإلقاء الحجارة على موقع لجيش العدو، الذي رد عليهم بإطلاق النار، فانطلقت الشرارة التي أدّت إلى “انتفاضة الحجارة”، أو الانتفاضة الأولى، وقد كان لمشاعر الظلم والمهانة تحت الاحتلال، ورفض استمراره، الأثر الكبير لانتشار نار هذه الشرارة إلى كل مناطق فلسطين، بمدنها وقراها ومخيماتها، وكانت حركة المقاومة حماس، قد ولدت من رحم هذه الانتفاضة، حين تم إعلان إنشائها، في الرابع عشر من ديسمبر 1987، والتي بدأت بشن هجماتها ضد جنود الاحتلال، وتُعد عمليات الشهيد المناضل “يحيى عياش” من أبرز هذه الهجمات. زاد الحشد في فبراير/شباط 1988، عندما نشرت وسائل الإعلام صوراً لجنود الاحتلال وهم يستخدمون الحجارة، لكسر أذرع أطفال وشباب الحجارة في نابلس، فأثارت هذه المشاهد لوحشية وهمجية المحتل مشاعر تعاطف الكثيرين حول العالم، وكان عدد منهم لا يعلم شيئاً عن فلسطين. استمرت هذه الانتفاضة على شكل حملة عصيان مدني، رغم اعتقال وقتل الآلاف، -استمرت لعام ونصف-، شارك فيها مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، فقاموا بتنظيم التظاهرات، وتوزيع المناشير التي تحث على التظاهر، ونشأت لجان شعبية محلية، تعمل على توفير المئونة والإسعاف والدواء. ويمكن القول أن من أهم آثار هذه الانتفاضة؛ تعزيزها لمشاعر العروبة، والرغبة بالتحرر لدى عرب 48، الذين نظّموا التظاهرات والإضرابات، وأرسلوا المساعدات والمعونات الغذائية والمالية والتبرعات بالدم لإخوتهم في الضفة والقطاع، مما أضعف كثيراً آثار سياسات التهويد وطمس الهوية التي ينتهجها الصهاينة، وكان كيان الاحتلال قد فرض قيوداً شديدة على وسائل الإعلام، وتوقف عن منح الصحفيين الغربيين تأشيرات دخول، في محاولة لإنقاذ صورته أمام الرأي العام الغربي.
حققت هذه الانتفاضة إضافات مهمة لكفاح الشعب الفلسطيني الطامح للتحرر، إذ توحد الشعب والتف حول قضيته، واستطاع كسب تأييد شعوب العالم، والأهم من ذلك عادت قضية العرب الأولى فلسطين إلى الواجهة بالنسبة للشعوب العربية، وأثبت الشعب الفلسطيني المناضل قدرة هائلة على الصمود والتنظيم والاستمرارية، وابتكار أساليب جديدة للكفاح، حتى قام الصهاينة بتوقيع معاهدة أوسلو، مع منظمة التحرير، في محاولة لإجهاض انتفاضة الحجارة، والالتفاف على مكتسباتها.
كان لتوقيع معاهدة أوسلو في 13 سبتمبر/أيلول 1993، أثره الكبير على القطاع والقضية الفلسطينية ككل، حيث أحدث إقدام منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بقيادات فتح، على توقيع الاتفاقية، بعد محادثات سرية مع المحتل، شرخاً كبيراً في كيان الشعب الفلسطيني و وحدته حول القضية، وأعاد النضال التحرري إلى المربع الأول، بعد أن همّش منظمة التحرير لصالح السلطة الفلسطينية، الخاضعة لهيمنة المحتل، والمقيّدة باتفاقيات السلام معه. ضَمِن الاتفاق الاستقرار للكيان الصهيوني، فتزايدت أعداد المهاجرين الصهاينة إلى أرض فلسطين المحتلة، وتمدّدت المستوطنات التي باتت تُقطِّع أوصال المناطق التي يُفترض أنها خاضعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، كما استحوذت دولة الاحتلال على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الزراعية، فعلى سبيل المثال، منح الاتفاق للمحتل 85% من مخزون المياه الجوفية، التي يقع أكثرها في المنطقة (C)، والتي تشكل 60% من أرض الضفة الغربية، إذ قسّم الاتفاق الأرض الفلسطينية إلى ثلاث مناطق (A.B.C)، تبلغ مساحة المنطقة الأولى 5%، وتمتلكها السلطة الفلسطينية، بينما تخضع المنطقة الثانية والبالغ مساحتها 35%، للسلطة إدارياً وخدميّاً، ولدولة الاحتلال أمنياً، وتقع المنطقة الأخيرة (60%) تحت سلطة الاحتلال بالكامل. والأخطر من كل ذلك؛ هو نهج السلطة القائم على التبعية السياسية والاقتصادية للمحتل، حيث أصبحت السياسات التي تُقر من جانبه، تسري تلقائياً على الجانب الفلسطيني، جنباً إلى جنب مع التنسيق الأمني بينهما، الذي سهل على المحتل قمع المقاومة، واعتقال المقاومين.
في غزة، سمحت الاتفاقية للصيادين الفلسطينيين، بالصيد حتى مسافة 20 ميل بحري فقط، ورغم ذلك، قام الكيان المحتل، تزامناً مع ترسيم الحدود البرية والبحرية، بتقليص المسافة إلى 6 أميال، ولم يكتفي بذلك؛ بل يقوم بتقليص المسافة إلى النصف (3 أميال)، كلما أراد؛ باعتباره الطرف الأقوى، والذي يمنح الحق أو يمنعه. ويتعرض صيادو غزة لاعتداءات جنود الاحتلال التي تشمل الاعتقال والتعذيب وحتى القتل، بالإضافة إلى تخريب ومصادرة المراكب. وأعقب توقيع الاتفاقية، قيام الصهاينة ببناء سياج عازل بينهم وبين غزة، تحت حجة تحسين الوضع الأمني، الأمر الذي أدّى إلى حصار القطاع، مع استمرار سيطرة الصهاينة على مجاله الجوي وحدوده البرية ومياهه الإقليمية. وكانت الشرطة الفلسطينية، تقوم بدوريات أمنية في القطاع، لمنع المقاومين من تهريب الأسلحة والذخائر أو المعدات ذات الصلة. وكأن الهدف من هذا الاتفاق، هو الاعتراف بالسلطة الفلسطينية، مقابل التنازل عن الأرض، وإسباغ الشرعية على المحتل.
بعد معايشة الفلسطينيين لمخرجات أوسلو المجحفة في حقهم، والتي لم يقطف ثمارها سوى المحتل، فزادت من قوته وتجبره، وتصاعدت عمليات الاغتيال والاعتقال والاجتياح وبناء المستوطنات، مع رفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كان تدنيس رئيس حزب الليكود السابق “أرئيل شارون” مع حرّاسه، للحرم القدسي، في 28 سبتمبر/أيلول 2000، بمثابة القنبلة التي فجّرت الانتفاضة الثانية، أو انتفاضة الأقصى، عندما انتفض المصلون لمنع الإرهابي شارون من الوصول إلى المصلى المرواني، فاشتبكوا اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال، وفي اليوم التالي، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأطلقت النيران على المصلين، فاستشهد 9، وجُرح آخرون، مما أدى لانتشار المواجهات في كل مناطق فلسطين، استخدمت خلالها قوى الاحتلال، المروحيات الحربية والمدفعية والدبابات، وتطورت بالمقابل أدوات المقاومة الفلسطينية، فبعد أن كانت تستخدم الحجارة، والزجاجات الحارقة، والسلاح الأبيض في الانتفاضة الأولى، أصبحت تقاوم باستخدام البنادق والقنابل اليدوية والألغام والعبوات الناسفة، فتمكنت من قتل حوالي 1069 صهيونياً، وجرح 4500 آخرين، وتعطيل 50 دبابة، وتدمير عدد من المدرعات العسكرية. وكان لاستخدام فصائل المقاومة للقذائف الناسفة والصواريخ لقصف الكيان المحتل، الفضل في إجبار قوى الاحتلال إعلان الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، وتفكيك مستوطناتها ومنشآتها العسكرية، وإعلانها ما أسمته بـ “فك الارتباط”، بين (15 أغسطس/آب ، 12 سبتمبر/أيلول 2005)، زاعمة بأنها قد أنهت الاحتلال، إلا أنها مازالت تمارس السيطرة على معظم الحدود البرية للقطاع، فضلاً عن مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
رغم استهداف الصهاينة، للزعيم الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات” في انتفاضة الأقصى، حتى أدى الأمر إلى تصفيته، بالإضافة لتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، استمرت قيادات السلطة بانتهاج سياسات التطبيع والتعاون الأمني مع المحتل، والسير نحو المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات، متجاهلة تضحيات وبطولات الشعب الفلسطيني في انتفاضته الثانية، والتي قد يكون أهمها تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، حين قُهر في معركة الدفاع عن مخيم جنين (أبريل/نيسان 2002)، رغم عدم التكافؤ الكبير في موازين القوى.
في يونيو/حزيران 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة، وأخرجت قوات حركة فتح، الفصيل الذي يقوده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فانقسم القطاع عن الضفة إدارياً. وكانت حماس قد فازت في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006. قام الكيان الصهيوني على إثر ذلك، بفرض حصار عسكري واقتصادي على القطاع، شاركت به مصر عن طريق إغلاقها لمعبر رفح. في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، أعلنت قيادة الاحتلال عن عملية “الرصاص المصبوب”، قائلة بأنها قد تستغرق وقتاً، ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها بإنهاء إطلاق الصواريخ من غزة، بالمقابل أعلنت حماس بأنها ستتابع القتال حتى توقف إسرائيل هجماتها وتنهي الحصار، وكان إعلان العملية بعد خرق الكيان الصهيوني لهدنة تهدئة واغتياله 6 من أعضاء حماس، بالإضافة لرفضه رفع الحصار عن غزة، والذي كان أحد شروط التهدئة، وبالتالي رفضت حماس التمديد. وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد نشرت جرداً للخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق، وقالت أنها بلغت 195 خرقا في القطاع. استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية، كما لجأت لاستخدام الأسلحة الفسفورية أمريكية الصنع في قصف القطاع لإخضاعه، وخاضت خطوتها الأخيرة بالاجتياح البري، إلا أن صمود المقاومة، وقدرتها على قصف مدن الاحتلال، أجبرها على الانسحاب من القطاع في 18 يناير/كانون الثاني 2009، وإيقاف القصف دون أن تحقق أهدافها. وكررت قوات الاحتلال اعتدائها على القطاع، حين استهدفت رئيس أركان حركة حماس الشهيد “أحمد الجعبري” عام 2012، وردت عليها فصائل المقاومة بعملية “حجارة السجيل”.
بعد حادثة مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، قامت حكومة الاحتلال باتهام حركة حماس بالوقوف خلف الحادث، لتبرر عدوانها الجديد على الضفة والقطاع. على إثر ذلك؛ قام جنود الاحتلال بشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية، إذ تم اعتقال ما يزيد على الألف فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من قادة المقاومة، بالإضافة إلى إعادة اعتقال جميع الأسرى المحررين بعد صفقة شاليط، وفي الثاني من يوليو/تموز 2014، أقدمت جماعة من المستوطنين على خطف وتعذيب، ثم حرق الطفل “محمد أبو خضير” حيا، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في القدس وداخل أرض الـ 48 وفي الضفة، زادت حدتها بعد أن دهس صهيوني عاملَين عربيَّين في حيفا. وفي الثامن من يوليو/تموز، بدأ جيش الاحتلال عدوانه على غزة، وأبدت المقاومة -رغم الحصار- تطوراً كبيراً في أساليب ردها على العدوان، على سبيل المثال؛ تمكنت صواريخ المقاومة من الوصول إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، كما قصفت مدينة حيفا، و وصلت صواريخها إلى ديمونة النويية، ومطاري نيفاتيم وريمون العسكريَّين، بالإضافة لاقتحام عناصر كوماندوز تابعة للقسام، قاعدة زيكيم العسكرية، وكانت كتائب القسّام قد أعلنت في 12 يوليو/تموز، بأنها ستقصف تل أبيب وضواحيها بصواريخ “جعبري 80″، في تمام الساعة التاسعة؛ وليست هذه المرة الأولى التي تقصف فيها المقاومة تل أبيب، ولكنها الأولى التي تعلن فيها عن الضربة قبل موعدها بساعة، وتدعو وسائل الإعلام أن توجه كاميراتها نحو تل أبيب، قبل أن تُمطر سماءها بالصواريخ متحدية القبة الحديدية، مما أدى لدوي صافرات الإنذار في كل فلسطين المحتلة، وشل الحركة في تل أبيب وضواحيها، وفرار ملايين الصهاينة واختبائهم في الملاجئ، بالإضافة لإصابة عدد منهم بنوبات هلع.
اليوم يتكرر القصف على غزة، ويستمر صمود المقاومة، مع استمرار صمت وخذلان العرب، وتبني بعض كتّابهم ومثقّفيهم، لخطاب المحتل وترديد دعاياته، من إلقاء اللوم على المقاومة وتحميلها مسئولية دماء الشهداء والجرحى، وكل الدمار الذي حلّ ويحل على القطاع، مع تكرار أسئلة على شاكلة، ماذا قدمت المقاومة لفلسطين؟، من هنا نرد بالسؤال، ماذا قدمت السلطة التي ولدت من رحم اتفاق أوسلو لفلسطين؟، جميع الخرائط والأرقام تثبت تمدد الاستيطان، وارتفاع أعداد الأسرى، وزيادة قوة الكيان المحتل، بعد توقيع معاهدات السلام معه، وإسباغ الشرعية عليه، وتحويل موقعه من عدو محتل، إلى شريك في عملية السلام، وكأن المسألة مسألة خلافات حدودية بين جارين، وليست مسألة احتلال أرض وتهجير شعب. في المقابل، تمكنت المقاومة من إجبار المحتل على الانسحاب، وتفكيك المستوطنات، وإطلاق قوافل من الأسرى، وكبّدته خسائر بشرية ومادية، وكشفت زيف أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، مما زاد من نسبة الهجرة العكسية لدى المستوطنين بحثاً عن الأمن. علاوة على ذلك، أسهمت المقاومة في كشف الوجه الحقيقي للصهاينة، ودحض الدعايات التي يقومون بترويجها لدولتهم باعتبارها دولة ديمقراطية تحترم القانون.
وتجدر الإشارة إلى أهمية رصد الاعتداءات الهمجية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا في فلسطين، إلّا أن تبني الخطاب الحقوقي الذي يناشد المجتمع الدولي لإدانة جرائم المحتل، لا يصب في خدمة المقاومة، ولن يسهم في التحرير؛ لأن “الشرعية الدولية”، هي التي منحت الشرعية للكيان الصهيوني، وإن دعمت حق الفلسطينيين في أرضهم، فإنها لا تدعم تحرير كامل فلسطين، وإن أقرّت حق اللاجئين بالعودة، فإنها لا تقر عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي تقوم عليها “دولة” إسرائيل الآن، والأهم من كل ذلك، هو أن الشرعية الدولية خاضعة تماماً للهيمنة الأمريكية، وبالتالي؛ فإن التعويل عليها يعني التعويل على الصهاينة ذاتهم.
في الختام، يجب التأكيد على خطورة التطبيع مع العدو بكل أشكاله، لأنه يهدم عقوداً من النضال الفلسطيني السامي للتحرر، ويؤدي إلى خلق جيل جديد، يتقبل المحتل ويسلّم بقوته، أو حتى يعجب به، وبالتالي يتنازل عن الثوابت والحقوق، في مقابل تحسين شروط العيش المشترك. إن مشروع دولة إسرائيل هو مشروع استيطاني مدعوم من قوى استعمارية، ولا يمكن مجابهته إلا بتبني مشروع قائم على تحرير الأرض وتفكيك المستوطنات، ولا يمكن أن تكون هناك دولة لشعب تحت الاحتلال، إلا بإنهاء دولة الاحتلال، ولن يحدث ذلك، إلا عن طريق مشاريع قائمة على المقاومة، لا محاولة إحياء مبادرة السلام العربية -التي وُلدت ميتة-، بشكلٍ مخزٍ ومثيرٍ للشفقة.
خاص بموقع “المقال”
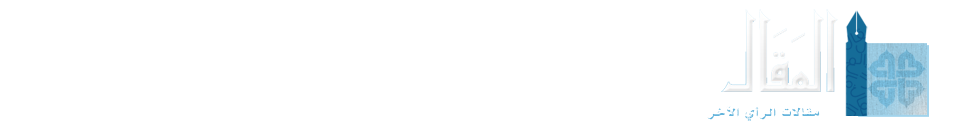











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك