في تهافت مبررات التطبيع
 6 فبراير, 2014
6 فبراير, 2014  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
على امتداد القرن التاسع عشر وحتى مُستهل القرن العشرين، امتلأت المكتبات الأوروبية بالكتب الأدبية والفلسفية المعادية لليهود، والتي تصورهم بمجموعة من الصور النمطية المسيئة، كوصفهم بالشيطانيين، و الطفيليين، ومنعدمي الشرف والأمانة … وغيرها من الأوصاف النابعة من اعتبارات أنثروبولوجية تقسم العالم إلى أعراق نبيلة وأخرى منحطة؛ مما هيأ المناخ لولادة “النازية” والتي تُعد ترجمة سياسية وعسكرية لكل هذه التراكمات العنصرية المعادية للأعراق الأخرى والمترسبة منذ ما يسمى بعصر النهضة، أي أن النازية بكل فظاعاتها -والتي لا تقتصر على “الهولوكوست”- صناعة أوروبية، وليست مجرد حالة ألمانية أو حدث خارج الزمان ناتج عن وجود شخصية “هتلر”؛ فقد عانى اليهود في كل أرجاء أوروبا من الاضطهاد بشكل أو بآخر، بداية من اعتبار المسيحية لليهود جنس غير كامل الإنسانية، مروراً بالنظرة العنصرية لهم واعتبارهم دخلاء على النسيج الأوروبي.
وقد استفادت الحركة الصهيونية من النازية في تحقيق مشروعها، والذي كان يطمح لإقامة دولة لليهود على أرض فلسطين، مستغلة آلام ومعاناة اليهود في أوروبا لتحقيق أهدافها السياسية، دون أن تحاول إنقاذ الضحايا أو مساعدتهم في الحقيقة، لدرجة أن كل صهيوني أصبح يعتبر نفسه “ضحية” للمحرقة، حتى وإن كان في الواقع أحد أعضاء “الكابو” (وهو مصطلح يطلق على اليهود الذين مُنحوا سلطة على اليهود الآخرين؛ ليقوموا بأعمال القتل والتعذيب لصالح النازيين)، وقد تبنى الاستعمار الأوروبي -البريطاني تحديداً- المشروع الصهيوني؛ لرغبة دول أوروبا بإزاحة عبء تاريخها الدموي والعنصري عن كاهلها، وليتم التخلص من اليهود على أراضيها تحت حجة تعويض ضحايا المحرقة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يحقق أهدافاً ثقافية وإستراتيجية واقتصادية تسهم في تقسيم وتجزئة البلاد العربية لما يخدم مصالح قوى الاستعمار؛ لتكون النكبة، وإعلان إقامة دولة إسرائيل في عام 1948، وذلك على أرضنا وعن طريق قتل وتهجير أهلنا في فلسطين.
المؤرخ والمفكر العروبي قسطنطين زريق؛ هو أول من أطلق مصطلح “النكبة”، معتبراً تأسيس إسرائيل كارثة من حيث آثارها على مشروع الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار، وبذات المنظور كان العرب ينظرون لما يحدث في فلسطين؛ معتبرين القضية قضيتهم وليست مجرد مصيبة حلت على الفلسطينيين، خاصة وأنها كانت فترة ثورات وتحرر من الاستعمار البريطاني/الفرنسي، حين كان المشروع القومي التحرري في فترته الذهبية.
استمرت حالة العداء بين العرب ودولة الاحتلال حتى عام 1973، ولم تكن فكرة التطبيع أو تقبل الوجود الصهيوني في المنطقة أمراً وارداً، إلى أن كان أول كسر لهذا الموقف العربي في عام 1977 حين زار السادات إسرائيل، وألقى كلمة أمام الكنيست مما جاء فيها: “أنتم تريدون العيش معنا في هذه المنطقة من العالم، وأنا أقول لكم بكل الإخلاص أننا نرحب بكم بيننا بكل الأمن والأمان”. وكانت هذه نقطة تحول هائلة في شكل العلاقة مع دولة الاحتلال، حيث تلت هذه الزيارة اتفاقية كامب ديفيد الأولى ثم اتفاقية السلام، مما فتح باب التطبيع مع المحتل، وحقق لإسرائيل أهم ما تطمح إليه؛ وهو الاعتراف بها، وإخراج مصر من حالة الصراع معها. ونتيجة لذلك برزت الكثير من الأصوات الداعية إلى التطبيع مع العدو الصهيوني.
يُستخدم مصطلح “التطبيع” للإشارة إلى التحول من حالة الحرب أو الصراع بين دولتين، إلى حالة تكون فيها العلاقات بينهما “طبيعية”؛ وذلك عن طريق إنهاء أو تجاوز كل ما يوتر هذه العلاقات، ومد جسور التعاون في كافة المجالات الدبلوماسية، والاقتصادية، والثقافية، .. الخ، وتشجيع كل ما يساعد على إزالة الحاجز النفسي في شكل التعامل بين الدولتين.
من هنا، يرى البعض أن التطبيع مع دولة الاحتلال هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، ولدى أصحاب هذه الرؤية مجموعة من المبررات، والتي ترتكز على تصورات ومفاهيم يظهر لنا بعد مناقشتها في بقية المقال أنها خاطئة.
-
الواقعية السياسية:
يرى أصحاب هذه النظرة، بأن وجود دولة إسرائيل أمر واقع، ومحاولة مقاومة هذا الواقع “تهور” ورومانسية؛ وذلك بسبب ما تحظى به هذه الدولة من دعم أمريكي و دولي، في مقابل حالة الضعف والتفكك التي نمر بها نحن العرب، لذا علينا أن نتقبل وجود دولة الاحتلال كحالة دائمة أو (مؤقتة حتى نتمكن من بناء قوة عسكرية واقتصادية تؤهلنا للمواجهة مع المحتل).
ويأتي الرد على وجهين: أولاً، لا يدرك هؤلاء أن ما يظنوه واقعياً هو غير الواقعي؛ إذ لا يمكن أبداً أن تنشأ علاقة طبيعية بين المحتل ودولة تحت الاحتلال وشعب في الشتات، لأن ذلك يعني القبول بمعايير المحتل فيما يراه طبيعياً، فالحديث هنا ليس عن دولتين “ذات سيادة” نشأ بينهما صراع، ثم قررا إعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد زوال مسببات هذا الصراع؛ بل عن دولة تم إنشاؤها مكان شعب تم تهجيره، وكل ما تطمح إليه هذه الدولة هو الاعتراف بها وبشرعية وجودها، إذاً التطبيع في هذه الحالة لا يعني إقامة علاقات طبيعية، بل يعني منح الاحتلال المشروعية السياسية ليحقق أهدافه في الهيمنة ومحو كل ما يتعلق بهوية البلد المحتلة.
ثانياً، الواقعي والطبيعي هو أن تتم مقاومة المحتل بشتى الوسائل الممكنة، والحديث عن عدم جدوى المقاومة ينافي الواقع؛ فقد تمكنت المقاومة اللبنانية من تحرير الجنوب وتكبيد المحتل خسائر على كافة الأصعدة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، كما أن المقاومة الفلسطينية كانت وما زالت تضرب أمثلة بطولية في الصمود والمواجهة؛ حيث منعت آلة القتل الإسرائيلية من تحقيق أهدافها في جميع أشكال العدوان التي شنتها على غزة، والتي لم تستطع إجبار المقاومة على قبول تسويات مُذلة وفقاً لشروطها، بل حققت صواريخ المقاومة تقدماً نوعياً حين تمكنت من ضرب تل أبيب عدة مرات، على الرغم من كل ما تتعرض له من تضييق وملاحقة من السلطة الفلسطينية ذاتها، وذلك بتنسيق أمني مع دولة الاحتلال.
-
المنطلقات الإنسانية:
هناك من يتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مسألة إنسانية، وليست مسألة احتلال أرض وتهجير شعب، وبسبب هذا التصور الخاطئ؛ يتم التوصل إلى حلول خاطئة، كاعتبار التطبيع والقبول بالتسويات “حلاً” يوقف نزيف الدم. يظن من يتعاطى مع القضية من هذا المنطلق بأنه يحمي “الضحية”، لكنه في الواقع يقف في صف المحتل ويسهل عليه الاستمرار في سياساته التوسعية والاستيطانية والتهويدية، التي تستهدف وجدان وذاكرة الإنسان الفلسطيني، دون أن يكون هناك أي رادع أو مقاومة.
إن التعامل مع القضية الفلسطينية من هذا المنظور، يفرغها من مضمونها، ويلغي تاريخاً من النضال في سبيل التحرر واستعادة الأرض والذي لا يمكن أن يتحقق بدون دماء وتضحيات.
-
قضية فلسطين شأن فلسطيني خاص:
أدت مسألة التجزئة في الوطن العربي، إلى تكريس منطق الدول القطرية، والتي تحكمها أنظمة تدور في فلك الاستعمار، ولا تمانع من عقد صفقات مع المحتل في سبيل بقائها ولتحافظ على مصالحها، مما أثر على قضية فلسطين بشكل كبير؛ حيث أصبحت بنظر البعض شأناً فلسطينياً، ولا يقع على العرب أي واجب أو التزام تجاهها، وبما أن منظمة التحرير المعترف بها كـ “ممثل شرعي و وحيد” للشعب الفلسطيني؛ قد اعترفت بإسرائيل واختارت طريق التسويات، فإن دورنا هو مساندتها في قراراتها.
يعاني هذا الطرح من مغالطتين تاريخيتين: الأولى، هذا الادعاء يفترض أن إنشاء الكيان الصهيوني كان يستهدف فلسطين وحدها لا الأمة العربية؛ لتقسيمها في سبيل تنفيذ خطط استعمارية تستهدف المنطقة بأسرها، ولو كان الأمر كذلك؛ لما اجتمعت كل من المقاومة الفلسطينية ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان والسعودية للحرب ضد الميليشيات اليهودية المسلحة في فلسطين عام 1948، بعد إعلان قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية، ولما حدثت معارك بين دول عربية وإسرائيل بعدها كالعدوان الثلاثي، وحرب حزيران “النكسة” وغيرها من المعارك التي خاضتها الدول العربية لشعورها بخطورة وجود دولة الاحتلال عليها. هذا، ويستمر احتلال إسرائيل للجولان (السورية) وشبعا (اللبنانية) حتى اليوم.
الثانية: إعلان منظمة التحرير كممثل شرعي و وحيد للشعب الفلسطيني، لم يكن نتيجة استفتاء شعبي، بل جاء كقرار من الزعماء العرب في قمة الرباط عام 1974، تم فرضه بعد ذلك على الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية عن طريق عدد من الإجراءات القانونية، بهدف إيجاد جهة فلسطينية يتم تحميلها عبء القضية، ليتفرغوا للتسويات المنفردة مع إسرائيل.
بدأت المنظمة بتبني الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، لكنها هُمشت تماماً خاصة بعد اتفاق أوسلو واعترافها بإسرائيل، لتكون النتيجة تأسيس سلطة فلسطينية؛ مستعدة للتعاون مع المحتل وتقديم التنازلات لتحافظ على وجودها على حساب القضية. لذا، لا يحق لأي جهة أن تعتبر نفسها ممثلاً للشعب الفلسطيني أو معبراً عن إرادته.
-
طول الفترة الزمنية للاحتلال:
يظن البعض بأن طول فترة الاحتلال، يعني وجود أجيال جديدة لا تعرف بلداً لها غير دولة الاحتلال، مما يمنحها الحق في البقاء، وبالتالي يمنح للمحتل الشرعية.
لو سلمنا بهذا المنطق، لما تحررت أمة في شرق الأرض أو غربها، والأمثلة على أمم تحررت بعد فترات احتلال دامت طويلاً كثيرة، ففي وطننا العربي، استمر الاحتلال البريطاني في اليمن 120 عاماً، وبقيت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي 130 عاماً، وكل ذلك لم يمنح المحتل المشروعية للاستمرار أو البقاء. وأرى أن عامل الزمن هو أكثر ما يراهن عليه الكيان الصهيوني؛ ليكسر إرادة الشعب، وييأس اللاجئون من العودة، ويواصل مخططاته في التهويد وتزوير التاريخ، لكن الأرض تبقى لأصحابها ما دام هناك من يناضل لاستعادتها. أما الأجيال المولودة في فلسطين من المستوطنين الصهاينة، فبإمكانهم البقاء باعتبارهم مواطنين؛ إذ أن النضال لا يهدف للانتقام من اليهود بتصفيتهم عرقياً أو حتى تهجيرهم، وإنما يهدف لإنهاء الاحتلال بكل أشكاله وكل سياساته بما فيها سياسة الفصل العنصري.
-
الإعجاب بالمحتل:
يعاني البعض من نزعة استشراقية قائمة على عقدة نقص واحتقار للذات، فإسرائيل حسب رؤيتهم تمثل امتداد للغرب المتحضر، المتقدم، والديمقراطي؛ وعلينا أن نطبع معها لنستفيد من وجودها بيننا.
هؤلاء متصهينون وأحياناً أكثر من الصهاينة أنفسهم، نعم إسرائيل امتداد للغرب؛ ولكنها امتداد للغرب العنصري الذي صنع “المسألة اليهودية” بعنصريته، وامتداد للغرب الاستعماري الذي زرع إسرائيل على أرضنا ليحل مشاكله على حسابنا، وبدعمه لإسرائيل فإنه يدعم كيان عنصري استعماري، لا يقوم على التقدم العلمي والحضاري – مع أن هذا الادعاء إن صح لا يشرعن وجود المحتل أو يبرر بقاءه- كما يظن هؤلاء؛ بل على جرائم لا تقل في فظاعتها عن النازية؛ من مجازر منظمة راح ضحيتها آلاف الأهالي بينهم أطفال، وتدمير القرى، واتباع سياسة التهجير الممنهج، واغتصاب النساء، وإعدام وتعذيب الأسرى.
ومن مظاهر عنصرية هذا الكيان وتأثره بالنازية، استحداثه لما يعرف بـ “الشوارع المعقمة”؛ وهي شبكة طرق حديثة وسريعة تربط المستوطنات بعضها ببعض، مخصصة فقط لليهود، ويمنع العرب الفلسطينيين الذين صودرت أراضيهم، وأقيمت الطرق عليها من استخدامها، وتقع الشوارع المخصصة للعرب تحت شوارع اليهود المعقمة. هذا بالإضافة لبناء الجدار العازل على الأراضي الفلسطينية لعزل القرى العربية، مع بناء عدد من الحواجز المؤقتة للتفتيش، بهدف إذلال الفلسطينيين وتقييد حريتهم بالتنقل والزيادة في تعقيد حياتهم، مع تفشي العنصرية ضدهم في التعليم والعمل.
ولا تقتصر اعتداءات إسرائيل البلد “الديمقراطي” و “الحر” على العرب؛ فقد ارتكبت جرائم قتل بحق صحفيين ومتضامنين أجانب، ربما تكون أشهرهم المتضامنة الأمريكية “ريتشيل كوري” والتي دهستها جرافة إسرائيلية كانت تحاول منعها من العبور لهدم مباني في مدينة رفح، بالإضافة لعدد من الاعتداءات على سفن الحرية، ولا يتسع المجال لذكر جميع جرائم الاحتلال والذي يعتبر جريمة في حد ذاته.
أطلقت جامعة الدول العربية في قمتها المنعقدة في بيروت عام 2002، ما يعرف بـ “مبادرة السلام العربية”، والتي تضمن الأمن لجميع دول المنطقة، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين باتفاق الطرفين وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194، وقد جاء رد الحكومة الإسرائيلية على العرض العربي بالرفض القاطع، لأن قرار الأمم المتحدة ينص على حق عودة اللاجئين.
وبدلاً من أن تسحب الدول العربية هذه المبادرة، قامت بتعديل أحد بنودها لتلاقي استحسان الجانب الإسرائيلي، حين أجازت مبدأ تبادل الأرض بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى الرغم من استجداء القيادات العربية لرضى إسرائيل، إلا أن الموقف الإسرائيلي ظل متعنتاً، حين علقت تسيبي ليفني على التعديل بدعوتها للفلسطينيين بدخول غرفة المفاوضات وتقديم “التنازلات اللازمة”.
ما لا يريد القادة العرب فهمه هو أن إسرائيل لا تفهم سوى منطق القوة، وأن هذه المبادرات المنطلقة من منطق الضعف والعجز تصب في صالح المحتل وتقوي من موقفه، وأن ضعفهم ناتج عن افتقارهم للتمثيل الشعبي الذي يدعم خياراتهم؛ حيث اختارت الأنظمة الحاكمة أن تعتمد على الدعم الخارجي وأن تنفذ أجندته، لتحافظ على مصالحها المتداخلة مع مصالح المحتل، والمناقضة تماماً لمصلحة وإرادة الشعوب الطامحة للاستقلال والتحرر.
خاص بموقع “المقال”
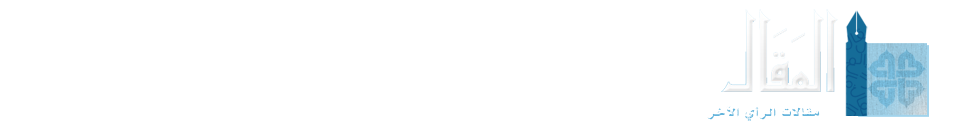











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك