
الدولة السلطانية
 3 فبراير, 2014
3 فبراير, 2014  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
تعتبر الدولة السلطانية بكل أدبياتها التي ورثتها عن الفقه الساساني مصدراً ثرياً للاستبداد، ومنبعاً هاماً لاستمراره ،منذ أواخر الدولة الأموية وحتى العصر الحديث.
وقد جعل بعض الباحثين تلازماً بين السلطان والعنف، فتعريف السلطان بالعنف يشكل بعداً أساسياً في مفهوم السلطان، يكاد يبلغ مرتبة الهوية، وهو تعريف بالحد لا بمجرد الرسم. ويقتضي بذاته استعمالا لقوةو القهر والغلبة دفعاً لعوارض الزوال والانتقال والتداول ص84 .
وقد نتج عن تكريس النموذج الفارسي في الثقافة الإسلامية إعادة ترتيب علاقة الدولة بالقبيلة، وعلاقة العقيدة بطاعة الإمام، وإفراغ الشورى من مضمونها، وتحول السلطة إلى الملك الوراثي ، والاصطلاح على جعل الحاكم خليفة الله في أرضه .
واعتبر رضوان السيد والجابري أن نقل وترجمة نصوص الأدب السلطانية وغرسها في الثقافة الإسلامية كانت تهدف بالدرجة الأولى بعد إعادة إنتاجها المحافظة على استمرار السلطة وبقاء الحاكم المتفرد بالسلطة سلطان الله في أرضة.
ويرى د.كمال عبداللطيف أن نشأة الخطاب السلطاني لم يكن في لحظة مثاقفة محايدة ، بل كانت نشأته في إطار وظيفي معين يتجلى في التنظير لدولة إمبراطورية “
ويرى رضوان السيد أن التشابه بين النموذج السياسي السلطاني والنموذج الإمبراطوري لفارس وبيزنطة يعود إلى زمن يواكب لحظة المثاقفة الحاصلة بعد الفتوحات الإسلامية.
التراتبية المجتمعية
تضع الدولة السلطانية الحدود الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، عبر ما يسمى بالتراتبية المجتمعية، أو عبر التصنيفات الثنائية: الملك والعامة، مقابل الروح والجسد، أو الرأس والجسد، وفي كلا الأمرين تكون الروح أو العقل أرفع منزلة من الجسد فتصبح علاقة الشعب بالحاكم علاقة طبقية غير متكافئة بلا كيف .
وعبر التراتبية الاجتماعية يصبح الحاكم سيداً والشعب عبداً، فوق الجميع، والجميع تحته قوته القاهرة .أو كما يقول ابن خلدون ” إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويجبي الأموال، ويبعث البعوث ويحمي الثغور، ولا يتكون فوق يده قوة قاهرة ”
ويعتبر الماوردي واحداً ممن أسهم بقدر كبير في ترسيخ معاني التراتبية المجتمعية، فقد أسهمت كتاباته في نصيحة الملوك، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر، إضافة لكتابة الشهير الأحكام السلطانية في تطبيع وتأصيل فكر الدولة الساسانية بما تحمله من تعظيم للسلطة الحاكمة، وصبغ أفكارها بالفقه، وهو ما جعله متمايزاً عن الجاحظ وابن المقفع، اللذان كانا أشبه برسل البريد بين الثقافتين، فالوظيفة الأساسية لهما كانت نقل وترجمة وترتيب، ولم تكن تأصيلية أو ما يعرف اليوم بأسلمة الثقافة الوافدة .
أورد الماوردي في كتابه نصيحة الملوك وهو من أشهر كتب الأدب السلطانية نصاً صريحاً يضع الحاكم في مرتبة والشعب خادم وعبد بين يدي حاكم فيقول: ” ثم فضل الله جل ذكره الملوك على طبقات البشر تفضيل البشر على سائر أنواع الخلق وأجناسه، بجهات كثيرة ودلائل موجودة، وشواهد في العقل والسمع جميعاً … منها أن الله تعالى أكرمهم بالصفة التي وصف بها نفسه، فسماهم ملوكاً وسمى نفسه ملكاً فقال: ” مالك يوم الدين وقال ” فتعالى الله الملك الحق. وقال فيما وصف به ملوك البشر: ( إن الله بعث لكم طالوت ملكا وقال: ( إذ جعل فيكم أنبياء وملوكا). فليس أحد في حكم هذا اللفظ أولى بالفضل، ولا أجزل قسماً، ولا أرفع درجة من الملوك، إذ كل البشر مسخرين لهم، وممتهنين لخدمتهم ومتصرفين في أمرهم ونهييهم ” …”
وفي نص آخر اعتبر أن سبب تسمية الملوك بالرعاة “تشبيهاً لهم بالرعاة الذين يرعون السوائم والبهائم” وسبب تسمية الحكماء للملوك بالساسة، “لأن محلهم من مسوسيهم محل السائس مما يسوسه من البهائم والدواب الناقصة الحال من القيام بأمور نفسها، والعلم بمصالحها ومفاسدها”.
موقع الشعب من الحاكم
وفي موضع آخر من كتابه اعتبر الماوردي الشعب كالعبيد والمملوكين مستدلاً على وجهة نظره بالوحي وتوجيه دلالته لما يقصد فيقول: “من جلالة شأن الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أن كل من تحت يد الملك من رعاياه وإن كانوا معاونيه في الصورة ومشابهيه في الخلقة، ولم يتكلف هو اقتناءهم ولا شراءهم فإن محلهم منه في كثير من الجهات محل المملوكين، ولذلك قال جل وعز في قصة سبأ: ” إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ) لأن ملك يملك في أصل اللغة من المِلك (بكسر الميم) لا من المُلك (بضمها). ولأنهم بأجمعهم أي الرعايا ينقسمون قسمين: بين من محله منه محل المادة، وبين من محله منه محل الآلة، فهو يستعملها في مادته على ما يريده ويهواه، ويحبه ويراه، ثم يخرج له صورة عمله على مقدار حذفه بالصناعة، وإصابته في الغرض والنية”.
أما الجاحظ فقد نص في كتابه تاج الملوك على طريقة الدخول على الملوك حيث يتم الدخول في نسق تراتبي بحسب المنزلة الاجتماعية الأشراف أولاً ثم الأوساط ثم المساوين له والمنادمة مراتب: “من حق الملك أن يقف منه الداخل بالموضع الذي لا ينأى عنه، ولا يقرب منه، وأن يسلم عليه قائماً، فإن استدناه قرب منه فأكب على أطرافه يقبلها، ثم تنحى عنها قائماً، حتى يقف في مرتبة مثله، فإن كلمه أجابه بانخفاض صوت وقلة حركة، ومن حل الملك أن يجعل ندماءه طبقات ومراتب، وأن يخص ويعم، ويقرب ويبعد، ويرفع ويضع….
بل لا يتورع الجاحظ أن يمنح الملك حق التفرد بكل شيء لتأكيد أبهة الملك فيقول: “وأولى الأمور بأخلاق الملك، إن أمكنه التفرد بالماء والهواءـ أن لا يُشرك فيهما أحداً، فإن البهاء والعزة والأبهة في التفرد”
الحاكم مصدر الخير والشعب مصدر الشر
وكما أن الحاكم في الدولة السلطانية في مرتبة لا تتساوى مع شعبه، فهو مصدر الخير وهم مصدر الشر، وقد ذكر الغزالي في كتابه التبر المسبوك في نصيحة الملوك وهو من كتب الأدب السلطانية: “أن الله اختار الملوك ليحفظوا العباد من اعتداء بعضهم على البعض، فإذا كانت وظيفة الأنبياء تتمثل في دعوتهم إلى معرفة السبيل إلى الله، فإن الملوك بعدهم يقومون بمهمة الحماية من الشر المتأصل في نفوسهم” .
وفي عهد أردشير: البشر طماعون، وأصناف مكرهم تتجلى في الغش والترفع والكبر ، ومعاداة الملوك”.
ولأن الشر أصل في الشعب وآفة في المحكومين، فلا بد من الحزم والشدة والحذر يقول الماوردي: ” وليعلم الملك أن من الحزم أن يتصفح أحوال حاشيته وأعوانه في زمان السلم وأوقات السكون، لأن القدرة أشد والمكيدة أمد، فإن لكل صنف من الحواشي والأعوان آفة مفسدة وبلية قادحة، تجعل الصلاح بهم فساداً، والميل منهم عناداً …
ويرى الجاحظ أن من أخلاق الملك البحث عن سرائر خاصته، وإذكاء العيون والجواسيس عليهم، وعلى الرعية عامة ” …
مماثلة الحاكم بالإله
وأسوأ من كل ما سبق مماثلة الحاكم بالإله، مماثلة أحلت الحاكم في مقام الرب، يضع له جنة يدخل فيه كل من أطاعه، وناراً تلظى يكوي بها من عصاه.
فنصوص الأدب السلطانية لم تتحرج في تنزيل الصورة الإلهية وإسكانها قصر الملك … فكيف استطاعت تلك الآداب رفع الملك إلى الصورة الملكية المتعالية، فتقيم تطابقاً بين المرتبة الإلهية بكل قداساتها والوضع الملكي بمختلف ملابساتها التاريخية السياسية.. ، ثم كيف استطاعت المؤسسة الملكية أن توظف حيزاً كبيراً من الإرث الديني والثقافي الإسلامي لترسيخ هذه المماثلة والنظر إليها كواقع بل البحث لها عن المسوغات التي تمنحها الأيدلوجية الفاعلة “
وقد كان للماوردي قدم السبق في شيء من تلك المماثلة بقوله: “إن الله أكرمهم بالصفة التي وصف بها نفسه ، فسماهم ملوكاً وسمى نفسه ملكاً” وفي نص آخر يقول :”إن صنع الملوك غير صنع الرعية… ” وقوله : “ثم فضل الله جل ذكره الملوك على طبقات البشر تفضيل البشر على سائر أنواع الخلق وأجناسه”
أما الطرطوشي فقد ماثل بين الملك والإله بالقياس “فالعالم بأسره في سلطان الله ، كالبلد الواحد في يد سلطان الأرض “
ويقول الجاحظ: “ولم يتقرب العامة للملك بمثل الطاعة، ولا العبيد بمثل الخدمة، ولا البطانة بمثل حسن الاستماع…” وفي نص آخر يقول: “إن الله أوجب على العلماء تعظيم الملوك وتوقيرهم وتعزيزهم وتقريظهم كما أوجب عليهم طاعتهم والخضوع والخشوع لهم” .
واختم بما قاله ابن الطقطقي في رفع مقام السلاطين بالتسبيح بذكرهم، بما يشبه التسبيح بذكر الخالق – جل شأنه – فيقول: “التعظيم والتفخيم لشأنه في الباطن والظاهر! وتعويد النفس على ذلك! ورياضتها به بحيث تصير ملكة مستقرة! وتربية الأولاد على ذلك! وتأديبهم ليتربى هذا المعنى معهم ” “فالطاعة يجب أن تشمل القلوب بعد الجوارح ، والولدان بعد الرجال، ويجب أن تصير الطاعة المطلوبة من الرعية في حكم العادة إن لم تكن في حكم الملكة المستقرة !! “
وهي صورة مقتبسة عن الأساطير القديمة التي تتحدث عن نشأة الكون، يتم فيها تقديم الآلهة في صورة المنتصرين على ممثلي الفوضى والاضطراب في العالم، مقابل انتصار الملوك على فتن الرعية وهرجها
إن الأمر لم يعد في كتب الآداب السلطانية مجرد حاكم له حق الطاعة، فكتّاب الآداب السلطانية ارتفعوا بالحاكم في مقاربات تشد الحاكم من الأرض إلى السماء، وتصنع له الأبهة والسؤدد، وتمنحه الألقاب والأوصاف التي لا تليق إلا برب السماء، كل ذلك لأجل تأكيد قوته المطلقة وسلطانه القاهر، وتثبيت هيبته بين الناس، وجبروته في نفوس المحكومين، فهو الخليفة والإمام والملك والحاكم وسلطان الله في أرضه وظله في أرضه، من سعى ليذل سلطان الله في أرضه أذله الله.
الخلط بين الخلافة والملك
وقد بلغ الخلط بكتاب الآداب السلطانية إلى إلباس الملك بالخلافة، وتجنب التمييز بينهما، في محاولة يائسة لتقديم الدولة السلطانية متطابقة مع دولة الخلافة والرحمة، لتأكيد شرعيتها الدينية، وهو تلبيس لا ينطوي إلا لهدف سياسي يهدف استمرار السلطة وتفرد الحاكم .
وقد أشار فهمي جدعان في كتاب المحنة لصنيع الماوردي بقوله: “يتجنب الماوردي التمييز بين الخلافة والملك ، بل إنه يتكلم عن الإمامة ووظيفتها وهي في نهاية التحليل ملك”
علاقة الدولة بالدين في الدولة السلطانية :
يقول ابن المقفع وهو يوجه الحكام لحراسة الدين في كتاب كليلة ودمنة: “ويقال أربعة أشياء لا يستقل قليلها: النار، والمرض، والعدو، والدين )
بعد تحول الخلافة إلى ملك أصبح هذا التحول عنواناً على اختلاف ميزان الدنيا بالدين إلى ميزان الدين بالدنيا.
فالنص النبوي في التحول يشير إلى جريان تحول موضوعي يقتضي بموجبه أن يساس الدين بالدنيا كما في إشارة ابن خلدون .
فموقع الدين في الحكم الملكي يختلف عن موقعه في النظام الشوري، ولذلك احتاجت الدولة الإسلامية منذ تأسيسها على الملك إلى الآداب السلطانية التي تضبط لها مسار الدين في علاقته بالسلطة وعلاقته بالمجتمع .
فالديني لا يتدخل في السياسي إلا برعاية وإذن وتقنين السياسي لعملية المشاركة .
لأن من طبيعة الملك التفرد بكل شيء وعلى وجه أخص في كل ما يتعلق بمسائل الدين كما في وصايا “أدرشير” التي أسست معنى حراسة الدين والوصاية عليه والتنبه لتركه دون حياطة.
فالدولة السلطانية استطاعت وضع الحدود الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، واستطاعت كذلك أن تقدم نفسها حارسة للدين، ونقلت عن “أنوشروان” تلك المقولة الشهيرة الملك والدين توأمان، والدين أس الملك .. وكان يهدف إلى أن يعلّم الحكام أن يكونوا أولى بالدين من العباد والنساك والمتبتلين، وعليهم ألا يعترفوا لهم بأنهم أغبر أو أحدب على الدين منهم
فالمقصود من حراسة الدين حتى لا يتحول الدين إلى أداة سياسية توازي قوة الدولة السلطانية، وهو ما كان يخشاه ابن المقفع الذي أعاد هيكلة النظام العباسي في بدايات الدولة العباسية وقام بدور بارز في :
أ ـ في وضع الاختصاصات تحت رعاية سياسية تامة آلت إلى تبعية مصالح الآخرة لضبطها وفق مصالح الدنيا.
ب ـ نقل من الآداب السلطانية أداوت التحكم والسيطرة التي تضمن حراسة الدين ، وتضمن تأميم الفقه ومؤسسات الفقهاء بيد الدولة .
جـ حصر الاجتهاد وتعدد الفتوى، وفرض المذهب الواحد، وتحييد الشورى، ومحاصرة أداوت الاحتساب والقضاء، وتضييق حالات عصيان الحاكم .
وقد أشار علي أومليل في كتابه السلطة الثقافية والسلطة السياسية إلى جهود ابن المقفع في إخضاع الديني للسياسي، لتأسيس علاقة تبعية، تضمن حضور الدين في السياسة بالقدر الذي لا يؤثر على الجهاز السياسي أو التفرد بالحكم والسلطة
ونتيجة لذلك “فإن نصوص الآداب في موضوع علاقة الدين بالدولة، وانطلاقاً من التصور الساساني كما عبر عنها عهد أردشير ، وبلورتها أعمال ابن المقفع ، ونصوص العهود المنحولة، وسر الأسرار اليونانية، لا تذهب بعيداً في تعبيرها عن المماثلة بين الإله والملك، إنها ترسم ملمحاً آخر لنظرية الحق الإلهي للملوك لا يطابق تماماً الصيغة الكنسية المباشرة في دولة العصور الوسطى المسيحية، ولكنها ترسم تجربة أخرى في تاريخ العلاقة بين الدين والدولة وهي ترسيخ السلطة الملكية المطلقة، وجعل التقوى الدينية إحدى دعائمها ومرتكزاتها “
الاستبداد والسلطة الفردية المطلقة لأجل الأمن مقابل الفوضى
وهذه الفكرة التي تروج في كل أدبيات الفكر الاستبدادي القديم والحديث، فكرة ثابتة مستقرة ترى في الرعية مصدر الخطر والتهديد، وترى السلطة لا تقوم إلا على القهر والتسلط حفظاً للأمن من شرور الرعية على السلطة وشروهم على أنفسهم …
نصوص الأدب السلطاني لا تكتفي فقط بترسيخ أن السلطان ظل الله في أرضه، ، بل أكثر من ذلك “تم ترسيخ فكرة أن السلطة لا تقوم إلا على القهر، انطلاقاً من أن التساهل مع الرعية والعامة، علامة مؤذنة بخراب العمران .
وهذه الفكرة تتنافى تماماً مع المنظور الإسلامي للكون وللحياة البشرية التي تتأسس على التكريم الإلهي للبشر، والتكريم يتنافى مع التفرد بالسلطة والقهر.
وهذا المنظور الإسلامي لمفهوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم يقوم على توجيه الطاقات البشرية لإقامة القسط في مقابل تحمل طبيعة السلطة وخشونتها التي لا بد منها .
بينما يؤول المنظور الأول وهو مفهوم الدولة البوليسية التي تقايض المحكومين بالأمن مقابل صونهم من الفوضى، إلى التخلق والتطبع بسلوك الخوف، خوفاً من كل ما يثير غضب السلطة، وأهم ما يثير غضب السلطة وجود قوة تنافس قوة السلطة، لأن السلطة هي القوة الحسية والمادية لطبيعة كل مستبد وسلطة مستبدة، وعليه فلا يمكن أن تتخلق قوة في المجتمع لأنها مصدر تهديد أمني، والعقد بين المحكومين في ظل حكومة مستبدة البقاء في مجتمع مقطع الأوصال، وهدم روابطه الاجتماعية وحرمانه من التجمع أو الاجتماع بقصد التحزب أو قيام مجتمع مدني.
خاص بموقع “المقال”
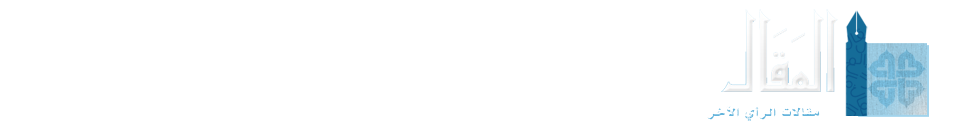











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك