
جدلية الديني والسياسي
 21 يناير, 2014
21 يناير, 2014  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
جدلية الديني والسياسي ليست وليدة دولة حديثة ديمقراطية أو نظام عالمي ، فقد عرض لها الباحثون منذ إشكالية محنة القرآن قبل أكثر من عشرة قرون.
وفي هذا المقال سوف أعرض بعض تفاصيل الجدلية، لأنتقل في مقال آخر لقراءة الجدلية من وجه آخر.
ابتدأت محنة خلق القرآن منذ العام 218هــ على يد على يد المأمون ( ت218هـ) ثم المعتصم (ت 227هـ ) ثم الواثق ( ت 232هـ).
لم تكن مجرد حادثة عابرة ، بل كانت مفصلاً تاريخياً في تراث المسلمين تصلح مجالاً لدراسة التداخل في العلاقة بين السياسي والديني ، وهو ما سيكون الحديث عنه بالتفصيل في نهاية المقال.
فلأكثر من عقدين عاش المسلمون فترة عصيبة من حياتهم، سجن فيها رموز الفقه والسنة ، وقتل فيها أحمد بن نصر الخزاعي، وفصل فيها رأسه عن جسمه، وعلق جسده على جذوع النخل، ومات فيها نُعيم بن حماد مسجوناً، وابتلي فيها علماء كبار كيحيى بن معين فأجاب إلى القول بخلق القرآن، ورُمي فيها علي بن المديني ثمانية أشهر في غرفة مظلمة، وحُقق فيها مع أبي مسهر الدمشقي، وأمرَ المأمونُ بإرساله إلى سجنِ بغداد حتى الموت، وامتُحن فيها أحمد بن حنبل ( 164 ـ 241هـ ) فضرب على ظهره بالسياط وسُجن مدة تزيد عن السنة ، وحُمل مقيداً من بغداد مع محمد بن نوح ( ت 218هـ) ليحقق معه أمام المأموم ، فتوفي المأمون وهم في الطريق إليه، ثم توفي محمد بن نوح.
كانت محنة قاسية، قام فيها قاضي قضاة المعتصم : أحمد بن أبي دؤاد بالتحقيق والمناظرة والحكم على من خالف عقيدة السلطة في زمن المعتصم والواثق.
عشرات المحدثين والفقهاء والقضاء تعرضوا للابتلاء في مسألة علمية لم ترَ السلطة أن أحداً كان بإمكانه أن يخالف رأيها دون أن يُهدد بالسجن والقتل والمنع من التدريس والعزل من الوظيفة ، وهو أمر غريب جداً أن تمارس السلطة السياسية دوراً علمياً تشرف عليه بنفسها.
لم ينج من امتحان السلطة العباسية محدث أو فقيه أو قاض له شأن ، ولم تتوقف إلا بمجيئ المتوكل الذي أوقف المحنة لكنه لم يتوقف عن التحقيق والاستدعاء والتضييق، فقد أمُر أحمد بن حنبل بالكف عن التحديث ولزوم بيته وترك صلاة الجمعة والجماعة، وتم استدعاؤه للمعسكر والتحقيق معه بسبب وشاية تتهمه بمؤامرة ضد الدولة.
ولم يثبت في الاستجواب والعرض على التحقيق سوى عدد قليل منهم : أحمد بن حنبل ، وأحمد بن نصر ونعيم بن حماد ( ت 228هــ ) ، والبويطي الذي توفي السجن ( ت232هــ).
حاول البعض أن يجيب في المحنة بالتورية والكناية، فيحلف في الظاهر أن القرآن مخلوق ويقصد اصبعه الذي يشير به ، وحاول البعض أن يستظرف أمام الواثق فيقول له : من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن ؟ على اعتبار أن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت. وعلق بعضهم بعد خروجه من الامتحان فقال : دخلنا وكفرنا ثم خرجنا ! وجماعة أخرى عند المأمون كانوا يقولون ما فيه أي القرآن من الجمال والبقر والحمير فهو مخلوق ، وما عدا ذلك فليس بمخلوق ، وإن كان الخليفة يراه مخلوقاً فكله مخلوق.
أحدثت تلك الفتنة فرقة بين الذين تعرضوا للبلاء ، فقد شق على الإمام أحمد إجابة يحيى بن معين، وأبي نصر التمار، وأبي خيثمة للقول بخلق القرآن والسقوط في الامتحان، فقطع صحبته بيحيى، ولم يرد عليه السلام ، ومنع من الكتابة عن أبي نصر التمار العابد ، الذي سمع الحديث من مالك والحمادين وخلق كثير ، ولما مات لم يصل عليه
لم تقف تأثيرات المحنة عند التوترات التي حدثت بين بعض المحدثين، بل أسهمت في اهتزاز ثقة الجماهير في شيوخها فلم يكونوا في مستوى التوقعات أو التطلعات وهم يتراجعون بالعشرات ولا يثبت منهم إلا قلة قليلة.
وأثبت التعاطي مع المحنة أن التسلط السياسي بكل أبعاده يعيد ترتيب الخارطة العلمية والفكرية داخل المجتمع، فلم تعد لعلي ابن المديني ذات المكانة العلمية التي كانت له قبل المحنة، فقد امتحن، وسجن ، وأجاب في الامتحان، فرفض أبو زرعة وإبراهيم الحربي نقل الحديث عنه ، رغم صدارته العلمية بين المحدثين
كان من نتاج المحنة على الحياة في الأوضاع العلمية والوظيفية: عزل كل من خالف توجه الدولة في معارضة القول بخلق القرآن، ومنعه من التحديث، وإبعاده عن الفتيا، وطرح الثقة بشهادته وعدم قبولها، بل نفي التوحيد عمن يقول بأن القرآن ليس بمخلوق!
وبادئ ذي بدء نتساءل عن دور المعتزلة في المحنة ، وموقعهم فيها .
حاولت بعض الدراسات أن تلغي دور المعتزلة كالدراسة التي قدمها د. فهمي جدعان في أشهر كتبه وهو كتاب “المحنة” والتي تعد أهم الدراسات التحليلية للمحنة .
توصل جدعان إلى براءة المعتزلة من محنة خلق القرآن ودلل على ما توصل إليه وفقاً للآتي:
ـ أن مسألة خلق القرآن كانت قبل خلافة المأمون بزمن طويل.
ـ أن نظرية المعتزلة في الإمامة تناهض خلافة بني العباس، فنظرية المعتزلة في الإمامة تقوم على التعاقد والاختيار، فهم مجمعون على أن الإمام لا يكون إماماً إلا بإجماع الأمة واختيارهم. ونظرية بني العباس تقوم على الوراثة .
وقد ناظر بعض صوفية المعتزلة المأمون بشأن سلطته التي لم تكن بإجماع الأمة وإنما أتت إليه بالوراثة، فأقره المأمون على رأيه، إلا أن المأمون تذرع بالفتنة ..
فهم في نظر بني العباس معارضون للسلطة الوراثية .
ـ أن عقيدة المعتزلة تقوم على العدل التي تنسب الأفعال للعباد ، وعقيدة بني العباس تقوم على الجبر التي تنفي اختيار العبد لفعله، وقد أشار جدعان إلى خطبة المنصور التي قال فيها: ” إنما أنا سلطان الله في أرضه أسوسكم بأمره ونهيه …” وقد أوردها كشاهد على جبرية بني العباس في مقابل قدرية المعتزلة ، كما نقل نصاً عن المأمون وقوله : ” إن الإرجاء دين الملوك ” ، ليؤكد للقارئ البون الشاسع بين بني العباس والمعتزلة.
كما دعم موقفه الرافض لتصنيف المعتزلة في رجال بني العباس أو تصنيف بعض بني العباس في المعتزلة باستعراضه لنظرية المعتزلة في الإمامة التي تُجمع بأن الإمامة :
عقد واختيار لا تجوز بالغلبة والقهر كما في نص عمرو بن عبيد : ” الإمامة اختيار من الأمة في سائر الأعصار “.
وترفض تخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يد السلطة ونقله من يد الأمة ليد السلطان.
وفي المقابل فإن أصحاب الحديث كانوا أقرب في نظرية الإمامة لبني العباس من المعتزلة، فلا يمانعون من حصول الحكم بالغلبة، ولا يرون بأساً من الصلاة خلف كل بر وفاجر ، ولا يرى بعضهم جواز الخروج على الحاكم الجائر بالسيف .
وإذا كان المعتزلة يوافقون الخوارج في جواز الخروج على الحاكم الجائر بالسيف ، فأصحاب الحديث يوافقون الخوارج المجمعون على جواز التغلب.
وإضافة إلى ما سبق فإن المأمون لم يكن معتزلياً ولم يكن شيعياً ، ولم يكن فيلسوفاً ولا فقيهاً، وإنما كان يرى نفسه فوق المذاهب والتيارات ، وكان يقول عن نفسه “معاوية بعمرِه، وعبدالملك بحجاجه وأنا بنفسي”، فلم يكن يرى لأحد عليه سلطة ، وقد نصحه وزيره يحيى بن أكثم بأن يدع الناس يختلفون دون أن ينحاز لطرف منهم ..
ـ أن المعتزلة ليسوا تياراً واحداً فهم فئات وتيارات مختلفة:
فمنهم التيار “التقوي” الاحتجاجي المناهض لفجور السلطة وجورها. ويرون جواز الخروج بالسيف تطبيقاً لأصل الأمر بالمعروف والنهي علن المنكر لخلع الحاكم الجائر بالقوة، ويرون عدم جواز الصلاة خلف الفاجر والجائر، وكان منهم جعفر بن حرب من صوفية المعتزلة وكان يتجنب الصلاة خلف الإمام، وهم امتداد لواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقد كانوا التيار الأقوى والأكثر داخل صفوف المعتزلة .
ومنهم تيار “الواقعية السياسية” أو “التيار العملي” ويأتي على رأس التيار أبو هذيل العلاف ( 135هـ ـــ 235هـ ) أكبر شيوخ الاعتزال في زمنه، وقد أعُجب به المأمون حتى أصبح أستاذاً له، ولم يتجاوز دوره الدور الكلامي الجدلي، وكان يمثل نمطاً دنيوياً تحكمه نزعة جدلية “صورية” جافة تتعامل مع السياسي وفقاً لمعايير نفعية خالصة، وكان بشر بن المعتمر المعتزلي الزاهد يصفه فيقول ” … وكان بالنفاق أشد إعجاباً منه بالإخلاص، ولباطل مقبول أحب إليه من حق مدفوع ” وأما النظام ( 231ه ـ) الذي افتقر وباع قميصه ليقتات، حتى أكل الطين من شدة جوعه كما يروي الجاحظ، فلم يكن له أثر يكشف عن أي دور سياسي لصالح السلطان أو لغير صالحه.
وتيار آخر لا يرى وجوب عقد الإمامة ، فالإمامة العامة كالصلاة ، تنتهي بانتهاء الإمام من الفرض، وكذلك الإمامة العامة تنتهي بانتهاء الحاجة للإمام، فإذا احتاج المسلمون لقطع يد السارق أنابوا عنهم رجلاً صالحاً يقيم الحدود ، فإذا انتهى مما وكل به انتهت إمامته ! ولأن الإمامة ذريعة لفساد أحكام الدين بتسلط الحكام ، فلا تستقر الأحكام الشرعية لكثرة إفساد الحكام ، ووجوب تغيير المنكر .
ـ أن المعتزلة لم يكونوا وحدهم جلساء الخليفة ، بل كان مجلس الخليفة مكتظاً بغيرهم من الفقهاء والمحدثين، ولم تكن الحظوة خالصة لهم كما تحاول بعض المصادر الحنبلية إظهار تأثيرهم على الخليفة واستئثارهم بكل شيء.
وإضافة لما سبق فإن دور المعتزلة مع السلطة لم يتجاوز مناظرة الفرق المخالفة للإسلام التي كانت تعقد في مجالس الخليفة ، فكانوا يناظرون السمنية والمثنوية والدهرية والزنادقة وغيرهم من الفرق المخالفة.
ـ أن أحمد بن أبي دؤاد لم يكن كما تصوره المصادر الحنبلية مستغلاً لمنصبه في الدولة لنشر اعتزاله، فلم يكن معتزلياً متكلماً بالمعنى الدقيق ، وإنما كان يقوم بوظيفة رسمية في الامتحان الذي أوكل إليه من قبل المعتصم والواثق، ولم يمتحن الناس لقوة انتمائه للاعتزال، بل بسبب مركزيته في السلطة العباسية ، والمهمة التي أوكلت إليه كانت تتطلب سؤال المخالفين في العقيدة والمخالفين للدين ، فمنصب القاضي الأول أو قاضي القضاة يتعين عليه أن يناظر ويسأل ويحقق ويستجوب كل من خالف في الملة ! وهو ما كان يفعله ابن أبي دؤاد كما زعم المؤلف !! ولم ينقل عنه قول في الكلام أو مؤلف في الاعتزال وقد قال فيه الإمام أحمد : “ليس بشيء ” وهو لا يعدو أن يكون ناقلاً ومقلداً لبرغوث وغيره من المعتزلة ، ولم يشهد أحد من القدماء أن ابن أبي دؤاد هو من أشرع باب الفتنة وابتدأ الامتحان، بل كانت له محاولات لتخفيف المحنة وانتزاع إجابة صورية من ابن حنبل وكرهه لمقتل الخزاعي . ولا اعتبار لزهو الجاحظ بدور ابن أبي دؤاد ، فهو زهو الجاهل لا يليق إلا بخفة الجاحظ وظرفه، والجاحظ من عوام المعتزلة لا يوثق بقوله ولا يصح الرهان عليه ، وغاية ما كان يرمي إليه مناكفة المخالفين.
ـ أن المنزلة الحقيقية عند المأمون لم تكن للمعتزلة ، بل كانت لوزيره الأول وقاضي قضاته وهو يحي بن أكثم الصيفي ، وهو محسوب على التيار السني ، ومن كان من المعتزلة قريباً من المأمون كثمامة بن أشرس النميري لم يكن له من المنزلة كالتي كانت ليحيى بن أكثم.
ـ أن مسألة خلق القرآن مسألة متصلة بالتجهم وليس بالاعتزال ، وأشهر من قال بها ونشرها بشر المريسي، وبشر من رؤوس الجهمية، وملحد في أسماء الله كما يصفه الدارمي، وابن تيمية يذكر بأن الذين ناظروا أحمد كانوا من الجهمية وليسوا من القدرية فلم يكن النزاع في مسائل القدر.
وبهذه المرافعة الصاخبة التي برأ فيها فهمي جدعان المعتزلة من دورهم في المحنة مهد لرؤيته للمحنة من زاوية البعد السياسي مستشهداً على رؤيته بعدة شواهد منها :
ـ أن المأمون قبل أن يبدأ الامتحان استعد لغزو الروم ، وفي قلب المعركة من طرسوس يبتدئ معركة خلق القرآن، فما الدافع الذي يجبره على افتعال معركة في الداخل ومعركة في الخارج في آن واحد ؟
ـ كما أن المعركة التي ابتدأها المأمون مع الروم توقفت منذ 25 سنة ، وهي بلا شك ستشكل له رصيداً سياسياً وشعبياً أمام الرأي العام وهو يجاهد في سبيل الله ، والخطوات التي سيقوم بها بعد ذلك لن تثير الشك في مصداقيته كحاكم يحفظ بيضة المسلمين ويتولى حراسة الدين.
ـ أن من تعرضوا للامتحان أصحاب سوابق شاركوا في مواجهات ثورية ، والامتحان لم يكن إلا انتقاماً لسوابقهم الثورية ضد الدولة. فأبو مسهر الدمشقي ، وإبراهيم بن المهدي ، وأحمد بن نصر الخزاعي كانت لهم سوابق في المعارضة المسلحة ضد الدولة، وقد آن أوان الثأر منهم.
ـ أن اكثر الذين تعرضوا للامتحان كانوا أمويين الهوى ، ومنهم من شارك في المعارضة الأموية ضد السلطة العباسية ، فالمحدث الفقيه أبو مسهر شارك مع السفياني في ثورته ضد العباسيين بدمشق، عام 195هـ والتي أقام فيها السفياني ولاية أموية بعد أن طرد الحاكم العباسي، وقد ذكّر المأمون أبا مسهر الدمشقي بعمله مع السفياني أثناء امتحانه. وكان الإمام أحمد يدافع عن معاوية ويثني عليه ، وينهى عن الكلام فيه، في ظل سلطة عباسية كانت تقف موقفاً عدائياً ضد الأموية، حتى كاد المأمون أن يأمر بشتم معاوية على المنابر لولا نصيحة وزيره بأن يكف عن ذلك . ويزيد بن هارون كان ممن خرج على المنصور مع المعتزلة مطر بن الوراق سنة 145هـ .
وخلاصة ما سبق أن المأمون أراد بالامتحان رأب الصدع الداخلي في الدولة إذ تبين له أن الطاعة ليست خالصة له، فأراد أن يثبتها بالامتحان .
بعد تلك الشواهد والأدلة خلص إلى أهم درس في المحنة التي تعرض لها أصحاب الحديث خاصة، وهي جدلية الديني والسياسي .
الديني له غايات تختلف عن غايات السياسي.
والسلطة التي تحقق غايات الديني لا يمكن أن تلتقي مع السلطة التي تحقق غايات السياسي إلا بخضوع الديني للسياسي أو العكس .
والنتيجة التي توصل لها بعد قراءة المحنة بأبعادها السياسية : أن الديني استطاع أن يبني سلطة توازي سلطة الدولة ، وهو الأمر الذي أفزع المأمون لتبديد القوة التي تنافس كيان الملك السياسي .
توصل المؤلف للنتيجة السابقة بعد أن أطال الشرح والتفصيل والتعمق في جذور العلاقة بين الديني والسياسي منذ لحظة الخلافة وحتى تحولها إلى ملك عضوض .
فجوهر الجدلية يقوم على الصراع بين الديني والدنياوي ، بين الخلافة والملك ، بين الأساس الذي تعود إليه الخلافة والأساس الذي يقوم عليه الملك .
وأثبت أن ابن خلدون كان بارعاً في تحديد مراحل الانقلاب التي حدثت بفعل الصيرورة التاريخية ، من النبوة إلى الخلافة ثم إلى خلافة ملتبسة بالملك، ثم إلى الملك الخالص .
وقارن بين براعة ابن خلدون وفذاذته في قراءة التحولات التاريخية وتجريد القول في مسألة انقلاب الخلافة إلى ملك ، وبين محاولات الماوردي التي آلت إلى إلباس الملك الدنياوي لبوس الخلافة، فلا يبدو الفرق جلياً بينهما، فالملك هو الخلافة والخلافة هي الملك ، فالخلافة بمعناها الراشدي قد انتهت في وقته، ولم يعد سوى الملك الدنيوي السياسي الذي يروم الغايات الدنيوية ، فأصبح من الضروري تشريع الملك بواجهة شرعية.
كان الماوردي يعلم أن وظيفة الدين في الملك الدنيوي القيام بدور روحي أخلاقي تلطيفي حراسي على الملك نفسه وبتعبير جدعان كان الفكر السياسي عند الماوردي يقوم على إمامة الملك وهي إمامة مستندة إلى الغلبة والقهر.
فكل كلام الماوردي عن الخلافة لا معنى له ، فقد انقلبت الخلافة لملك ، ولم يشأ أن يعترف بما آلت إليه الخلافة .والملك كما في تعريف ابن خلدون مفارق لمعنى الخلافة والإمامة فحقيقته ومقتضاه وماهيته : القهر والتغلب فهو متولد عن القوة الغضبية والحيوانية ، وأحكامه في الغالب جائرة عن الحق ، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم ، لحملهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته.
هذه العودة إلى الجذور تشكل الناظم الحقيقي لما جرى في عهد المأمون والمعتصم والواثق.
وتبين أن جدلية الديني والسياسي لا تتوقف عند زمن المحنة، بل الجدلية تعد الحاكمة لعلاقة السياسي بالديني في كل المراحل السابقة واللاحقة للمحنة.
فالخلافة ليست ملكاً ، فهي وظيفة لإصلاح الدنيا بالدين أو لسياسة الدنيا بالدين ، وهذه الوظيفة لا تتطلب التأسيس على القهر والغلبة، فمبنى سلطة الخلافة على الرحمة كما جاء في النص النبوي: ” ستكون نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة… ، فلا تتطلب سوى القيم السياسية التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالشورى ومشاركة الأمة في انتخاب الحاكم.
بخلاف الملك الطبيعي والسياسات المدنية التي لا تهدف إلا إلى سياسة الدين بالدنيا أو سياسات لمصالح الدنيا فقط، فهي قد لا تقوم إلا على القهر والغلبة والتدخل إذا كانت ملكاً طبيعياً ، وإذا لم تكن كذلك فهي تسير على غير نور الله إذ الغاية من الملك الدنيوي والسلطة المدنية حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي لمصالح الدنيا
وقد أفاض ابن خلدون في بيان الفروق بين الخلافة والملك، ونقلها جدعان بطولها في كتابه لأهميتها في إثبات الجدلية.
لقد أتت الخلافة كتعبير عن علاقة الدين بالشأن الاجتماعي، فأحد الوجوه الرئيسة في وجوب الإمامة ونصب الإمام للتعبير عن الكيان الاجتماعي السياسي للإسلام.
فكل ما هو فردي إذا تحول إلى اجتماعي يصبح سياسياً، وإذا أصبح الدين شأناً للجماعة تطلب ذلك البحث عن سلطة ، وتطلب التنازع على السيادة ، لحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي لمصالح الدين والدنيا.
فاشتمال الدين على أحكام تتعلق بالجماعة ووجوده في هيئة اجتماعية بأي صورة من الصور يُدخل الدين في السياسة، ويدخله في البحث عن سيادة تقوم على شؤونه وتحقق مصالحه ، تماماً كما يبحث الدنيويون عن السيادة والسلطة والملك لإقامة مصالح الدنيا فقط . فالخلافة ذات حدين، والملك ذو حد واحد .
وإذا دخل الدين في المجال السياسي فهو يبحث عن سيادة وسلطة ودولة ، ولكن السلطة والدولة والسيادة التي يقصدها الديني أساسها الرحمة، فلا تقوم الخلافة بالقهر والغلبة، ولا تسمى خلافة مالم يكن أساسها الرحمة كما في النص.
فشرط الخلافة شرطان : أن تكون وظيفتها الأساسية مصالح الدين والدنيا وسياسة الدنيا بالدين. وأن يكون قيامها بالرحمة لا بالغلبة والقهر .
فإذا تحقق الشرطان فهي خلافة .فالشرط الأول شرط موضوعي يتعلق بوظيفة الحكم، والشرط الثاني شرط إجرائي يتعلق بالنظام .
وإذا نقص شرط من شروطها فإما أن تكون خلافة ملتبسة بملك ، وإما أن تكون ملكاً خالصاً، وإما أن تكون سياسات مدنية لا تقوم على الغلبة والقهر ولكن لأنها لمصالح الدنيا فقط فهي على غير نور الله وهداه وتصبح عبثاً لا رحمة، إذ لا شأن لها بالمصالح الأخروية، فتنتفي منها الرحمة بالمعنى الذي في الخلافة.
وسميت خلافة لأن الحاكم يسوس الدنيا بأحكام الله وبشرعه وبهداه ورحمته وعلى نور منه ، ولذلك جاءت التعابير التي تفيد معنى الخلافة بالنيابة عن الله في أرضه ، ولو كان الحاكم لا يسوس الناس إلا بشريعة الأرض فهو خليفة لإله الأرض، ونائب عن مشرع بشري ، ولكن لم يصطلح على تسميته بخليفة المشرع الأرضي ، وإلا فهو في الحقيقة ينوب عن المشرع في الأرض في تنفيذ قوانينه .
وعليه :
أولاً: أن كل حكم تأسس على الطغيان والجبر والغلبة وجعل من وظائفه الجمع بين مصالح الدين والدنيا فهز ملك.
وقد يُغلّب الحاكم مصالح الدين على الدنيا فيسوس الدنيا بالدين، وهو مالم يتم إلا في مرحلة تاريخية محدودة فهو ملك ملتبس بالخلافة، وقد يسوس الدين بالدنيا لطبيعة الحكم القائم على الغلبة والقهر وهو الأغلب، وهو الذي تجسد في الملك العضوض والجبري.
وبذلك يظهر معنى أن الخلافة رحمة، لأنها لا تقوم على طقوس الملك وطبيعته الشرسه والخشنة في الجبروت والقوة والإكراه والإلزام .
فالأحكام الشرعية تتأثر بنوع الحكم القائم، فإن كان الحكم خلافة ، فالخلافة رحمة، ولازم الرحمة أن تكون أحكام الشريعة رحمة بالناس.
وإن كان الحكم قهرياً ، فأحكام الشريعة تتبع سياسة الحكم وتدور على نوع الحكم ولو كان الحاكم عادلاً صالحاً في نفسه.
فطبيعة التفرد ملازمة للإكراه والإجبار والإلزام، فهي سلطة إكراهية لا تقوم على الرضا والقناعة بالحاكم، بل على كرهه وكره أحكامه، وكره طاعته والاستجابة له ، سلطة تشكلها الخوف والرهبة، وتتلون الطاعة فيها بالنفاق، وتؤثر على علاقة الناس بالحكم الشرعي لتتحول إلى علاقة التزام وظيفي بالأحكام الشرعية وليست على القناعة والرضى . ولذلك كثر التوجيه القرآني للنبي الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم : ( وما أنت عليهم بجبار ) ، قال ابن عباس : وما أنت عليهم بملك ، فطبيعة الملك ملازمة للقهر. ( لست عليهم بمسيطر) ، ( وما أرسلناك إلا رحمة ) ( إن أنت إلا نذير ) ( لا إكراه في الدين ) …
ثانياً: إذا تأسس الحكم على الطغيان والجبر والغلبة وقدمت فيه مصالح الدنيا فقط، وقام بوظيفة شكلانية تجاه الدين، كما حصل في القرون التي تلت عهد الدولة الأموية وأوائل العهد العباسي، فهو ملك عضوض وملك جبري كما نبهت لذلك السنة النبوية.
ثالثاً: إذا لم يتأسس الحكم على الغلبة والقهر ، بل على التشاور والانتخاب ، ولكنه حكم لأجل بناء الدنيا فقط . فقد شرطاً من شروط معنى النيابة عن الله في أحكامه وتشريعاته، وصار حكماً للنيابة وخلافة التشريعات والقوانين الأرضية وتطبيقها والحكم بها، لإقامة المصالح الدنيوية وإهمال المصالح الأخروية، فهو حكم يسير على غير نور من الله .كما هي النظرية الخلدونية.
فحقيقة الصراع الذي تفجر في عهد المأمون والمعتصم والواثق كان صراعاً بين الغايات وعلى السلطة والسيادة .
وما حدث في محنة خلق القرآن كان يسير في منحى جدلية الديني والسياسي ، وصراع الغايات المتباينة. بين سلطة عباسية قامت على الملك الدنياوي، وعلى القهر والغلبة ، وعلى قصد استمرار السلطة في يد العباسيين بأي ثمن ولو على حساب مصالح الدين، وهو قصد يكفي لجعل مصالح الآخرة عملاً شكلانياً ، فكل مصلحة للآخرة تعارض بقاء الملك في يد الوراثيين فيجب أن تبرر .
ومن هنا فقد تعمقت إشكاليات الملك العضوض في العصر العباسي بعد أن أصبح غاية لذاته لتحقيق شهوة التسلط وشهود السيادة .
لقد اتسعت فجوة الغايات بين ملك بني العباس وبين القوى الدينية التي أدركت قبل ابن خلدون أن مصالح الآخرة لم تعد أساساً في سلطة الدولة ، وأن الصيرورة التاريخية بدأت تتعزز بصيرورة أخرى وهي فساد الزمان ، وكثرة الفتن ، وانكفاء الخير.
وكتاب الفتن لنعيم بن حماد يأتي في سياق غلبة الشر والفتن ، وغلبة مصالح الدنيا على مصالح الآخرة.
فالناس في عهد المأمون أصبحوا تحت سلطة دنياوية، قائمة على القهر، ولا تقوم بوظيفتها تجاه الدين، فهم بين نارين: نار القهر ، وضياع مصالح الآخرة .
أدركت القوى السنية كما يشير فهمي جدعان إلى أن ملك بني العباس لم يعد صالحاً لتحقيق مصالح الآخرة، وتطبيق أحكام الله.
وأدرك المأمون بحسه الثاقب وقوة تدبيره السياسي أن في دولته قوة توازي سلطان دولته وتتحدى على نحو متزايد سلطان المأمون على رعيته، وقد تمثلت تلك القوة في أصحاب الحديث خاصة وأهل الدين بعامة من المذاهب الأخرى.
وقد كشفت رسالة المأمون التي افتتح بها الامتحان مدى استشعاره لقوة الدولة الموازية القوة التي داخل الدولة .
ويشير التحليل النصي للرسالة بأن استهداف المأمون لرجال الحديث خاصة كان لشدة تأثيرهم ولقوتهم المتنامية للاستحواذ على إرادة العامة، ولم يكن المأمون يخشى من الحجم العددي لأصحاب الحديث بقدر خشيته أن تتحول سلطة هؤلأ الرؤساء على العامة ــ كما يقول ــ إلى قوة ضارية لدك مملكته.
وهناك عامل آخر يؤكد البعد السياسي ــ كما يرى مؤلف كتاب المحنة ــ وهو تواطؤ العامة مع الأمين في ثورته ضد المأمون، بما يؤكد خطر التفاف العامة لديه حول الشخوص الرمزية التي لا يُؤمن خطرها لأن تنقلب عليه في لحظات الفراغ السياسي في الدولة .
كما دلت وصية المأمون على مبلغ القلق الذي انتابه من المنافسين لسلطة الرعية قوله في وصيته : ” الرعية الرعية والعوام العوام فإن الملك بهم” .
كانت مناظر الجموع التي تحيط بالرموز ، والآلاف التي تجتمع عند يزيد بن هارون أو ابن حنبل تثير خوف المأمون، فإذا نظر إلى مجلس ابن هارون قال هذا الملك.
لقد أدرك بحدسه السياسي أن سلطانه على رعيته لم يكن برغبة حقيقية لدى العامة التي كانت تلتف حول الرموز الدينية ، وأدرك أن هذا الملك قد أصبح مُلكاً آخر في ملكه.
أما ردود فعل المأمون على أجوبة الممتحَنين فهي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن القصد الأساسي الذي لأجله قامت المحنة كان لإسقاط خصومه السياسيين دينياً وأخلاقياً واجتماعياً من أجل إضعاف ثقة الرأي العام بهم ، وتشتيت الجموع التي تجتمع حول تلك الرموز العلمية وتخيف سلطان الدولة على الرعية .
لم يكتفِ المأمون بمعرفة موقفه الممتحَنين في خلق القرآن بل كان يضيف بعض ما يعلمه عنهم من سقطات اجتماعية أو أخلاقية ، ممالا مدخل له في أصل المسألة .
إن الإطار الناظم للمحنة لم يكن لنشر الاعتزال ، أو للدفاع الحقيقي عن العقيدة ، أو التنبه لمصالح الآخرة.. فالمأمون وكما سبق لا يعنيه الاختلاف العلمي في مسألة علمية، مجالها المناظرات والمجالس والكتب ، ومسألة خلق القرآن لم تكن أخطر من غيرها وترك أصحابها بلا امتحان، إلا أن اختياره لها لعلاقتها بالقرآن مما يجعلها مسألة خطرة بالغة الحساسية.
والخلاصة أن الإطار الصحيح للمحنة يكمن في تفجر الصراع على السلطة لتحقيق الغايات التي تباينت مع مرور الزمن وبلغت ذروتها في عهد المأمون.
حاول جدعان استقراء مواقف أهل الدين تجاه الصراع الدائر بين الغايات إلى ثلاث فئات، فئة المتأولين من أهل الدين وهم عادة ذراع السلطة السياسية وجزء من ماهيتها ، وفريق آخر صنفه في المتاركين أو الساكتين ، وفريق ثالث وهم المعارضون.
ليس بالضرورة كما يرى المؤلف أن القوة الموازية كانت تتنظم في هياكل سرية منظمة للإطاحة بسلطة المأمون ولكن كان يكفي لتفجر الصراع وجود عناصر واعية ذات رصيد رمزي وعلمي في المجتمع تستطيع في لحظات معينة أن تقدم نفسها كبديل محتمل.
كان مما يخفف العبء على المأمون عدة أمور من أهمها:
الأول: أن خصوم المأمون لم يكن لهم مشروع سياسي يمكن أن يكون بديلاً عن سلطة العباسيين .
الثاني: أن المعارضة كانت منقسمة إلى فئة متصلبة تطمح للإنكار العلني المباشر والصدع بالحق تتذرع بحديث وكلمة حق عند سلطان جائر، وفئة تتذرع بالطاعة لولي الأمر كوسيلة معارضة سلمية ، ولم تكن منظمة في هياكل سرية أو تنظيمية .
الثالث: أن مطالبات المعارضة لم تكن مطالبات سياسية تعيد رسم السلطة على أسس الرحمة، وإنما اقتصرت على محاربة الفساد الأخلاقي والسلوكي والبدعي .
فالطموحات لم تتجاوز إعادة بعض مصالح الآخرة وضمها في الملك السياسي، ليصبح ملكاً ملتبساً بالخلافة.
الرابع: أن الدولة استطاعت تحييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسبه في يدها عبر جهازها الديني الرسمي الذي ينظّر للعامة إسلام السلطة ، فيشرع بقاء استمرار بقاء المستبد وفي ذات الوقت يلغي جميع الأدوات السياسية المتاحة للعموم والتي يمكن أن تستخدم ضده كأداة ناجعة لجبر السلطة الحاكمة على ما يخالف مصالحها من أحكام الشرع.
ضمنت السلطة الحاكمة تخصيص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأهم أداة سياسية يمكن أن تقع في يد المحتسبة وتثير العامة ضد الدولة.
وبذلك فقد تيار الاحتساب والمعارضة القدرة على إنكار مظالم السلطة السياسية ، كما سُمح له في ذات الوقت بالتسلط على من هم خارج السلطة في منكراتهم الأخلاقية والبدعية.
والمعنى التفسيري لتنظيم الاحتساب على ذلك النحو: اكتساب السياسي “الدنياوي” المزيد من الشرعية الدينية لسلطته وتعميقها بإظهار العناية بأهم شعائر الدين، وفي الوقت نفسه يظهر الديني وقد فقد القدرة على الموازنة ، ضعيفاً في الولاء لمبادئه ، متناقضاً ، لا يستحق ثقة الرأي العام وهو يواجه فساد الضعيف ولا يقوى على إنكار فساد الشريف.
إن تجريد الأمة أو تفريغها من القوة يؤدي لنتيجتين هامتين الأولى: تذرير الأمة أي هدم روابطها الاجتماعية والأهلية، والثانية : تسكين رهبة الحاكم من تزايد العدد السكاني الذي قد يشكل قوة توازي قوة الدولة في حال تبلورت القوة في مؤسسات مجتمع مدني ، فالملايين التي تقاد من طبقة أو عائلة أو أفراد معددوين تفقد القدرة على التأثير وهي مقطعة الأوصال مفككة الروابط لا يجمعها جامع ولا تلتف حول بؤرة مركزية، وهو يؤدي بالضرورة إلى تماسك السلطة الحاكمة، في مقابل الملايين المشتتة ، فالقوة الحقيقية ليست في كثرة العدد مع أهمية العدد، ولكن الأهمية بالدرجة الأولى للقوة المنظمة ولو كانت قليلة العدد .
ومؤسسة الحكم أكثر تنظيماً وتنسيقاً وأقدر على قيادة الجموع ولو كان الجموع بعشرات الملايين بشرط أن تكون جموعاً مفرقة ، فكما قيل فرق تسد.
وعليه فلا بد لأي أمة أو مجتمع يحاول أن ينهض في وجه مظالم السلطة الحاكمة المتسلطة أن يعيد ترتيب قواه الاجتماعية ، أو يصنع له قوة منظمة توازي قوة السلطة الحاكمة ، التي لا ترتدع عن جورها أو فسادها أو تسيدها المطلق إلا بتنظيم قوة الجموع العددية في تنظيمات وروابط أهلية واجتماعية ومؤسسات ناشطة في كل الميادين ولكن باتجاه منافسة قوة السلطة.
خاص بموقع “المقال”
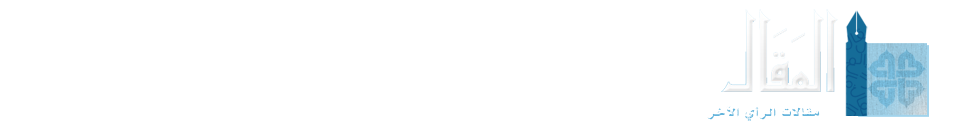











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك