
التحليل المكاني للربيع العربي – لماذا حصل هنا، لماذا لم يحصل هناك؟
 2 أكتوبر, 2012
2 أكتوبر, 2012  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
منذ أن اندلعت انتفاضة تونس والأسئلة تتوالى. لماذا حصل ما حصل؟ وكيف حصل؟ ولماذا الآن؟ أسئلة كثيرة تنتظر الباحثين كي يناقشوها لسنوات قادمة في محاولة تحليل هذا الزلزال الذي لم ينته بعد وفي محاولة توقع الأحداث القادمة والمسار الأفضل لها.
أحد هذه الأسئلة الملحة هو سؤال لماذا هنا؟ لماذا حصلت انتفاضات الربيع العربي في دول عربية معينة ولم تحصل في دول أخرى؟ سؤال طُرِح منذ بداية 2011 وهذه المقالة محاولة للإجابة عنه.
- · الدمقرطة:
دراسات “الدمقرطة” Democratization أو “علم الانتقال” Transtology هو فرع من العلوم السياسية يبحث عن كيفية حصول التغيير في النظم السياسية والانتقال من شكل حكم إلى آخر، غالبا من نوع ما من أنواع الديكتاتورية إلى نوع ما من أنواع الديموقراطية. وهو يبحث ذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة “الانتقال”، التي يحصل فيها الخروج من نظام سياسي إلى آخر، والمرحلة الثانية هي مرحلة “الترسيخ”، التي تترسخ فيها قيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة مما يضمن عدم العودة للديكتاتورية، وهي مرحلة مهمة كون العديد من الانتقالات قد تعرضت لانتكاسة أعادت الأوضاع للوراء.
وقد برز هذا مجال من العلوم السياسية إلى النور بعد ما عرف بـ”موجة الديموقراطية الثالثة”، التي اجتاحت أغلب مناطق العالم منذ السبعينيات، فصالت وجالت من أوروبا الجنوبية إلى أميركا اللاتينية، ومن أفريقيا وأوروبا الشرقية إلى أطراف آسيا، ولم تبق منطقة من مناطق العالم إلا قد دخلتها الدمقرطة بدرجة من الدرجات باستثناء الشرق الأوسط الذي صُنِّف في هذا الحقل من الدراسات بوصفه منقطة عصية على الانتقال الديموقراطي، فصارت الأدبيات تكتفي فقط بمحاولة تحليل أسباب ما سموه بـ”الاستثناء العربي”، تارة بربط الموضوع بالدين الإسلامي أو ثقافة شعوب المنطقة، وتارة بمحاولة تحليل سلوك الطغاة العرب وتكتيكاتهم في تجنب الانتقال الديموقراطي، وأخرى بتسليط الضوء على الدعم الأجنبي لهذه الأنظمة ودوره في بقائها. ورغم وجود شبه إجماع في هذه الدراسات على عدم وجود أي ديموقراطية عربية إلا أنها تحدثت عن وجود شكل مميز من أشكال الديكتاتورية في الدول العربية يعرف بـ”الديكتاتورية التعددية”، وهي أنظمة الحكم الديكتاتورية التي تسمح بهامش من الممارسات التعددية.
في 2011 تغير كل شيء. اجتاحت الاحتجاجات كل دولة عربية (باستثناء الصومال ربما). ولكن كل دولة تعرضت لدرجة مختلفة من الاحتجاج، بعضها تعرض لاحتجاجات كبيرة مثل تونس ومصر، وأخرى تعرضت لاحتجاجات بسيطة مثل لبنان, بعض الاحتجاجات غلبت عليها الدعوة لإسقاط النظام وأخرى غلب عليها الدعوة لإصلاحه، بعض الاحتجاجات كانت سلمية وبعضها كان مسلحًا مثل ليبيا. فما الذي جعل الربيع العربي يأخذ هذا المنحى ويختلف من دولة لأخرى؟
تقصى عالم السياسة جان تيوريل – في بحث أنهاه عام 2011 – حالات الانتقال للديموقراطية حول العالم من 1972 وحتى 2005 وتوصل إلى أن احتمالية الانتقال إلى الديموقراطية تزداد في ظل الأنظمة التي تصنف كديكتاتوريات تعددية على عكس الأنظمة الديكتاتورية الأحادية. ليس هذا فقط، إنما وجد أنه كلما زادت هيمنة الحزب الحاكم في الديكتاتوريات التعددية قلت فرص الانتقال الديموقراطي. وعلى ضوء هذه الدراسة الحديثة سأحاول تحليل التوزيع الجغرافي للربيع العربي.
- · ما الدول العربية التي شهدت انتفاضة في 2011؟
كي نحاول قياس الدول التي تعرضت للربيع العربي في 2011 سأضع 3 معايير أساسية:
أ) حصول مظاهرات شارك فيها الآلاف يغلب عليها الطابع السلمي.
ب) حصول تغييرات حكومية كبيرة بسبب الاحتجاجات السلمية.
ت) سقوط رأس النظام بسبب الاحتجاجات السلمية.
وقد كان الأدق أن نقيس المعيار الأول بالنسبة المئوية للمشاركين في الاحتجاجات مقارنة بتعداد السكان لكن ذلك متعذر بطبيعة الحال، لذلك لجأت للقياس بالآلاف وذلك لأنه في كل الدول العربية كان حشد الآلاف قبل 2011 مسألة صعبة وتحمل مخاطر أمنية جمة خصوصا إذا كانت تطالب بإسقاط النظام أو بإصلاحات عميقة أو إذا كانت تنتوي الاعتصام المفتوح في ميدان رئيس.
وقد اشترطت هنا أن يكون الحراك سلميا في غالبه لسبب بسيط، وهو أن الثورات المسلحة ليست ممثلة لأغلب الشعب بالضرورة ولا تعتمد على قوة الدعم الشعبي بقدر اعتمادها على المعايير العسكرية التقليدية، كحجم القوات وتوفر السلاح والذخيرة وخطوط الإمداد وقواعد التدريب… إلخ، لذلك نجد أن الثورة الليبية انتقلت من انتفاضة مسلحة محدودة إلى ثورة مسلحة منظمة حين حصلت على منطقة حظر الطيران، وفي سوريا يعد التفوق العسكري للنظام من أهم أسباب استمراره إلى الآن.
بالإضافة إلى ذلك فقد استثنيت الدول التالية من البحث: السودان، الصومال، فلسطين، والعراق. وذلك لأن هذه الدول عاشت العقود الماضية في حالات مستمرة من الحروب والحروب الأهلية والكوارث الإنسانية والتدخل الخارجي، أو ما سأطلق عليه اسم “الاستثناء الحربي” الذي يجعل من المتعذر تحليل وضعها بنفس الطريقة التي نحلل بها وضع باقي الدول. فبينما كانت الدول العربية تشهد ربيعها كانت السودان تنقسم لدولتين بعد حربين أهليتين تعدان من أطول الحروب الأهلية في التاريخ، ومعارك المستمرة بين النظام في الخرطوم ومعارضيه في كردفان والنيل الأزرق وغيرهما، بالإضافة إلى عمليات القصف الإسرائيلي والأميركي على السودان.
أما الصومال فقد عاش العقود الماضية كلها ضمن حروب أهلية متكررة ووقعت البلاد بين الحركات المسلحة والقراصنة والمجاعات والتدخل العسكري المستمر من عدة دول أفريقية ومن أميركا والإتحاد الأوروبي.
أما العراق فلم تتوقف فيها الحرب منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، التي ذهب ضحيتها مليون قتيل تقريباً، تلتها حرب الكويت ثم الحصار والقصف لمدة 12 عاما تقريبا انتهت بالغزو في 2003 ثم استعار الهجمات الإرهابية الغامضة والاقتتال الطائفي اللذان لم يتوقفا إلى تاريخ كتابة هذا المقال.
وحال فلسطين غني عن التعريف، الاحتلال وكافة مظاهره من استيطان وتهجير وقتل وأسر وتعذيب وتجسس وسرقة للمياه والموارد الطبيعية وتنفيذ عمليات الاغتيال وغير ذلك، كلها عوامل تجعل فلسطين دولة عربية لا يصح تحليل وضعها بمثل ما نحلل به وضع الدول الأخرى.
ولا يمكن هنا ضم سوريا لهذا الاستثناء رغم وجود الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي للجولان السوري منذ 1967 وذلك لأن الحالة العام في سوريا لم تكن أبدا حالة حرب منذ وقف إطلاق النار في 1973، على عكس حالة الحرب الواضحة في الحالات الأربع السابق ذكرها.
فإذا وضعنا هذه المعايير تحت الاختبار لباقي الدول العربية التي لا تخضع للاستثناء الحربي سنخرج بالجدول التالي:

من هذا الجدول يتبين لنا أنه – وعلى العكس من التصور السائد إعلاميا– فقد شهدت عديد من الدول العربية كالكويت وجيبوتي والمغرب “ربيعها” الخاص بها في 2011، وليس فقط دول الثورات. وأيضا يتبين لنا أن الحالة الليبية لا تنطبق عليها معاييرنا للانتفاضات العربية وذلك لأنها نحت مسار الثورة المسلحة في أول أيامها، وهو ما سنتطرق له لاحقا.
وقد حصلت جيبوتي على نصف درجة في معيار سقوط رأس الحكم وذلك لأن الاحتجاجات أجبرت الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية ولكنه ربحها وسط إدعاءات من معارضيه بأن الانتخابات كانت مزورة.
- ما الدول العربية التي شهدت ممارسات ديكتاتورية تعددية؟
كي نحاول قياس وجود أو غياب هذا النوع من الديكتاتورية من بين الديكتاتوريات العربية سأستعمل 3 معايير أساسية:
أ) وجود انتخابات برلمانية.
ب) وجود انتخابات الرئاسية.
ت) وجود الأحزاب.
والمقصود بوجود الأحزاب أي وجودها بشكل قانوني أو وجودها بشكل فعلي حتى وإن كان غير مسموح به قانونيا، ولكن مع التفريق بينهم في التصنيف بنصف درجة.
ولم تُحسَب الإمارات كدولة برلمانية وذلك لأن الانتخابات في الإمارات لا يمكن عدها ممثلة للشعب حيث يسمح لبعض المواطنين فقط بانتخاب النصف غير المؤثر من المجلس، والدولة هي التي تختار من يمكنه الإدلاء بصوته (!).

وفي هذا الجدول يتبين لنا أن عديدا من الدول العربية عاشت شكلاً من أشكال التعددية الديكتاتورية التي تحدثنا عنها. والآن إذا قارنا نتائج الجدولين في جدول ثالث منفصل سنجد النتائج التالية:
وعددت أن العلاقة دقيقة إذا كان الفرق بين النتيجتين يقع بين صفر ونصف درجة، ودقيقة جزئيا لو تراوح الفرق بين درجة إلى درجتين، وغير دقيقة لو كان 2.5 فما فوق.

- · قراءة النتائج:
النتائج تظهر ترابطا عاليا. هناك علاقة تتراوح بين “دقيقة” و”دقيقة جزئيًّا” في كل الدول العربية باستثناء دولتين فقط هما لبنان وجزر القمر، وهما حالتان سنتطرق لهما لمحاولة فهم خروجهما من هذا الترابط.
عود على بدء، قال تويريل أن هناك سببين لهذه الظاهرة (ظاهرة ارتفاع احتمالية الانتقال الديموقراطي في الأنظمة الديكتاتورية التعددية): السبب الأول هو أنه مهما كانت الممارسات التعددية صورية وسطحية فإنها تجبر النظام على التقرب من الناخب ومحاولة كسب وده. والثاني يكمن في أن الممارسات التعددية تفتح الباب لوقوع خلافات بين النخب الحاكمة بعضها البعض، على عكس الأنظمة الشمولية ذات الحاكم الواحد والحزب الواحد، التي تميل أكثر إلى طاعة رأي واحد. والترابط بين خلافات النخب الحاكمة واحتمالية الدمقرطة هو ترابط متعارف عليه في دراسات الدمقرطة، ذلك أن عددا كبيرًا من حالات الانتقال الديموقراطي حول العالم قد حصلت بسبب خلافات النخبة وحتى دون وجود ضغط شعبي في الشارع في بعض الأحيان. وهذا يتناسب مع النظام العربي الذي رصد علماء السياسة مروره بمراحل تغيير النخبة في العقود الأخيرة، فصارت هناك نخب أمنية تزاحم العسكرية (مثل وزارات الداخلية التي ازداد نفوذها)، وبرزت نخب رجال الأعمال لتقلل نفوذ رجال السياسة ودخلت أجيال جديدة من المستبدين أصغر بكثير من الأجيال المتربعة على السلطة ونشأت بينهم حساسيات واختلافات.
وهذا يمكن ربطه بالروايات المتعددة التي تقول بأنه حين اشتدت الثورة التونسية أمر بن علي الجيش بالقصف فرفض الجيش، وأن قيادة الجيش المصري رفضت أوامر بارتكاب مذبحة في ميدان التحرير، بينما في ليبيا وسوريا رأينا القوات المسلحة تطيع الأوامر في القتل حتى آخر لحظة، والعصيان لهذه الأوامر وُجِهت بالإعدام مما دفع الجنود لأن ينشقوا ويهربوا من فرقهم العسكرية.
بالإضافة لهذين السببين الذين يقترحهما تويريل هناك أسباب أخرى يمكن افتراضها هنا:
1- الممارسات التعددية تسمح بتشكل كيانات مما يسهل حشد الجماهير
وهذا العامل بدا واضحاً في الربيع العربي حيث تمكنت كيانات سياسية وغير سياسية مختلفة من اتخاذ موقف حين احتدمت الأحداث. وهذا يتضمن كيانات غير سياسية في طبيعتها مثل روابط مشجعي كرة القدم في مصر (الألتراس)، وجمعيات الأطباء في البحرين. بينما في الدول التي لا تتيح مجال لإنشاء كيانات حقيقية تعمل في العلن سيجد انصار التغيير صعوبة في الحشد سواء للنزول للشارع أو لإصدار بيان أو للإضراب عن العمل أو غير ذلك.
2- الممارسة التعددية تحدث تغيير في طريقة التفكير الجمعية
من الطبيعي أنه حين تستقر فكرة التغير عبر الصناديق في تفكير عشرات الملايين من المواطنين أن يتشكل وعي جمعي مختلف عن الذي تشكل في ظل الأنظمة التي لا يوجد لسكانها أي قناة رسمية ولو صورية للتغيير ولا سلطة لهم في تحديد من يخولونه بإدارة شؤونهم العامة، ففي هذه النظم يكون التفكير في التغيير ليس واردا بشكل جماعي منظم إنما بشكل فردي على الأغلب.
وهذا التحليل مرتبط بدراسات الإعلام والاتصال الجماهيري، حيث يؤدي الانفتاح السياسي والإصلاح إلى إدخال بخيارات سياسية جديدة على الوعي العام وعليه طريقة تفكير جديدة. وهذا التغير الجماعي في معلومات المواطن سيحدث فجوة بين ما يفضله بعض المواطنين وما يفضله النظام السياسي، وإذا ازدادت الفجوة وازداد عدد المواطنين الذين يفضلون مسارات سياسية مختلفة عن مسارات النظام السياسي كلما زادت فرص الثورة.
وهذه الآلية مذكورة في أدبيات الإعلام والاتصال الجماهيري، وتطبيقها هنا في أن النظم التي سمحت بهامش من الممارسة التعددية قد غيرت التفكير الجماعي للمجتمع، وأدخلت على كل المواطنين فكرة التغيير ببعض السبل كالانتخابات وغيرها، مما جعل الوعي الجماعي متقبل منذ فترة طويلة فكرة تغيير رأس النظام أو تغيير الحكومة أو البرلمان أو محاسبة كبار المسؤولين أو انتقادهم على الملأ أو مقاضاتهم.. إلخ، على عكس الأنظمة التي لا تسمح بهذا الهامش، التي يكون فيها التفكير الجماعي في سبل التغيير غير موحد ولا واضح ويدفع الناس نحو التفكير في التغيير بالعنف بسبب غياب سبل التغيير السلمية.
ولذلك من الشائع أن تجد صحيفة كويتية تتكلم عن مخالفة الدولة للدستور في قضية ما مثلا، أو أن تجد معارضا مصريا أيام حسني مبارك يقول أن التوريث مخالف للديموقراطية، وأن تجد غير ذلك من نقاشات التي تختلف اختلافا شاملا عن نقاشات المعارضة في الأنظمة التي حرمت التعددية مثل ليبيا أيام القذافي أو العراق أيام صدام حسين.
3- صعوبة سحب الإصلاحات المؤسساتية
الإصلاحات الصورية التي يمنحها حاكم ديكتاتوري ما لشعبه يمكن سحبها وإلغاءها بشكل أكثر سهولة في الأنظمة الديكتاتورية غير التعددية عنه في الديكتاتوريات التعددية التي تجد نفسها مضطرة لأن تجعل إصلاحاتها مؤسساتية. الحاكم الديكتاتوري في نظام غير تعددي يطلق وعود عن حرية الرأي مثلا في خطاب له هنا ويطلق وعودا أخرى بمكافحة الظلم في تصريح هناك وبعد ذلك يطبق هذه الوعود أو يخلفها كيفما شاء ولن يحاسبه أحد. في الأنظمة الديكتاتورية التعددية تتم الإصلاحات في شكل مؤسساتي أكثر ومرتبط بقرارات مكتوبة وقوانين مدونة ووزارات وأجهزة حكومية وقد تتدخل في تثبيت هذه الإصلاحات مجموعات مدنية، بمعنى آخر يصبح سحب هذه الإصلاحات أصعب خصوصا مع كثرة اللاعبين على الساحة، وهذا يعيدنا لما قاله تويريل من أن التعددية في هذه الأنظمة يفتح الباب لانشقاقات النخبة وخلافاتها وهذا بدوره يزيد من فرص الانتقال الديموقراطي.
- · الطبيعة الحلقية للتغير السياسي في العالم العربي
لطالما نظر إلى التطورات السياسية العربية في الدراسات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط على أنها تطورات حلقية، بمعنى أنها تحصل في شكل دائري يبدأ غالبا بفشل النظام مما يولد شيئا بسيطا من المعارضة يستجيب له النظام بشيء من الإصلاحات ثم يبدأ تدريجيا في تفريغها من محتواها مما يولد موجة جديدة من المعارضة تليها موجة من الإصلاحات، وهكذا حلقة تلو حلقة، وكلما زادت الحلقات زادت معها قوة المعارضة وتراكم خبراتها. طبعا هذا لا يعني أن السياسة في العالم العربي تسير في مسارات حلقية صارمة لا يمكن الخروج عنها ولكن يمكن القول ان هذا التفسير الحلقي مقبول في دراسة عديد من التطورات والظواهر السياسية في الدول العربية خلال المائة عام الماضية أو أكثر. هذا التصور يعد محوريًّا هنا لأنه يجعل الربيع العربي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات السابقة له وليس مجرد حدث صدر من العدم، ويجعله تطورا طبيعيا لمجموعة من التطورات التي سبقته.
والأمثلة كثيرة للتدليل على ذلك، منها على سبيل المثال الحالة الكويتية. في 2006 بدأت الحملات المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء (وهو من آل الصباح) بشكل صغير ومحصور تقريبا في البرلمان فقط، وفي 2009 كانت حلقة جديدة حين كسبت هذه الحملات زخما وقوة ونجحت في النزول للشارع وفي استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية بمجلس الأمة. ولذلك في 2011 حظيت الكويت بنصيب لا بأس به من الربيع العربي حيث جاءت الحلقة الجديدة أقوى من سابقاتها وأطاحت فعلا هذه المرة برئيس الوزراء وغيرت البرلمان. فلو تخيلنا أن أول مطالبة لإسقاط الرئيس جاءت في 2011 لوجدنا أنه على الأرجح لم يكن ليسقط بل ربما كانت جهود المعارضة لتستمر سنوات أخرى قبل أن تبني حلقة قوية بما فيه الكفاية لإزاحته من منصبه.
وهذا التراكم الحلقي مرتبط بمسألة الإصلاحات المؤسساتية التي ذكرت أعلاه، حيث يمكن للمراقب أن يرصد بسهولة أنه وقبل الربيع العربي كانت المعارضة في الدول الديكتاتورية التعددية تطالب بإصلاح المؤسسات والقوانين القائمة فعلا، كالمطالب بنزاهة الانتخابات وتوسيع صلاحيات البرلمان وتسهيل إجراءات إنشاء الأحزاب، على حين في الدول الديكتاتورية المطلقة كانت المعارضة في نفس الوقت مشغولة بالمطالبة بمجرد إيجاد هذه المؤسسات والقوانين.
- · الحالة الليبية والسورية
الحالة المسلحة في ليبيا وفي سوريا لهما نصيبهما من التفسير أيضا. فانعدام الممارسة التعددية لا يعني أن النظام سينجح في البقاء للأبد، بل يعني أن البلاد قد تنجرف سريعا للثورة المسلحة والانشقاقات عن النظام. وهذا ما قد يفسر بعض الحوادث السابقة في التاريخ العربي الحديث مع نظم سياسية لم تسمح بأي ممارسات تعددية كالثورة المسلحة ضد حكم سياد بري في الصومال ومحاولات الثورة المسلحة ضد حكم صدام حسين في العراق. وربما يكون هذا أحد أوجه تفسير بقاء الحركات المسلحة ضد حكم القذافي على قيد الحياة منذ نشأتها في الثمانينيات والتسعينيات إلى أن شاركت في ثورة 17 فبراير، في حين انتهت الحركات المسلحة في الجارة المصرية وضعفت إلى أن شاركت في ثورة 25 يناير السلمية، وانخرطت بعدها في العمل السياسي السلمي مثل غيرها من القوى السياسية في الساحة المصرية، علما أن الاثنين قد برزا في نفس الآونة تقريبا وتعرضا للملاحقة الأمنية الشديدة.
وفي سوريا بدأت الثورة سلمية ثم ما لبثت أن دخلت عليها المظاهر المسلحة خصوصاً مع تنامي حركة الانشقاقات عن مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية. ونلاحظ هنا أن البداية السلمية للثورة السورية قد يكون مرتبطًا بوجود هامش طفيف جدا من الممارسة التعددية قبلها، في حين بدأت الثورة في ليبيا مسلحة من أول أو ثاني أسبوع ولم تشهد قبل الثورة أي ممارسة تعددية تذكر. وقد ذكر تويريل في بحثه أنه كلما زادت هيمنة وسيطرة الحزب الحاكم في الأنظمة الديكتاتورية التعددية قلت فرص الانتقال الديموقراطي من داخل النظام أو كرد فعل على الضغوط الشعبية، وهذا ينطبق على الممارسة التعددية الهامشية في سوريا التي كان حزب البعث يسيطر فيها على مختلف جوانب الحياة.
وزيادة احتمالية الثورة المسلحة في هذه الأنظمة يرجع لعدة أسباب منها الانخفاض حالات تنازع النخب الحاكمة فيصبح قرار قمع الاحتجاجات مثلا أمرًا مقبولا عند كل النخب بالذات لدى النخب السياسية والعسكرية والأمنية، التي تكون على الأرجح قليلة العدد وشديدة التجانس والترابط، وما إن تسقط حتى يسقط كل النظام (مثلما حصل بعد مقتل القذافي) على عكس النظم الأخرى التي قد ينهار رأس النظام وتبقى بعض أطرافه ونخبه (مثل مصر واليمن). ويدرك المطالبون بإسقاط النظام خطورة الوضع عليهم مبكرا وأن النظام لن يتسامح معهم ولن يتعامل معهم باللين مما يجعل المناخ خصبا لتبني خيار التسلح مبكرا لدى هؤلاء المعارضين ولدى المتعاطفين معهم وهذا بدوره يوفر البيئة الخصبة لانتعاش الجهادية السلفية وخروجها من مجرد تنظيمات صغيرة ومستترة إلى تيار يجذب الكثير من الشباب إليه. بل أنا أزعم أن إتاحة شيء من الحريات والممارسات التعددية سيدفع بعض الجماعات الإرهابية في العالم العربي لإلقاء السلاح والتخلي عن خياراتهم العسكرية.
وبالنظر إلى الجداول نجد أن دول الخليج هي الأكثر عرضة لاحتمالية الثورة المسلحة أو انتعاش الحركات المسلحة إذا لم تبدأ في تغيير نهجها السياسي. وهذا يعطينا زاوية تحليلية أخرى لفهم الحركات المسلحة التي نشأت في عدة دول عربية والبعد الانقلابي فيها، ومنها حركة جهيمان مثلا، حيث إن الانتفاضات المسلحة – كما أسلفنا – لا تعتمد على التأييد الشعبي. فهي كالبذور التي قد تتحول لغابة لو جاءتها ظروف حادة تسقيها.
- · تفسير الاستثناء اللبناني والجزر قمري
الاستثناء الحاصل في جزر القمر يسهل تفسيره فهي دولة لم تنل استقلالها إلا مؤخرا في عام 1975، بل إن إحدى جزر الأرخبيل ما تزال تحت الحكم الفرنسي لأنها الوحيدة التي صوت أغلب سكانها ضد الاستقلال. ومنذ استقلال جزر القمر لم تخرج تماماً من هيمنة الدولة الفرنسية أو بعض المرتزقة الفرنسيين، لدرجة أن أحدهم قاد عدة انقلابات في البلاد واستولى في آخرها بنفسه على الحكم مما دفع الحكومة الفرنسية إلى إرسال قواتها لجزر القمر وخلع الرجل.
إذن هي دولة لم تختبر بعد تراكم كبير في التجربة السياسية وبناء الحلقات التي تحدثنا عنها، مما يفسر عدم دخولها في الربيع العربي بالرغم من وجود الممارسة التعددية. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل خاصة بجزر القمر تعرقل نشوء الحراك الشعبي مثل صغر الحجم وقلة السكان وتوزعهم على عدة جزر.
أما الحالة اللبنانية فهي أكثر صعوبة، وسأطرح هنا عدة تفسيرات محتملة لوجود الاستثناء اللبناني. التفسير الأول يقول أن لبنان تقع ضمن “الاستثناء الحربي” الذي ذكرناه سابقا وصنفنا الصومال والعراق وفلسطين والسودان فيه. ففي نهاية المطاف، لبنان بلد لم تهدأ فيه المشاكل الأهلية من قبل إنشاء الجمهورية، وشهد حربا أهلية ضارية امتدت من 1975 إلى 1990 ولم تنته تبعاتها وجروحها بعد بما فيها أزمات المهجرين داخل لبنان والمهاجرين خارجه (والذين تجاوز عددهم عدد سكان لبنان المقيمين فيه) وتجدد الاشتباكات الأهلية من فترة لأخرى مثل الاشتباكات الأخيرة في بيروت وطرابلس. وفوق ذلك هناك الاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت في 1948 ولم تنته أبدا، بل وقبل 30 عام كانت بيروت أول عاصمة عربية تحتلها إسرائيل، وظلت إسرائيل محتلة للجنوب اللبناني إلى عام 2000 ومعها فصيل منشق من الجيش اللبناني يحميها ويدافع عن احتلالها (جيش لبنان الجنوبي)، واشتبكت مع حزب الله مرارا وتكرارا بعد التحرير إلى أن نشبت حرب 2006 التي تلتها أيضاً حالات اشتباك مع إسرائيل ناهيك عن عدم توقف عمليات التجسس واختراق السيادة وخطف المواطنين من على الحدود والتهديد المستمر بالحرب. هذا كله يضاف إليه الوجود العسكري السوري الذي لم ينته إلا في 2005، ودخول عدد كبير من الجيوش في لبنان في مراحل مختلفة (منها الجيش السعودي والأميركي والسوداني والإماراتي وغيرهم) فهل هذه الحقائق تضع لبنان في الاستثناء الحربي؟ ربما.
التفسير الثاني يقول بأن لبنان وقعت في الاستثناء لأنها أقرب النظم العربية للديموقراطية. فالممارسة التعددية في لبنان، مهما كانت سطحية وقاصرة، قد سمحت بوجود انتقال سلمي للسلطة في أغلب التاريخ اللبناني الحديث. فمنذ استقلاله في الأربعينيات شهد لبنان أكثر كمية من الرؤساء ورؤساء الوزراء، وهذا بدوره يصعب تبلور معارضة موحدة ضد النظام، وذلك لأن النظام لا يرأسه شخص واحد يمكن توحيد الجهود ضده مثلما كان الحال في تونس ومصر مثلا. ومن المثير للاهتمام أنه في خضم انطلاقة الربيع العربي تمكنت المعارضة في لبنان من إسقاط الحكومة بشكل قانوني ومن دون الحاجة لتحريك الشارع أو استعمال السلاح. ورغم بعض الاضطرابات وأعمال العنف التي تلت هذه الخطوة، إلا أنها سرعان ما انطفأت وقبل سعد الحريري الرحيل من منصبه وقبلت كل القوى السياسية بتنصيب نجيب ميقاتي كرئيس وزراء لبنان الجديد وما زالوا بعد أكثر من عام يتعاملون معه ولا يشككون في شرعيته، مما قد يعني أن الديموقراطية اللبنانية لم تتحقق فقط بل “ترسخت” أيضا. علما أن التقييم السنوي للديموقراطية حول العالم الذي تقوم به وحدة الاستخبارات بالإكونوميست قد صنفت لبنان على أنه أكثر البلدان العربية قربا من الديموقراطية في تقريرها لعام 2010.
التفسير الثالث للاستثناء اللبناني هو أن الحجم الصغير للبنان وتوزع السكان على أكثر من 18 طائفة دينية وعرقية يجعل تبلور معارضة وطنية متجاوزة للطوائف مسألة شبه مستحيلة. وليس خفيا أن أكبر الأحزاب اللبنانية (حزب الله، حركة أمل، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الإشتراكي، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، التيار الوطني الحر) كلها مبني على خلفية طائفية ومناطقية أو إحداهما، على حين الأحزاب التي لا يهيمن عليها الانتماء الطائفي دائما أضعف، مثل الحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي. فلا وجود حقيقي للإحساس بـ “نحن وهم” أو “النظام والشعب” وذلك لأن النظام يُبدَّل بين الأحزاب والطوائف القوية، وكذلك المعارضة، فلا يوجد تبلور حقيقي لهوية النظام أو هوية المعارضة، أو الشعب.
- · الاستنتاجات
هناك علاقة واضحة بين طبيعة النظام السياسي في أي دولة عربية وبين احتمالية تعرضها للثورة السلمية أو المسلحة. وكلما زادت الممارسة التعددية كان ذلك أدعى للانتقال الديموقراطي تحت ضغط الشارع وقوى المعارضة، وكلما قلت الممارسة التعددية زاد احتمال الصدام المسلح مع جماعات ترى عدم شرعية النظام.
- · التوصيات
لابد لنشطاء المعارضة الساعيين للتغيير في بلدانهم أن:
1- يحرصوا على بناء حلقات متتالية من التجربة النضالية.
2- لا يستخفوا بأي إصلاح يحصلون عليه من النظام مهما كان هامشيا وصوريا، ينتقدونه ولكن يستغلونه لمنح الشعب مزيدا من المكاسب.
3- يسعوا للحصول على إصلاحات مؤسساتية وموثقة على شكل قوانين مكتوبة.
4- الحرص على استغلال أي قناة رسمية للمشاركة السياسية مهما كانت هامشية والسعي لتوسيعها وترسيخها.
5- يمدوا شبكات التواصل مع الكيانات الموجودة في المجتمع باهتماماتها المختلفة: السياسية والقانونية والدينية والرياضية والشبابية والخيرية والفنية والعمالية والطلابية.
6- إدراك حجم التأثير المنتظر منهم في إحداث التغيير خصوصا وأن نجاحهم قد يعني وأد الاستبداد والتطرف معا، وحقن دماء مستقبلية نحن في غنى عن رؤيتها.
خاص بموقع “المقال”.
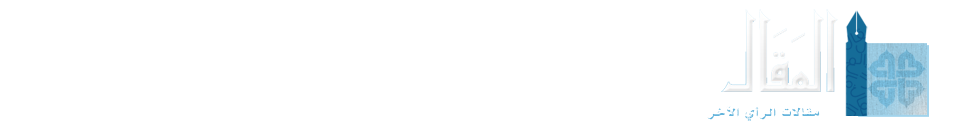











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك