
العنف الرمزي في قضية حمزة كشغري
 18 فبراير, 2012
18 فبراير, 2012  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
في قضية حمزة كشغري الأخيرة في السعودية، أُطلِقت اتهامات، من قبل عقلاء وغير عقلاء، تتجاوز الاتهام الموجه لحمزة وخطأه الأخلاقي والديني والاجتماعي، لتصل إلى فئات أخرى. هذه الاتهامات تُوجَّه بشكل مركز وكثيف تجاه الشباب المنفتح والمتحرر والتنويري في السعودية، على اعتبار أنهم المسؤولون بانفتاحهم واختلافهم الفكري عن هذه “الموجة”. نعم، لقد عُدَّ أن الإلحاد والخروج عن الدين موجة لدينا، وأُلصِق حمولتها تهمةً بهذه الفئة، وهذا الأمر ليس سوى “عنف رمزي”.
في البدء، كان الصراع
العنف الرمزي يختلف عن العنف المادي، وربما كان أبلغ أثرًا منه، فهو معني، كما يقول عبدالإله بلقزيز، بإلحاق الضرر السيكولوجي بالإنسان. أي استهداف شعوره الذاتي “بالأمن، والطمأنينة، والكرامة، والاعتبار، والتوازن… إلخ”. وربما يرى البعض أن العنف النفسي مبرر لترهيب بعض مرتكبي الخطأ، وهذا المقال لا يناقش هذا القول ولا يقف عنده، بقدر ما يهدف إلى إلقاء الضوء على مسألة أعمق وأبرز، وغير مبررة، وهي أن العنف الرمزي قد يتعدى حدود قضية ومسألة محددة ليصبح هجوما على فئات مجتمعية، فتصبح المسألة أخطر هنا لأنها تحدث على مستوى مجتمع لا فرد.
من السهل أن تنتصر حين تكون معركتك الثقافية في المجتمع أمام “الإرهاب” و “الإلحاد”، لكن هل هذه هي حقا المعركة الثقافية لدينا؟!، بمعنى آخر، لو ذهبت إلى أحد المجالس الملأى بالناس في بلدنا وأخذت تهاجم الإرهاب أو الإلحاد فلن تجد من يرد عليك!، وهذا لا يعني أنك تنتصر في معركة، لأن الأقرب هو أن الجميع مقتنعون بذلك حتى من قبل أن يأتيهم كلامك. والتركيز هنا على مسألة الصراع، لأن النفَس الذي ذهب بمسألة “الإلحاد” بعيدا، هو نفَسٌ وتيار صراعي، يحاول أن يكسب من هذه الدعاوى عبر تنميطها وتعميمها على فئات شبابية ومثقفة تختلف عنه.
الثقافة الجديدة والمختلفة والنشطة لشبابنا اليوم لا تصنف أنها أيدلوجية. لأن واقعهم الجديد المرتبط بزمن جيلهم هو واقع غير أيدلوجي. فالمشاكل اليوم أكثر واقعية وأقل أيدلوجية، أي أنها مرتبطة بالنظم المدنية والسياسية والحقوق المطلبية بدرجة أكبر من ارتباطها بعالم المثل والمسارات الفكرية المحددة. واتضح لنا ذلك مثلا من خلال ظاهرة “الربيع العربي”، فلاحظنا كيف خفتت الأيدلوجيا وارتفع صوت الشباب لأجل المطالبة الحقوقية والتنظيم المدني والسياسي لبلادهم.
وصاحب الأيدلوجيا قد يُهزم بسهولة أمام الشباب في معركتهم المدنية والفكرية. فالأمور المدنية والحقوقية والتنويرية التي يعمل عليها عدد واسع من طلائع شبابنا الجدد، هي ممارسات واضحة وصريحة ومنطقية، ولا تحتاج لفتوى شيخ أو رأيه ومباركته، ولا لتوقيع رئيس تحرير لديه أجندته البائتة، أو إذن سياسي ومسؤول.
لكن صاحب الأيدلوجيا في هذه الحالة يعمل على خلق ارتداد أيدلوجي مقابل، لكي يتصارع معه وينتصر من خلاله. وهو سيعمل على صناعة هذا الضد حتى لو لم يكن موجوداً فالداعية يعمل على تضخيم مسألة الإلحاد والعلمانية، وكأنها متفشية وظاهرة في كل زاوية، حتى يُحتَاج إلى ما لديه. والعالم الشرعي ورجل الدين التقليدي، تجده يبالغ في وجود “الشرك” وكثرة مظاهره وانتشارها، حتى ينفق مما لديه من بضاعة علم شرعي تتركز في هذا الموضوع. مع أن الفضلاء طالما حاولوا لفت الانتباه أن مظاهر الشرك غير موجودة في بلادنا، وأن الأولى هو صرف هذه الجهود والحلقات العلمية إلى مشاكل واقعية موجودة وملحة!، لكن البعض استمر في تصميمه على اصطناع صراعات معينة من أجل أن يستثمر “رأس ماله الثقافي” فيها.
قبل مدة، وجدنا إعلاميين وصحفيين وطلبة علم يمارسون الربط بين الشباب التنويري والحقوقي وبين الإرهابيين، باعتبار أن هذه فئات متماثلة تعمل على تغيير الوضع القائم بطرق غير مقبولة ولا مُعتبر بها سلفيا أو تقليديا، فماثلوا هكذا وبكل برود بين شباب تنويري وشباب آخر قد يرى القتل واستحلال الدماء!. إن طرح الشباب التنويري المثقف لا يخلو من مشاكل، لكن هؤلاء لم يناقشوا مشاكل هذا الطرح، بل ناقشوا مشاكل طرح آخر (تسهل هزيمته). ونفس الشيء الآن يحدث مع من يريد أن يقف أمام هذا التيار الشبابي المنفتح والمختلف، فيلصق بهم تُهما لم يحملوها على أكتافهم.
ولا ننسى أن المتدينين أنفسهم كانوا سابقا ضحية لمثل هذا العنف الرمزي، عبر ظاهرة الإرهاب في العقد السابق. حين حدث الضح والتعميم والتنميط للإرهاب بوصفه تهمة، فتضرر كثير من المتدينين ومنعوا من العمل الخيري ومن أنشطة المكتبات وغيرها.
والإرهاب والإلحاد هي نهايات “متطرفة” و”محدودة” على أقصى اليمين وأقصى اليسار، ولا يمثلان موجات ولا تيارات، وكن يستسهل البعض أن يعمّمها بوصفها تهمة حتى يمارس تجريم الطرف الآخر من خلالها. فالعنف الرمزي يستند ابتداءً على نقطة حسّاسة وتؤلم على نطاق واسع مثل قضية الإرهاب أو المساس بجانب الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، فتتكون هنا فرصة قد يستخدمها من لا يعدل في الخصومة، ومن يذهب بها بعيدا في صراعاته ومكاسبه.
وتتضح خطورة هذا العنف الرمزي على المجتمع والأخلاق، حين نجد أستاذا للعقيدة في جامعة “الإمام محمد بن سعود” يقول عبر “تويتر” أن من مارس تعيير حمزة بأصله وعرقه فلعل ذلك أن ينغمر في حسنة ذبّه عن الرسول. هكذا! لعنصرية والإساءة والتجاوز في حق الناس والمجتمع من الممكن تبسيطها والسماح بها، بدعوى أن هناك قضية خطيرة وحسّاسة وظروفها تسمح بذلك!، هكذا نزعة نفسية وعاطفية لن تعدم أن تبرر لنفسها تجاوزاتها التي تريد بكل أسلوب وطريقة. ورحم الله أوائل السلف الذين قالوا أن: حقوق الله مبناها على السعة، وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح.
بورديو والعنف الرمزي
ذكرت في الأعلى مفهومين هما: العنف الرمزي (Symbolic violence)، ورأس المال الثقافي (Cultural capital). وصاحب هذين المفهومين هو عالم الاجتماع السياسي بيير بورديو (1930-2002). يعد بورديو ومنذ نهاية الستينيات قامة من أهم القامات الفرنسية والعالمية في علم الاجتماع، بجانب مواطنيه دوركهايم وميشيل فوكو. كتب بورديو أكثر من ثلاثين كتابا إلى جانب مئات المقالات العلمية. وأكثر ما تميز به هو اشتغاله على مفاهيم تجريبية حيوية يأخذها من الشارع ومن الثقافة الحية بين الناس، ويسائل عبرها ويختبر الأذواق الاستهلاكية والثقافية، وأنماط الهيمنة، ومنطق العلاقات في الحقول الاجتماعية.
كان بورديو يرى نفسه باحثا تجريبيا يزاوج بين النظرية والتطبيق التجريبي، فهو يرى أن (التجريب) أساس البحث العلمي. ومن أهم المفاهيم السوسيولوجية التي قدمها بورديو: رأس المال الثقافي، والعنف الرمزي، ونظام الاستعدادات والقيم أو الطبع (الهابيتوس)، والحقل أو المجال، وإعادة الإنتاج.
وإن كان ماركس قد أتى بمفهوم “رأس المال” ليدلل كيف انقسم الناس إلى طبقات وإلى خاضع ومستغل، فإن بورديو أتى بمفهوم “رأس المال الثقافي”، الذي يكون أخفى من رأس المال الاقتصادي لكن له تأثير أعمق في نسج التمايزات وتنسيق الهيمنة. فبحسب بورديو ليس المال وحده ما يجعل أحدهم ينتقل من طبقة إلى أخرى أعلى منها بل هو مخزونه من رأس المال الثقافي الخاص بتلك الطبقة، من مفردات وسلوكيات وانطباعات وأذواق غيرها من الأمور المشتركة بينهم، التي يكون لها ثقل ووجود رمزي. ويوضح بورديو أن النخب تمارس تمايزها وطغيانها عبر ما يسميه بالعنف الرمزي حيث تقوم النخب بترويج مفاهيمها وأساليبها على أنها هي الطرق السليمة التي ينبغي للجميع السير فيها ومحاكاتها، ومن يخالف هذه الصورة والسياق المفترض يشعر بذنب المخالفة، وبانطباع سلبي عن ذاته، التي تتمزق بين طبيعتها وطبيعة مصطنعة لمثال دخيل عليها. ومن الأمثلة الواضحة على العنف الرمزي، حين يحتقر أبناء القرى لهجتهم أمام لهجة أبناء المدن التي قد تبدو راقية وقوية. رغم أن هذه كتلك، معطى طبيعي لا يتضمن السوء أو الخير بذاته.
لقد كان بورديو يرى أن علم الاجتماع لا يستحق الاهتمام إن لم يكن في خدمة الإنسان والمجتمع، وإن لم يعمل على كشف آليات الهيمنة السائدة في المجتمع وتفكيكها. وقد كان واعيا بهذا الموضوع منذ فترة مبكرة في حياته، فذكاؤه الدراسي جعله يحظى بفرصة الدراسة في باريس في كلية راقية ورفيعة كانت شبه مغلقة على أبناء النخب والطبقات الثرية، وشاهد فيها كيف يتعاملون معه وهو القادم من قرية صغيرة ومن عائلة متوسطة الدخل، فقال البعض إن هذا ما جعل بورديو يتبنى عاطفة حادة ضدهم رافقته في بقية حياته فيما يشبه الانتقام. وهو في تفكيكه لأنماط الهيمنة الحديثة، كان متأثرا بالفيلسوف الإيطالي أنتونيو غرامشي، فالأخير هو صاحب مفهوم “الهيمنة الثقافية”، الذي تحدث عنه في “دفاتر” سجنه، وأعلن أن الطبقات المتحكمة في المجتمعات الحديثة لم تعد بحاجة إلى القوة لفرض سيطرتها، بل يكفي تعميم أعرافها وطرائقها لكي تحظى بالسيطرة.
وأتباع القوى والأيدلوجية السائدة يستخدمون العنف الرمزي عبر هذه الأعراف والطرائق، التي تمثل سبيلا لهم لإبعاد الآخر وإقصائه ومحاكمة ما لديه. إن المسألة الرمزية والثقافية مؤثرة لدينا بشكل كبير. فإذا كان مفكرو الغرب قد اهتموا بتفكيك الهيمنة الرمزية والثقافية، فنحن أولى بالانتباه لهذا البعد في ثقافتنا.
فالصراع في تاريخنا لم يكن صراعا ماديا بين طبقات، بقدر ما كان صراعا بين مناطق البداوة والتمدن، ولا تخفى أهمية الرمزية والأعراف والطرائق الرمزية بين هذين العالمين. رغم أن البعض، خصوصا من اليساريين، قد حاول تفسير التاريخ لدينا عبر جدلية مادية، كما فعل المؤرخ فيصل السامر حين كتب كتابه “ثورة الزنج” ليبين أن هذه الثورة، التي تعد من أوائل الثورات وأعنفها في الإسلام، ليست إلا “حربا اجتماعية ذات طابع طبقي”. ومن يتأمل أيام العرب وحروبهم يدرك كيف كانت الأمور المعنوية هي أكثر ما يستثيرهم، فأغلبها قد اشتعل عبر إهانة للكرامات أو صراع بين المقامات. وبيت شعر قد يرفع من قبيلة، وينزل من قدر أخرى. بالإضافة إلى أن الثقافة الدينية التي تعد المكون الأهم في ثقافتنا، تتجسد معنويا واعتقاديا. ولذلك مسألة القتل المعنوي للفرد بإبعاده من القبيلة أو من الدين كانت السلاح الرمزي الأعنف في ثقافتنا طوال تاريخها.
تجاوز في حق الإنسان
استغرب كثيرون من هذا الهجوم والاندفاع الثقافي الواسع على الشباب المثقف والتنويري في السعودية مؤخرا، وربطه، عبر اصطياد الشوارد والشكوك، بقضية لم يقد لها خطاما. وبرأيي أن هذا الهجوم له تفسيره الثقافي المركب، فأولا هو يساعد على استخدام رأس المال الثقافي (الديني والوعظي) المتكوّن مسبقا لدى الفئة المهاجمة، فهي تظل تبحث دوما عن مساحات لاستخدامه، ولا يوجد أفضل من أن تخلق مساحة يكون خصمك فيها منحرفا (أو ملحدا) حتى تكون المعركة مناسبة لسلاحك. وهذا يفسر ميل البعض لتعميم حوادث على الفئات المختلفة كالمثقفين والتنويريين، مثل حادثة بهو فندق الماريوت، وقضية كشغري. والأمر الآخر هو جانب “مفهومي”. فلطالما ربُط مفهوم “الحرية” لدينا بأنه (حرية الفساد أو الانحراف عن الدين)، والقضية الأخيرة لكشغري، حين تُستغل قد تساعد على تثبيت المفهوم بهذا الشكل. لذا القضية لديها أكثر من بُعد ثقافي كامن يجعلها تندفع لمستويات بعيدة، وستظل مستمرة في ذلك.
هناك مقولة تنسب للخليفة عمر بن عبدالعزيز تقول أن “السلطان بمنزلة السوق، يُجلب إليها ما ينفق فيها، فإن كان برّا أتوه ببرهم، وإن كان فاجرا أتوه بفجورهم”. وما يحدث لدينا في مسألة استثمار “رأس المال الثقافي” من قبل التيارات هو عكس ذلك. أي أن هناك من يصطنع سوق يناسب رأس ماله وبضاعته لكي ينفقها فيه. فيُوحى أن هذا الحقل وهذه البيئة محتاج إلى كذا، و”كذا” تعني بضاعة هذا التيار. والاستخدام لرأس المال الثقافي والرمزي في قضايا الهيمنة، يجعلنا نفهم مثلا كيف أن العسكر حين حكموا بعض الدول بحثوا عن الحروب، وذلك لأن رأس مالهم وتمايزهم وما يجيدون يتركز في هذه النقطة. وكذلك رجال الدين، يعتمد مفهومهم دوما على الرعاية والوصاية فيناسبهم بذلك الإيحاء بوجود بيئة غافلة وخاطئة، تحتاج إليهم دوما.
واستخدام رأس المال الثقافي، ورفده بالعنف الرمزي كان حاضر بقوة في قضية حمزة كشغري. فهناك من بدأ يتحدث عن خلايا نائمة (إلحادية)، ومن يطالب بحصر الأسماء تمهيدا لرفعها للقضاء وللمسؤولين، وهناك من تهجم عبر القصيدة، وآخر عبر الفتوى، وآخرون عبر التهديد المادي والمعنوي، وإهانة عنصرية للأصل والعرق، وتهجم على البيئات الحاضنة وتجمعات الشباب المدنية، بل وصلت التهم لدى البعض إلى ما سمّي بــ”مطالعة الكتب الفكرية”!، وما أجملها من تهمة بالمناسبة.
يوجد لدينا بالفعل بعض الأجواء الثقافية المرضية، فعلى سبيل المثال هناك منتديات ليبرالية تكتب فيها أسماء مستعارة وتقدم فيها ثقافة ساقطة واعتدائية لا يقرها عاقل.. لكن هذه تحسب على نفسها فقط، فمثلها مثل منتديات دينية سابقا كانت تشجع على الإرهاب والتخريب، ومن الظلم أن تُحسب على ثقافة الإسلاميين.
إن العنف الرمزي في القضية الحالية وضّح لنا مستوى مرتفعا من ثقافة الكراهية والاستعداء. لقد استباح البعض حرمة الناس، واستسهلها، وأصبح يتعدى ويشكك ويحقق ويتقصّى تحت مزاعم حفظ الدين!، ولم يكن للغيرة على الدين ولا على رموزه أن تكون سببا للتعدي على الناس.
نحن محتاجون بالفعل إلى أن نجدد فهمنا واعتبارنا بسماحة هذا الدين وعظمته، عبر حفظ قيمة الإنسان في داخله، وحماية حقوق الناس فيما بينهم. إن غضب الله وسخطه لا يحل بالناس حال الكفر أو خطأ بالعقيدة، بقدر ما يحل حال استباحة وامتهان حقوق الناس.
قال الفخر الرازي في “التفسير الكبير” ضمن تفسيره للآية الكريمة “وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون”: “إنه تعالى لا يُهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في المعاملات في ما بينهم، والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين بالشرك والكفر وإنما ينزل ذلك العذاب إذا أساؤوا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم، ولهذا قال الفقهاء إن حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة والمساهلة وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح”.
خاص بموقع ” المقال”.
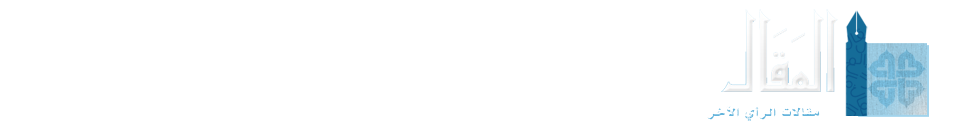











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك