
ربيع العرب: قراءة في التحولات العربية وتأثيرها في حالة التسامح 2-2
 26 يناير, 2012
26 يناير, 2012  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
العالم العربي ودولة المواطنة:
لعلنا لا نأتي بجديد حين القول: إن أغلب المجال العربي بكل دوله وشعوبه، يعاني من تحديات خطية وأزمات بنيوية، ترهق كاهل الجميع، وتدخلهم في أتون مآزق كارثية.
فبعض دول هذا المجال العربي، دخلت في نطاق الدول الفاشلة، التي لا تتمكن من تسيير شؤون مجتمعها، مما أفضى إلى استفحال أزماتها ومآزقها على كل الصعد سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية. والبعض الآخر من الدول والمجتمعات، مهدد في وحدته الاجتماعية والسياسية، حيث قاب قوسين أو أدنى من اندلاع بعض أشكال الحروب الأهلية وصورها.
ودول أخرى تعاني من غياب النظام السياسي المستقر، وما زالت أطرافه ومكوناته السياسية والمذهبية، تتصارع على شكل النظام السياسي، وطبيعة التمثيل لمكونات وتعبيرات مجتمعها.
إضافة إلى هذه الصور، هناك انفجار للهويات الفرعية في المجال العربي بشكل عمودي وأفقي، مما يجعل النسيج الاجتماعي مهددا بحروب وصراعات مذهبية وطائفية وقومية وجهوية . ونحن نحسب أن اللحظة العربية الراهنة، مليئة بتحديات خطيرة، تهدد استقرار كثير من الدول والمجتمعات العربية، وتدخل الجميع في أتون نزاعات عبثية، تستنزف الجميع وتضعفهم، وتعمق الفجوة بين جميع الأطراف والمكونات.
وفي تقديرنا أن المشكلة الجوهرية، التي ساهمت بشكل أو بآخر في بروز هذه المآزق والتوترات في المجال العربي، هي غياب علاقة المواطنة بين مكونات المجتمع العربي الواحد وتعبيراته.
فالمجتمعات العربية تعيش التنوع الديني والمذهبي والقومي، وغياب نظام المواطنة بوصفه نظامًا متجاوزًا للتعبيرات التقليدية، جعل بعض هذه المكونات تعيش التوتر في علاقتها، وبرزت في الأفق توترات طائفية ومذهبية وقومية. فالعلاقات الإسلامية -المسيحية في المجال العربي، شابها بعضُ التوتر، وحدثت بعض الصدامات والتوترات في بعض البلدان العربية التي يوجد فيها مسيحيون عرب.
وفي دول عربية أخرى، ساءت العلاقة بين مكوناتها القومية، بحيث برزت توترات وأزمات قومية في المجال العربي . وليس بعيدا عنا المشكلة الأمازيغية والكردية والأفريقية.
وإضافة إلى هذه التوترات الدينية والقومية، هناك توترات مذهبية بين السنة والشيعة، وعاشت بعض الدول والمجتمعات العربية توترات مذهبية خطيرة تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي.
فحينما تتراجع قيم المواطنة في العلاقات بين مكونات المجتمعات العربية، تزداد فرص التوترات الداخلية في هذه المجتمعات؛ لهذا فإننا نحسب أن العالم العربي يعيش مآزقَ خطيرة على أكثر من صعيد، وهي بالدرجة الأولى تعود إلى خياراته السياسية والثقافية. فحينما يغيب المشروع الوطني والعربي، الذي يستهدف استيعاب أطياف المجتمع العربي، وإخراجه من دائرة حبسه في الأطر والتعبيرات التقليدية إلى رحاب المواطنة؛ فإن هذا الغياب سيدخل المجتمعات العربية في تناقضات أفقية وعمودية، تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي.
وإن نزعات الاستئصال أو تعميم النماذج، لا تفضي إلى معالجة هذه الفتنة والمحنة، بل توفر لها مزيدًا من المبررات والمسوغات.
فدول المجال العربي معنية اليوم وبالدرجة الأولى بإنهاء مشاكلها الداخلية الخطيرة، التي أدخلت بعض هذه الدول في خانة الدول الفاشلة والبعض الآخر على حافة الحرب الداخلية التي تنذر بالمزيد من التشظي والانقسام، فما تعانيه بعض دول المجال العربي على هذا الصعيد خطير، وإذا استمرت الأحوال على حالها فإن المجال العربي سيخرج من حركة التاريخ، وسيخضع لظروف وتحديات قاسية على كل الأصعدة والمستويات.
وإن حالة التداعي والتآكل في الأوضاع الداخلية العربية، لا يمكن إيقافها أو الحد من تأثيراتها الكارثية، إلا بصياغة العلاقة بين أطياف المجتمع على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وإن غياب مقتضيات المواطنة وحقائقها في الاجتماع السياسي العربي، سيقوي من اندفاع المواطنين العرب نحو انتماءاتهم التقليدية، وعودة الصراعات المذهبية والقومية والدينية بينهم، وسيوفر لخصوم المجال العربي الخارجين إمكانية التدخل والتأثير في راهن هذا المجال ومستقبله.
فالمجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات الإنسانية، التي تحتضن تعدديات وتنوعات مختلفة، لا يمكن إدارة هذه التعدديات على نحو إيجابي إلا بالقاعدة الدستورية الحديثة [ المواطنة ] كما فعلت تلك المجتمعات الإنسانية التي حافظت على أمنها واستقرارها.
فالاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمعات العربية، هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية.
وأي مجتمع عربي لا يفي بمقتضيات هذه المواطنة، فإن تباينات واقعه ستنفجر وسيعمل كل طرف للاحتماء بانتمائه التقليدي والتاريخي؛ مما يصنع الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية بين مكونات المجتمع الواحد.
وفي غالب الأحيان فإن هذه الحواجز، لا تصنع إلا بمبررات ومسوغات صراعية وعنفية بين جميع الأطراف، فتنتهي موجبات الاستقرار، ويدخل الجميع في نفق التوترات والمآزق المفتوحة على كل الاحتمالات.
لهذا فإن دولة المواطنة هي الحل الناجح لخروج العالم العربي من مآزقه وتوتراته الراهنة.
فدولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه، وهي التي تستوعب جميع التعدديات وتجعلها شريكة فعلية في الشأن العام، وهي التي تجعل خيارات المجتمع العليا منسجمة مع خيارات الدولة العليا والعكس، وهي التي تشعر الجميع بأهمية العمل على بناء تجربة جديدة على كل المستويات، وهي التي تصنع الأمن الحقيقي لكل المواطنين في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
والمجتمعات لا تحيا حق الحياة، إلا بشعور الجميع بالأمن والاستقرار. لهذا فإن الأمن والاستقرار لا يبنى بإبعاد طرف أو تهميشه، وإنما بإشراكه والعمل على دمجه وفق رؤية ومشروع متكامل في الحياة العامة.
وهذا لا تقوم به إلا دولة المواطنة، التي تعلي من شأن هذه القيمة، ولا تفرق بين مواطنيها لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية.
فهي دولة الجميع، وهي التمثيل الأمين لكل تعبيرات المجتمع وحراكه.
فالمجال العربي اليوم من أقصاه إلى أقصاه، أمام مفترق طرق. فإما مزيد من التداعي والتآكل، أو وقف الانحدار عبر إصلاح أوضاعه وتطوير أحواله، والانخراط في مشروع استيعاب جميع أطرافه ومكوناته في الحياة السياسية العامة. فالخطوة الأولى المطلوبة للخروج من كل مآزق الراهن وتوتراته، في المجال العربي، هي أن تتحول الدولة في المجال العربي إلى دولة استيعابية للجميع، بحيث لا يشعر أحد بالبعد والاستبعاد. دولة المواطن بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو قومه، بحيث تكون المواطنة هي العقد الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف. فالمواطنة هي الجامع المشترك، وهي حصن الجميع الذي يحول دون افتئات أحد على أحد.
وخلاصة القول: أن دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، هي خشبة الخلاص من كثير من المآزق والأزمات.
:العالم العربي والحكم الرشيد
يعيش العالم العربي بكل دوله وشعوبه اليوم كثيرًا من التحولات والتطورات المتسارعة. حيث دشنت لحظة سقوط نظام بن علي في تونس عملية التغييرات والتحولات التي ما زال تأثيرها ممتدا ومتواصلا في كل أرجاء العالم العربي بمستويات وأشكال متفاوتة ومختلفة. ولا ريب أن ما يجري من أحداث وتطورات في بعض البلدان العربية، هو مذهل وغير متوقع وكل المعطيات السابقة، لا تؤشر أن ما حدث سيكون قريبا.
لهذا فإن كل هذه التطورات والتحولات هي بمستوى من المستويات مفاجئة للجميع.
لذلك فإن النخب السياسية في العالم العربي بكل أيدلوجياتها وخلفياتها الفكرية، كانت تعيش حالة من اليأس تجاه قدرة الشعب أو الشعوب العربية من إحداث تحولات دراماتيكية في واقعها السياسي وواقع المنطقة بشكل عام. ولكن جاءت أحداث تونس وتطوراتها وتحولاتها ومن بعدها مصر، لكي تثبت عكس ما كانت تروجه بعض الأيدلوجيات والنخب تجاه الجماهير وقدرتها على إحداث تغيير سياسي في واقعها العام. واللافت للنظر والذي يحتاج إلى كثير من التأمل العميق هو أن جيل الشباب، أي جيل الإعلام الجديد من الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، هو الذي قاد عملية التغيير، وهو الذي تمكن من تحريك الشارع العام في تونس ومصر. فالجيل الجديد الذي كانت تصفه بعض النخب والجماعات، بأنه جيل ترعرع دون قضية عامة يسعى من أجلها ويناضل في الدفاع عنها عكس أجيال الخمسينيات والستينيات، هو الذي قاد عملية التغيير، وبوسائله السلمية استطاع أن يحرك كل النخب وكل شرائح المجتمع الأخرى وفئاته.
لهذا فإن ما حدث –ويحدث- في العالم العربي اليوم هو مذهل، وقد أنهى حقبة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياته؛ حيث كان الغرب ينظر إلى شرائح المجتمعات العربية المختلفة بوصفها مشروعًا قائمًا أو محتملا للإنسان الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقوم بأعمال عنفية لا تنسجم وقيم الدين وأعراف العالم العربي وتقاليده الراسخة.
فما جرى في تونس ومصر، حيث حضر الشباب، ومارسوا حقهم بالتعبير عن الرأي، أنهى على المستوى الاستراتيجي حقبة بقاء الشباب العربي تحت تهمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياته.
فالنموذج الجديد الذي قدمه الشباب العربي في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا وسياسيا ومطلبيا هو أنه جيل يستحق أن يعيش حياة كريمة وأن تعاطيه الشأن العام عبر عنه خارج الأطر والأحزاب الأيدلوجية، وإنما مارسه بطريقته الخاصة، والمذهل في الأمر أن هذه الطريقة غير المتوقعة هي التي آتت أكلها، ونجحت في إحداث تغييرات وتحولات سياسية واجتماعية كبرى في أكثر من بلد عربي. لهذا فإننا نحسب أن المنطقة العربية بأسرها، تعيش مرحلة جديدة على أكثر من صعيد. وما نود أن نؤكده في هذا السياق هو النقاط التالية:
1 – إن المجتمعات والشعوب العربية تستحق حكومات وأنظمة سياسية متطورة ومدنية، وتفسح المجال للكفاءات الوطنية المختلفة للمشاركة في تنمية الأوطان العربية وتطويرها على مختلف الصعد والمستويات.
والذي يلاحظ أن الدول العربية التي كانت أو ما زالت في منأى من موجة المطالبة بالإصلاحات والتغييرات، هي تلك الدول التي تعيش في ظل أنظمة وحكومات فيها بعض اللمسات أو الحقائق الديمقراطية، أو تمكنت من حل بعض مشاكل شعبها الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك فإننا نزعم أن هذه الموجة ستشمل بشكل أو بآخر كل الدول والشعوب العربية.
ونحن نؤمن أن مسارعة الدول العربية في القيام بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، سيقلل من فرص خروج الناس إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم. وما جرى في تونس ومصر، يوضح بشكل لا لبس فيه أن المجتمعات العربية تستحق أوضاعا سياسية واقتصادية وقانونية أفضل مما تعيشه الآن.
2 – إن التحولات السياسية الكبرى التي تحققت في تونس ومصر، وموجاتهما الارتدادية في أكثر من بلد عربي، تجعلنا نعتقد وبعمق أن المشاكل الكبرى وبالذات على الصعيد السياسي متشابهة في أغلب الدول العربية. فالحكومات والأنظمة السياسية في هذه الدول، هي أنظمة ذات قاعدة اجتماعية ضيقة، مع تضخم في أجهزتها الأمنية التي تمارس الإرهاب والقمع بكل صوره وأشكاله، مما زاد من الاحتقانات، وراكم من المشكلات البنيوية التي يعيشها المجتمع والدولة في هذا البلد العربي أو ذاك.
وبفعل هذه الحقيقة تمكنت هذه الدول التسلطية من إفراغ كل الأشكال والحقائق الديمقراطية الموجودة في أكثر من بلد عربي من مضمونها الحقيقي، حتى أضحت نموذجا صارخا للمقولة التي أطلقها المفكر المصري ( عصمت سيف الدولة ) بالاستبداد الديمقراطي. فالأشكال الديمقراطية أصبحت عبئا حقيقيا على المجتمعات العربية ونخبها السياسية والاجتماعية والثقافية؛ لأنه باسم الديمقراطية تُؤيَّد السلطة واحتكار عناصر القوة وتستفحل من جراء هذا كل أمراض الاستبداد والديكتاتورية.
3 – إن الإصلاح السياسي الذي نرى أنه جسر عبور لكل الدول العربية إلى مرحلة جديدة، تؤهلها لتجاوز بعض مشكلاتها، ومعالجة أزماتها الداخلية، ويحصنها من خلال تطوير علاقة الدولة بمجتمعها تجاه كل التحديات والمخاطر. أقول إن هذا الإصلاح السياسي هو ضرورة حكومية – رسمية، كما هو حاجة وضرورة مجتمعية.
فهو (الإصلاح) ضرورة للحكومات العربية لتجديد شرعيتها الوطنية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية ولكي تتمكن من مواجهة التحديات المختلفة. كما هو -أي الإصلاح- ضرورة وحاجة للمجتمعات العربية، لأنه هو الذي يخرج الجميع من أتون التناقضات الأفقية والعمودية الكامنة في قاع المجتمعات العربية، وهو الذي يصوغ العلاقة بين مختلف المكونات على أسس الاحترام المتبادل والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ومن المعلوم أن الانغلاق في السلطة سمة من سمات الدولة التسلطية (على حد تعبير خلدون النقيب في كتابه: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر – دراسة بنائية مقارنة).
وهو يعبر عن حالة غير طبيعية في مسيرة الدولة الحديثة، هي حالة التماهي بين السلطة والدولة. لهذا فإن العالم العربي بحاجة إلى أنظمة سياسية حديثة تستجيب لشروط العصر وتتناسب والدينامية الاجتماعية المتدفقة.
4 – إن التجارب والتحولات السياسية الكبرى، تجعلنا نعتقد أن الشيء الأساسي الذي يجعل عمر الدول طويلا وممتدا عبر التاريخ، ليس هو ترسانتها العسكرية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وإنما هو قبول الناس ورضاهم بها. إذ إن كل تجارب الدول عبر التاريخ الطويل تثبت بشكل لا لبس فيه أن حكم الناس بالإكراه، قد يطول، إلا أنه لا يدوم. وإن عمر الدول واستمرارها مرهون بقدرة هذه الدول على تحقيق رضا الناس قبولهم بها. بمعنى أن الدول حتى ولو كانت إمكاناتها البشرية محدودة وثرواتها الطبيعية والاقتصادية متواضعة، إلا أن رضا الناس بها، وقبول الشعب بأدائها وخياراتها، يجبر كثيرًا من نواقص الدولة الذاتية أو الموضوعية، ويمدها بأسباب الاستمرار والديمومة.
فالذي يديم الدول ويوفر لها إمكانية الاستمرار، هو مشاركة الناس في شؤونها المختلفة، واحتضانهم إلى مشروعها، وشعورهم بأنها -أي الدولة- هي التعبير الأمثل لآمالهم وطموحاتهم المختلفة.
وما جرى في تونس ومصر من أحداث وتحولات سياسية سريعة، يؤكد هذه الحقيقة. فكل المؤسسات والأجهزة العسكرية، لم تستطع أن تدافع عن مؤسسة السلطة التي يرفضها الناس ويعدونها معاديةً لهم في حياتهم اليومية وتصوراتهم لذاتهم الجمعية والمستقبلية. لهذا فإننا نحسب أن إسراع الدول في إصلاح أوضاعها وتطوير أنظمتها القانونية والدستورية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية وتجديد شرعيتها السياسية، كل هذه العناصر تساهم في إعطاء عمر جديد لهذه الدول.
فتحريك عجلة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دولنا العربية، أضحى اليوم من الضرورات والأولويات، التي تحول دون دخول دولنا العربية في أتون المشكلات والأزمات التي تعوق من مسيرتها ودورها في الحياة الوطنية والقومية والدولية.
ومن المؤكد أن اقتراب الدول العربية من قيم ومعايير الحكم الرشيد، هو الذي سيعيد الاعتبار إلى المنطقة العربية، وهو السبيل المتاح والممكن اليوم للخروج من عديد من الأزمات والمآزق على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وحده الحكم الرشيد بكل قيمه ومضامينه ومقتضياته، هو الذي سيعيد العالم العربي إلى حركة التاريخ، ودون ذلك ستبقى المنطقة بكل ثرواتها البشرية والاقتصادية بعيدا عن القبض على أسباب التقدم والاستمرار الحضاري.
المحور الثالث : نحو حركة عربية مدنية:
لقد أبانت التطورات والتحولات الكبرى، التي جرت في أكثر من بلد عربي، هو أن مشاكل البلاد العربية متشابهة بعضها مع بعض، وإن الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج تتفاعل وتتعاطف بعضها مع بعض، كما أن آمال هذه الشعوب وطموحاتها السياسية والمدنية متطابقة إلى حد كبير. فالجميع يشعر أنهم يستحقون أنظمة سياسية أفضل مما عليه اليوم، سواء من ناحية نوعية النخب السائدة، أو في طبيعة خياراتها السياسية والاقتصادية، أو تمثيلها لتعبيرات المجتمع المختلفة ومكوناته. فهي -أي الشعوب العربية- تنشد بمستويات مختلفة أنظمة سياسية جديدة تنسجم ومعايير الحكم الرشيد، وهي تتطلع إلى تحسين نوعية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها.
لهذا فإن الشعوب العربية – مع اختلاف في المستوى والدرجة – تعيش مشاكل واحدة، وتتطلع إلى أهداف وغايات متشابهة. كما أن التحولات الأخيرة التي جرت في البلاد العربية تجاوزت بعض المشكلات التي كانت تهدد بعض البلدان في وحدتها الداخلية والوطنية. فجميع الأطياف الدينية والمذهبية والاجتماعية والجهوية، ساهمت في عملية التغيير السياسي، وإنها تكاتفت وتضامنت بعضها مع بعض من أجل تفكيك حوامل الاستبداد السياسي الجاثم على صدور الجميع.
فهذه التحولات أخرجت الجميع من سجون الطائفية والمذهبية والجهوية، وأعلت من شأن الشخصية الوطنية الجامعة. فالملايين التي خرجت في البلدان العربية وتطالب بتغيير أنظمتها السياسية، كانت من جميع الأطياف والمكونات. فالإصلاح السياسي ليس مهمة طرف دون آخر، وإنما هو مهمة الجميع. وإن الاستبداد السياسي بكل متوالياته، هو المسئول الأول عن نزعات التشظي التي سادت في أكثر من بلد عربي تحت عناوين ويافطات دينية أو مذهبية أو قومية أو جهوية.
فالأنظمة السياسية الشمولية هي التي تعمل على تنمية الفوارق الأفقية والعمودية بين المواطنين. وهي التي تعمل عبر ممارساتها وبرامجها المختلفة إلى توتر العلاقة وتأزمها بين أهل الأديان والطوائف والقوميات.
فالتعددية الدينية والمذهبية والقومية الموجودة في العالم العربي، ليست هي المسئولة عن نزعات الاستئصال والتشظي، وإنما المسئول هو النظام السياسي العربي الذي يحتكر القوة والقرار باعتبارات وعناوين عصبوية ضيقة، فتمنح جميع المناصب والامتيازات لفئة قليلة من المجتمع، وتعمل على طرد وتهميش بقية المكونات والتعبيرات. لهذا فإننا نعتقد أن اللحظة العربية الراهنة، من اللحظات الحيوية القادرة على إخراج كثير من الشعوب العربية من أتون الطائفية والمذهبية ودهاليزها، وتدخلها في مرحلة بناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وإن هذه الغاية تتطلب العمل على بناء حركة مدنية عربية، تتجاوز الأطر والعناوين الضيقة، وتعمل على نسج العلاقة بين مختلف المكونات على أسس ومعايير جديدة، تساهم في تعزيز مرجعية الوطن والمواطنة الجامعة. وإن بناء الحركة المدنية العربية هو الذي يديم لحظة الإصلاح بكل أبعادها في العالم العربي، وهو الذي يوفر الإمكانية الحقيقية لمواجهة مخاطر الاستبداد بكل صنوفه.
وكما أن الاستبداد العربي يتعاون بعضه مع بعض، وينسق في مواقفه وخطواته المختلفة، ويتبادل الرأي والخبرة، فإن القوى والمؤسسات المدنية العربية معنية أيضا بهذا الأمر. فهي مطالبة بالتنسيق والتعاون بعضها مع بعض، وبزيادة وتيرة التلاقي وتبادل الرأي والخبرة.
ولعلنا لا نجانب الصواب حين القول: إن بزوغ الهويات الفرعية في العالم العربي، وتعلق المواطنين بها يعود إلى سببين رئيسين وهما: طبيعة علاقة السلطة بمجتمعها ومواطنيها، وهي علاقة غير محايدة تجاه عقائد مواطنيها وقناعاتهم، فتتحول الدولة بمؤسساتها المختلفة إلى سلطة قامعة ونابذة لبعض مكونات مجتمعها؛ فتضمحل علاقة المواطنة لصالح العناوين الفرعية.
والسبب الآخر هو غياب المؤسسات والأطر المدنية التي تتجاوز الانتماءات الفرعية لصالح قضايا ومفاهيم جامعة للمواطنين بعيدا عن انتماءاتهم التقليدية.
وحينما تغيب المؤسسات الجامعة والحاضنة لجميع المواطنين مع احترام تام لعقائدهم وانتماءاتهم التاريخية، حينذاك يبحث المواطن عن مؤسسات أهلية تحميه من تغول الدولة ومؤسساتها، فلا يجد إلا الانتماء التقليدي أو التاريخي بوصفها عنوانًا لحمايته والدفاع عن مصالحه.
لهذا فإن تأسيس وبناء حركة مدنية عربية فاعلة وحيوية، يساهم في الحد من تغول السلطة والدولة في العالم العربي، ومن جهة أخرى تكون رافعة للمواطنين للخروج من آسار انتماءاتهم التاريخية لصالح الانتماء إلى المواطنة التي هي قاعدة الحقوق والواجبات.
فالمطلوب هو إخراج المجتمعات العربية من مستنقع الطائفية والقبلية والعشائرية ،وهذا لن يتأتى إلا بحركة مجتمعية نشطة تتجاوز هذه العناوين، وتوفر البدائل والأطر المتجاوزة لها.
الخلاصة:
إننا ننظر ونتعامل مع التغيرات السياسية الراهنة في العالم العربي، بوصفها تحولات إيجابية، وهي الخطوة الأولى في مشروع التحول نحو الديمقراطية والتخلص من براثن الاستبداد والديكتاتورية ومتوالياتهما. وإن بناء الأنظمة السياسية في عالمنا العربي على أسس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة، سيعزز من حقائق التسامح في المجتمعات العربية، وسيطرد كل الحوامل والثقافات والنزعات المضادة لذلك.
فما يجري اليوم من إصلاحات وتحولات في عديد من الدول العربية، هو بإرادة شعبية عربية بعيدا عن إملاءات الخارج ومؤامراته المختلفة.
لهذا فإننا نستطيع القول: إن العالم العربي اليوم، دخل فعلا وممارسة مرحلة جديدة نتجاوز فيها محن الماضي ومعوقات الواقع الهيكلية. وإن تهاوي بعض الأنظمة المستبدة بشكل سريع، يبشر بهذه المرحلة، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي حجر الزاوية في مشروع الإصلاح والتغيير في العالم العربي.
وإن أمام العالم العربي بكل دوله وشعوبه، فرصة تاريخية، لإعادة بناء أنظمته السياسية على أسس جديدة تنسجم ومنطق العصر وحقائق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
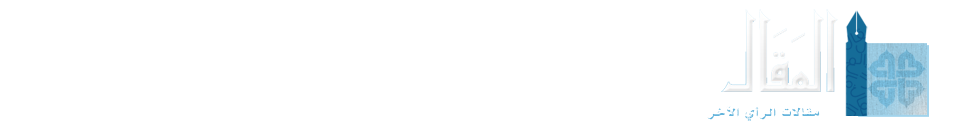











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك