
لماذا فشلت تجربة الإخوان في الحكم
 13 يوليو, 2013
13 يوليو, 2013  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
– 1 –
قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن نؤكد على هذه المقدمة التأسيسية التالية، وهي :
أنه لا جدال، بأن الرئيس المنتخب عبر آلية (الصندوق)؛ يحق أن يكمل مدته القانونية المتفق عليها كعرف ديمقراطي، ولا يجوز خلعه ونزع شرعيته أثناء مدته الرئاسية إلا إذا ارتكب ما يوجب ذلك، مثل خيانة الدستور الذي أقسم عليه ونحوه .. ويكون خلعه عبر الآليات والإجراءات التي يحددها الدستور، حفظا للمسار السلمي ومنعا للسلوك والمظاهر الشعبوية التي قد تقود البلاد إلى الفوضى وربما تقويض العملية الديمقراطية برمتها، وبالتالي فالموقف الذي اتخذه مرسي بالتمسك بحقه في إكمال مدته هو موقف متسق مع العرف الديمقراطي، بغض النظر هل كان مصيبا في موقفه أم لا ؟ وكون الموقف متسقا مع التقاليد الديمقراطية لا يلزم منه أن يكون صحيحا في ذاته وموافقا للمصلحة العامة.
وفي المقابل يحق للشعوب، أن تخرج إلى الشارع في مظاهرات سلمية واعتصامات مدنية تطالب بخلع رئيسها واللجوء إلى انتخابات مبكرة، إذا اعتقدت بأنه لم يلتزم بعهوده معها، أو خان دستورها، أو ارتكب أخطاء كارثية قد تؤدي بالبلاد إلى الدمار والتفكك والانهيار، فهذا أيضا سلوك ديمقراطي صميم، وتكرر في أكثر من تجربة ديمقراطية، وما المعيار هنا سوى قدرة المعارضة أو القوى المدنية الشعبية الناشطة في تحريك الشارع على الحشد الجماهيري للمظاهرات والاعتصامات والقيام بالعصيان المدني الشامل، ونحو ذلك من الوسائل الديمقراطية القادرة على إسقاط رئيسها بصورة سلمية وبعيدة عن العنف والتخريب، علما بأن الشارع عادة لا يتحرك بصورة جماهيرية ضخمة إلا لوجود أسباب تدفعه إلى مثل هذا الخروج، وإلا فلن تستطيع أي معارضة أن تخرج مثل هذا الشارع لمجرد المعارضة فقط.
يبقى هنا .. طريقة حل النزاع بين الطرفين، إذا تمسك كل طرف بموقفه، إذْ لا يمكن أن يبقى الخلاف معلقا .. خصوصا إذا وصل النزاع إلى طريق مسدود، وانعدمت كل آفاق الحلول السياسية، وترتب عليها انقسام شعبي وتوتر في العلاقات الاجتماعية تهدد السلم الأهلي، إضافة إلى تزايد واتساع رقعة الاحتجاجات والاعتصامات، ودخول البلاد فيما يعرف بالعصيان المدني الشامل الذي قد يهدد مؤسسات الدولة بالانهيار .. فالعادة أن الدساتير الديمقراطية في مثل هذه الحالة تحدد القواعد والإجراءات التي يتم من خلالها البت في هذا النزاع .. فإما أن يبادر الرئيس من نفسه بالاستقالة واللجوء إلى الانتخابات المبكرة، أو أن يحتكم إلى الاستفتاء، وإما أن يتم مناقشة شرعيته داخل البرلمان وحسمها بالتصويت من خلال الأعضاء، أو أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية للنظر والحكم في شرعية الرئيس، ونحو ذلك من الإجراءات والقواعد السلمية المتعلقة بفض مثل هذا النوع من النزاع، والتي تختلف بحسب كل دستور.
يكفي هنا أن نضرب مثالا بالرئيس الفرنسي شارل ديغول، حين اندلعت ضده الثورة الطلابية في 1968 وكان يقودها اليسار حينذاك، ومن ضمنهم سارتر ومشيل فوكو وجيل دولوز وألتوسير وغيرهم كثير، لم يكابر ديغول ولم يعاند، ولم يستعن بجماهيريته التي ما زالت حاضرة وكبيرة ويطالبها بالخروج في الميادين، علما بأن ديغول كان زعيما تاريخيا واستثنائيا، ومؤسسا للجمهورية الخامسة وباني فرنسا الحديثة وله الفضل في استقلالها وتحريرها من الجيوش النازية، لم يبرر ديغول شرعيته بكل هذا التاريخ المجيد، بل استجاب بكل تواضع لاحتجاجات الشارع، وتقدم بإصلاحات دستورية لكي تخرج البلاد من الأزمة، وطرحها للاستفتاء الشعبي، والخطير هنا أنه اعتبر ذلك الاستفتاء على هذه الإصلاحات هو استفتاء على شرعيته كرئيس .. مع أنه رئس منتخب ولم تنتهي مدته الرئيسية، وفي اليوم التالي كانت نتيجة الاستفتاء: 52،4% قالوا (لا) و 47،59 % قالوا (نعم)، وبهذا خسر الاستفتاء، وحبست فرنسا أنفاسها لترى ما سيكون قرار شارل ديغول، وبعد عشر دقائق يسمع الفرنسيون والعالم صوت ديغول وهو يقول في بيانه التاريخي: “أُعلن توَقفي عن ممارسة مهامي رئيساً للجمهورية، ويصبح هذا القرار نافذاً عند ظهر اليوم: 29 نيسان 1969”. وساد الصمت والوجوم في فرنسا والعالم، وعندما سألوه .. كيف تفعل هذا وأنت شارل ديجول محرّر فرنسا من الفوهر النازي .. فأجاب: “لوكنتُ ملاكاً فمن حق الشعب الفرنسي أن يأتي بشيطان يحكُمه”. وقال : “أتيت إلى الحكم بإرادة الشعب، وأتركه الآن بإرادة الشعب”. لم يقل بأن نصف الشعب معي، ولم يقل “أنا مستعد أن أدفع دمي ثمنا للشرعية” .. مات ديغول تاركا وصيتين : الأولى .. ألا يحضر جنازته رؤوساء ولا وزراء ولا سياسيون .. والثانية : ألا يكتب على قبره سوى (شارل ديغول).
ما الذي أريد أن أصل إليه من خلال الشرح السابق ؟
ما كنت أريد قوله .. أنه لا يصح المزايدة هنا على الإيمان بالمبادئ الديمقراطية بين الطرفين .. فالرئيس المنتخب إذا كان يعتقد بأن الشرعية ما زالت بيده، فمن حقه أن يطالب بإكمال مدته الرئاسية التي يحددها الدستور، كعرف ديمقراطي، وفي المقابل يحق للشعوب أن تحتج وتطالب بخلع رئيسها المنتخب متى ما رأت بأنه ارتكب ما يوجب خلعه، ولا يصح التشكيك بأن تلك الجماهير لا تؤمن بالتقاليد الديمقراطية، أو أنهم إنقلابيون، ما دام أنهم يحتجون سليما ويطالبون بذات الإجراءات الديمقراطية المتعارف عليها، ومنها كالانتخابات المبكرة أو الاستفتاء .. وبغض النظر عن كل شيء، يبقى الشعب هو مصدر السلطات .. وهو صاحب الولاية من حيث الأصالة .. ومن حقه أن ينزع توكيله للرئيس، ولو في أثناء مدته الرئاسية، متى ما رأى أن ذلك الرئيس لم يعد صالحا للحكم .. وإذا انقسم الشعب على نفسه في هذا الأمر، فلا يمكن جبر الانقسام إلا بالاستفتاء أو بالانتخابات المبكرة.
ثم إن الشرعية ليست كتلة جامدة تأتي جملة وتذهب جملة، وإنما هي أشبه بالنار التي تزيد وتنقص، وقد تخفت شيئا فشيئا إلى أن تنطفئ نهائيا، فحينها لابد من تجديدها والتأكيد عليها عبر اللجوء إلى الاستفتاء، أو الانتخابات المبكرة، فإما أن تعود الشرعية إلى الرئيس الحالي ولكن بقوتها المشتعلة، أو تذهب إلى رئيس آخر ..
وهذا يعني أن محاولة التفاضل بين الموقفين لا يكون عبر المرجعية الديمقراطية، فكلا الموقفين كما قلنا متسق معها .. أما مسألة ما هو الأفضل سياسيا والأقرب للصالح العام ؟ فهذا أمر آخر ..
شخصيا كنت أتمنى أن يكمل مرسي مدته في الرئاسة ويتم إسقاطه عبر الانتخابات بعد أن يتم استيفاء مدته الرئاسية، لأجل ترسيخ مبدأ (تداول السلطة) في الثقافة السياسية العربية .. ولكن يبدو أن الشارع المصري أو جزء كبير منه أو نصفه على الأقل، لم يعد يحتمل الأخطاء التي ارتكبها مرسي وأدت إلى الانقسام والاحتقان والتدهور الاقتصادي في غضون سنة واحدة ! فكيف سيكون الحال بعد سنتين ؟ أو بعد ثلاث ؟! هكذا نظر المحتجون الذي خرجوا في 30 يونيو بالملايين التي أذهلت العالم وصدمت الإسلاميين، ويصح أن تسمى بالموجة الثورية الثانية من ثورة 25 يناير.
– 2 –
لكن .. في اليوم التالي من 30 يونيو، تفاجأ الجميع : الإخوان والمعارضة والثوار وعموم الشعب، بالبيان الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة، والذي حدد فيه مهلة 48 ساعة، لجميع الأطراف المتنازعة لكي تحل خلافاتها السياسية، وإلا فإن القوات المسلحة ستطرح خارطة مستقبل يشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية ومنهم الإخوان ..
هنا أصبحنا أمام معادلة سياسية جديدة .. لم تعد المعادلة بين طرفي السلطة والمعارضة كما كانت، وإنما أصبحت معادلة بين القوى المدينة والعسكر .. وهذا منعطف يجعل التجربة الديمقراطية برمتها في خطر! وأنه قد يحدث انقلاب عسكري إذا لم يتم حل الأزمة سياسيا .. هنا حصل الارتباك الشديد في المشهد السياسي، وتعقدت الأمور أكثر فأكثر .. وبما أنه لم يعد هناك فرصة للحلول السياسية، ولم يعد ثمة مجال لأي حوار في ظل مدة قصيرة لا تتجاوز 48 ساعة؛ فإن حل الأزمة أو بالأصح (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) لن يكون إلا بالموافقة على الانتخابات المبكرة ..
صحيح أن الجماهير التي خرجت يوم الأحد بقيادة حركة (تمرد) وبقية القوى الثورية الشبابية والأحزاب السياسية سواء الإسلامية والعلمانية، لم تطالب بالتدخل العسكري في حل النزاع السياسي وإنما طالبت الرئيس بالانتخابات المبكرة، ولكن حين صدر البيان العسكري استقبلته قيادات المعارضة بالموافقة الصريحة – للأسف – أو باتخاذ موقف ضبابي متردد يميل إلى الموافقة .. لا أتحدث هنا عن رموز النظام السابق أو إعلام الفلول، فهؤلاء فرحتهم واستبشارهم بالتدخل العسكري مفهوم، ولكني أتحدث عن رموز المعارضة والقوى الثورية الشبابية الذين ما زالت دماء أبنائهم وإخوانهم ملطخة بأيدي الشرطة والعسكر منذ ماسبيرو ومحمد محمود وانتهاء ببور سعيد.
وأما الإخوان فقد كانوا بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يقطعوا الطريق على العسكر، ويحافظوا على مسار الديمقراطية من خلال اللجوء إلى الانتخابات المبكرة، تحت إشراف دولي وقضائي وإعلامي وحزبي، وتكون إدارة المرحلة الانتقالية عبر حكومة تكنوقراط مستقلة يتم التوافق عليها من جميع الأحزاب بعيدا عن سلطة العسكر .. وإما أن يرفض الإخوان هذا المسار الديمقراطي، وبالتالي يفتحوا الباب للانقلاب العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية في ظل قوانين وأحكام استثنائية مفروضة.
يبدو أن الإخوان فضلوا الانقلاب العسكري على المحافظة على المسار الديمقراطي، لأن رأوا أن اللجوء إلى الانتخابات المبكرة، فيه اعتراف صريح بفشلهم في إدارة الحكم، الأمر الذي سيزيد من مستوى شعبيتهم، التي هي منخفضة من الأساس، وستكون فرصهم ضئيلة أو معدومة في أي انتخابات قادمة، بخلاف الانقلاب العسكري الذي سيحوّل صورتهم من صورة القيادة الفاشلة التي يجب خلعها إلى صورة القيادة المظلومة التي انتزعت منها شرعيتها بقوة العسكر، وبالتالي لن يتذكر أحدٌ أخطاء وكوارث الإخوان التي ارتكبوها أمام إشكالية وخطورة الانقلاب العسكري.
الخلاصة .. أن المشهد السياسي كان محكوما بين انتهازية المعارضة التي استغلت تدخل العسكر لحسم النزاع لصالحهم، وبين انتهازية الإخوان التي فضلت الانقلاب العسكري على خوض الانتخابات المبكرة التي لن تكون في صالحهم.
ولا يصح هنا – في نظري – الاحتجاج بوجود مخططات ومؤامرات مبكرة لأجل إسقاط الرئيس، فالمؤامرات ضد الثورة لم تتوقف منذ 25 يناير، فهي ليست واقعا جديدا، وبالتالي ليست هي جوهر الإشكال، إنما جوهر الإشكال يكمن في الفشل السياسي الذي خلق واقعا هشا وضعيفا ومفككا يسمح لأتفه المؤامرات ومن أضعف الجهات وأصغر الدول لكي تؤثر وتعبث فيه. (الإشكال ليست في المؤامرات وإنما في قابليتك لهذه المؤامرات).
ثم إن خلع الرئيس مرسي قد أعلنه غير واحد من نشطاء الثورة قبل أن تنشأ حركة (تمرد)، وتحديدا بعد واقعة الاتحادية، وكذلك مطلب الانتخابات المبكرة طالب به بعض الشخصيات السياسية قبل أن تطالب به حركة (تمرد)، كعبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد يسري سلامة رحمه الله وغيرهما. فالمؤامرات لم تخترع هذا المطلب، بل كان مطروحا في المشهد السياسي منذ أشهر، ثم إن الجماهير الضخمة التي ملأت الميادين وأذهلت العالم في 30 يونيو، لا يمكن أن تخرجها تلك المؤامرات، المعارضة أضعف من أن تخرج تلك الملايين، وإنما الذي أخرجها واقع سياسي فاشل لابد أن يتغير .
حتى مع كل ما قيل عن حركة (تمرد) والجهات التي تقف وراءها، يبقى السؤال الجوهري : لماذا خرجت تلك الملايين الحاشدة في الشوارع ؟ ما الذي جعل كل القوى الثورية والأحزاب السياسية تقف مع الشارع وضد الرئيس ؟ ما الذي قسّم الشعب إلى قسمين : مؤيدين ومعارضين ؟
يجب على الإخوان أن يجيبوا عن هذه الأسئلة بكل شجاعة وشفافية، وأن ينقذوا الشارع المصري من الانقسام إذا كان (بقاء مرسي في الحكم) هو سبب واستمرار هذا الانقسام !
– 3 –
نقطة أخرى .. أحب أن أشير إليها، وهو أنه لا بد من التمييز بصورة واضحة، بين الديمقراطية المستقرة والراسخة بمؤسساتها الدستورية القائمة، وبين المرحلة الثورية الانتقالية نحو بناء الديمقراطية .. لا يصح إطلاقا قياس الفضاءات الثورية الانتقالية بالفضاءات الديمقراطية المستقرة . هذا الأمر الذي لم يدركه الإخوان في إدارتهم للحكم، الإخوان بمجرد أن أصبحوا أغلبية برلمانية ثم بوصول مرشحهم إلى سدة الحكم، خلعوا قمصانهم الثورية مباشرة ولبسوا قمصان السلطة، وكأنهم يحكمون في دولة كالنمسا أو النرويج أو فرنسا أو أمريكا، نسوا بأنهم ما زالوا في مرحلة ثورية لم تنتهِ، تحكمها قواعد (استثنائية) مختلفة تماما عن قواعد الديمقراطية المستقرة، خصوصا أن النظام السابق لم يسقط بعد، بل بقي يتحكم بمفاصل الدولة، وفلوله منتشرة في الإعلام والقضاء والداخلية وربما الجيش، فالحديث عما يسمى بـ (شرعية الصندوق) في مثل هذه الحالة الثورية لا يخلوا من تسطيح أو تزييف، فالشارع ما زال هو الأقوى وهو الحَكَم وله المرجعية في ظل الفضاءات الثورية .. نعم لابد من الصندوق في حسم بعض الخيارات أثناء المرحلة الانتقالية .. وهذا أمر طبيعي .. ولكن هذا الصندوق بلا شارع ثوري وجمهور حاشد لا يفيد شيئا!
يكفي أن ندرك أنه لولا انحياز القوى الثورية في التصويت لمرسي في الانتخابات الرئاسية، لعاد النظام القديم مجددا من خلال مرشحه (شفيق) وعبر (الصندوق) .. هنا تظهر إشكالية الصندوق في ظل مرحلة ثورية لم يحصل فيها بعدْ إسقاط للدولة العميقة بصورة كاملة، ولم يطبق فيها نظام العزل بصورة عادلة وحاسمة.
هل معنى ذلك، أن تتحول الثورة إلى حالة قمعية متوحشة تحت شعار تطهير الدولة من فلول النظام؟
لا .. ليس هذا هو المقصود .. لا يمكن أن تصبح الثورة عدوة للإنسان وهي خرجت لأجل الإنسان .. لا يمكن أن تكون منتهكة للحقوق الأساسية وهي خرجت لأجل تلك الحقوق، بل بمجرد أن تتجاوز الثورة تلك المبادئ والقيم فإنها تتحول إلى حالة استبدادية جديدة .. إذاً ما هو المطلوب ؟ المطلوب هو إكمال الثورة من خلال الاستمرار في إسقاط أركان النظام المتحكمين بمفاصل الدولة والإعلام، وإبعادهم عن تلك المناصب والدوائر المؤثرة، وعزلهم عن المشاركة في الحياة السياسية ولو لفترة معينة يحددها (نظام العزل) وفق قوانين تحقق ما يسمى بـ (العدالة الانتقالية) حتى يستقر النظام الديمقراطي الجديد. هكذا تنجز الثورات أهدافها التي خرجت من أجلها.
إشكالية الثورة المصرية، أن القوى السياسية دخلت في بناء الديمقراطية وهي لم تنجز ثورتها بعدْ، بل وأخذت تستنزف جهودها في حروب فكرية متعلقة بالثقافة والهوية، وكأنهم سيبتدعون هوية وثقافة جديدة للشعب المصري، ثم انخرطت تلك الأحزاب السياسية في اللعبة التنافسية وهي لم تتفق بعد على ميثاق للقواعد والمبادئ التي يتم من خلالها إدارة النزاع والخلاف، والأخطر من ذلك أنهم يتنافسون على دولة لا يملكون منها سوى 50% على أكثر تقدير، والبقية ما زال تحت تحكم النظام السابق، والمضحك والمحزن في نفس الوقت أن تنقسم الثورة وتتحول إلى سلطة ومعارضة ولم يتأسس النظام الديمقراطي بعد، في حين أن المفترض تكون السلطة للثورة في المرحلة الانتقالية، والمعارضة هي فلول النظام السابق ..
لقد كان الفلول والجيش هما المحور الثابت في المرحلة الانتقالية، وأما الثورة (السلطة/ والمعارضة) كانا هما العنصران المتغيّران، فمرة تتحالف السلطة مع الفلول والجيش ضد المعارضة، ومرة تتحالف المعارضة مع الفلول والجيش ضد سلطة الإخوان.
الذي أريد أن أؤكد عليه، أن الثورة لا تنتهي بإسقاط شخص واحد كان رئيسا للنظام، وإنما يجب عليها أن تستكمل إسقاط وهدم أركان وعناصر هذا النظام، أو أن يتم على الأقل التفاوض والمساومة مع رموزه لأجل القطيعة مع الماضي وإشراكهم نحو الانتقال إلى فضاء ديمقراطي جديد. وهناك تجارب ثورية لم تستطع إزاحة النظام السابق بالكلية، فانتقلت إلى الديمقراطية عبر التفاوض والمساومة مع رموز النظام السابق الذين لم يثبت في حقهم جرائم ضد الشعب.
ولكن المهم هنا .. أنه لا يصح أن ينفرد حزب أو جماعة معينة بالقيام بتلك المهمة السياسية، دون إشراك القوى الثورية الأخرى التي خرجت وأيدت وثارت على النظام السابق بحجة أن تلك الجماعة أو ذلك الحزب فاز بالأغلبية من خلال نتائج الصندوق !! هذا المنطق ليس صحيحا في الحالة الثورية أو في المراحل الانتقالية، لأن الانفراد في إدارة المرحلة الانتقالية مظنة للاستبداد والطغيان، وربما قد يتم خطف الثورة وسرقة إنجازاتها لصالح ذلك التيار أو ذلك الحزب بحجة أنه فاز بالأصوات عبر الصندوق .
إن المهمة الأساسية والأولية والجوهرية للرئيس المنتخب في المرحلة الانتقالية هو توحيد القوى الثورية والمدنية والسياسية تحت مبدأ (المشاركة لا المغالبة) لمواجهة ما يعرف بـ (الدولة العميقة) ومحاولة إسقاطها أو التفاوض معها. لا أن ينفرد لوحده بهذه المهمة ويعطي ظهره لرفاق الثورة!
هذا باعتقادي كانت مشكلة الإخوان في إدارتهم للحكم في المرحلة الانتقالية .. نعم كانت هناك دعوات للحوار ، ولكن يبدو أن تلك الحوارات لم تكن سوى مظاهر سياسية للتجميل وتحسين الصورة أكثر من كونها حوارات جوهرية حقيقية مبنية على الرغبة في التوافق والمشاركة عبر تنازلات حقيقية.
لا أريد أن أستثنى المعارضة من تحمل مسؤولية الفشل، فالمعارضة لم تكن أحسن حالا من السلطة، إن لم تكن أسوأ، فسلوكها السياسي كان قائما على الانتهازية السياسية في استغلال فشل الحكومة لمحاولة إسقاطها أو إسقاط الرئيس بأي وسيلة، ولو على حساب الوطن واستقراره واحتياجات رجل الشارع البسيط. بل وصل الأمر ببعض رموزها أن يستدعي الجيش ويطالبه بالتدخل في العملية السياسية، أو يستنجد بالدول الغربية لإنقاذ الديمقراطية من تسلط واستبداد الإخوان كما يقول.
لم تكن المعارضة في غالبها تسعى لمعاجلة الأزمات بقدر ما كانت تستغلها وتستثمرها لأجل إفشال السلطة والإطاحة بها. قد نفهم هذا السلوك في ظل ديمقراطية مستقرة، قواعدها ثابتة ومؤسساتها الدستورية محايدة، لكن لا يمكن أن نفهم هذا في ظل مرحلة انتقالية تستوجب المشاركة والمعاونة لإنجاز بناء الديمقراطية، ولكن يعود السؤال المشكل مرة أخرى: كيف تحصل المشاركة والمعاونة والسلطة الحاكمة قد انفردت واستبدت بإدارة المرحلة الانتقالية بحجة أنها فازت بنتائج (الصندوق).
– 4 –
نقطة أخرى، متعلقة بالجيش وعلاقته بالدولة المصرية .. لم يكن في الحقيقة دور العسكر شيئا طارئا أو مستجدا بعد ٣٠ يونيو، فهم كانوا متغلغلين في مفاصل نظام مبارك قبل ثورة يناير، وتعزز وجودهم في الاقتصاد المصري وفي إدارات الحكم المحلي والمؤسسات التابعة للدولة خلال العقدين الأخيرين، ثم خرجوا من الظل إلى النور بعد ٢٥ يناير، وأصبحوا يتحكمون ويحكمون بشكل مباشر ويديرون المرحلة الانتقالية، فالحكم لم ينتقل بعد إسقاط النظام إلى الثوار، وإنما انتقل إلى العسكر. ومع صعود الإخوان للحكم لم يغب العسكر عن المشهد، وكانت سياسة الإخوان هي التفاهم معهم على تقاسم النفوذ وبقاء قدرتهم على إدارة ميزانيتهم بشكل مستقل بعيداً عن المساءلة البرلمانية، وهو ما تقرر في الدستور الذي دافع عنه الإخوان باستماتة، إضافة إلى بقاء دورهم في صناعة السياسات الخارجية وصون اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقد تمت هذه التفاهمات بين الإخوان والعسكر برعاية أميركية، وكان الإخوان يتصورون أنهم بإدارة ظهرهم للقوى الثورية والتحصن بهذا التفاهم يمكنهم أن يحكموا ويتمكنوا في الدولة بارتياح، لكن العسكر عاد وانقلب عليهم، فيما تركهم الأميركيون لمصيرهم. (انظر: ورقة معهد كارنيغي، بعنوان، فوق الدولة: جمهورية الضباط في مصر).
وما يمكن أن نستنتجه هنا، أن العسكر لم يغيبوا عن المشهد السياسي ليعودوا إليه، وأن وجودهم كحَكَم مرجح بين الأطراف، سببه النزاع الحزبي بين القوى الثورية، وإعلاء هذا الأمر على على أولوية إسقاط قوى النظام القديم، والإخوان الذين يشتكون من العسكر اليوم هم من ثبت دورهم بهذا الشكل في المعادلة السياسية.
لا أعتقد بأن العسكر يرغبون في التمسك بالحكم، لأنهم لا يستطيعون ذلك، فالمشهد السياسي معقد جدا، والمؤسسة العسكرية ليست قادرة على تحمل تبعاته، وقد جربت ذلك بعد الثورة خلال سنة ونصف .. العسكر يريدون أن يتحكَّموا لا أن يحكموا، والتحكم عادةً لا يلزم منه إدارة الحكم .. إشكالية الجيوش في ديمقراطيات العالم الثالث، أنها عادةً تكون محتفظة باستقلالها وانفصالها عن سلطة مؤسسات الدولة، أي مستقلة عن مساءلة البرلمان وسلطة الرئاسة أو الحكومة .. نعم هو لا يريد أن يتدخل بإدارة الحكم المحلي، ولكن في نفس الوقت لا يريد لمؤسسات الدولة أن تتدخل في إدارته، ولا شك أن هذا إشكال كبير، وقد يهدد الديمقراطية، ولابد من معالجته، لأن هذا الجيش في نهاية الأمر هو جيش الأمة، والأمة هي صاحبة السيادة، وسيادتها لا ينبغي أن تكون منقوصة أو مستثناة، الأمة هي المتحكمة بجيشها عبر ممثليها في البرلمان، أو عبر رئيسها المنتخب!
ولكن معالجة هذا الإشكال، قد يأخذ وقتا من الزمن، وإذا كان الجيش يتسم على قدر لا بأس به من الوطنية والمهنية كالجيش المصري مقارنة ببعض الجيوش العربية، فمن السهل معالجة وضعه خصوصا إذا قويت وترسخت مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرئاسية، وقويت أيضاً وتجذرت مؤسسات المجتمع المدني، حينها يصبح الجيش أمام مؤسسات لا تقل عنه قوة وتأثيرا.
– 5 –
الآن .. وبعد الانقلاب العسكري وعودة الجيش مرة أخرى إلى المشهد السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية .. فما هو الحل إذن ؟
الحل في اعتقادي، هو أن تتحمل القوى الثورية والأحزاب السياسية ومنهم الإخوان وأنصارهم، مسؤوليتهم التاريخية أمام ثورة 25 يناير، فيتجاوزوا الماضي، ويحاولوا أن يوجدوا حالة جديدة من التوافق، تجعلهم في جبهة واحدة لمواجهة هيمنة العسكر، أو لمواجهة ما يسمى بـ (الدولة العميقة).
ليس الحل في أن يستمر الإخوان في اعتصاماتهم للمطالبة بإعادة الرئيس كما يحصل الآن، يجب أن يتجاوزا هذه المسألة، وينخرطوا ويندمجوا مع القوى الثورية لمواجهة العسكر والفلول، والضغط عليهم لإنهاء المرحلة الانتقالية بصورة جدية وفق الجدول المرسوم، حتى يعود العسكر إلى ثكناتهم.
إذا كانت المعركة الآن كما يدعي الإخوان وأنصارهم بأنها ليست بين الإخوان والمعارضة، وإنما بين الديمقراطية والعسكر، فعليهم إذن أن يتجازوا مسألة إعادة مرسي للحكم، لأن هذه المسألة هي سبب الانشقاق والانقسام في الشارع الثوري، وليجعلوا قضيتهم هي مواجهة العسكر وإنهاء المرحلة الانتقالية. أما محاولة الادعاء بأن المعركة قد أصبحت بين الديمقراطية والعسكر، وفي نفس الوقت يطالبون بإعادة الرئيس المعزول، حينها يمارسون تزييفا دعائيا لن يخدم معالجة الأزمة والانقسام الحاصل، إلا إذا تم التوافق مع القوى والأحزاب السياسية على صيغة حلّ معين يتم من خلالها إعادة المشهد إلى ما قبل الانقلاب، بحيث يعود مرسي إلى قصر الرئاسة، شريطة أن يعلن عن استفتاء شعبي على بقائه، أو يعلن عن استقالته ثم الانتخابات المبكرة بحسب التوافق.
ولكن على أية حال .. لا يمكن أن يتم أي توافق سياسي، قبل أن تتوقف سياسة الاعتقالات والقمع والإقصاء والانتهاكات والشيطنة الإعلامية الممنهجة التي تتعرض له جماعة الإخوان وأنصارهم، يجب أن يتوقف كل هذا من حيث المبدأ، سواء وافق الإخوان أن ينخرطوا مع القوى الثورية لمواجهة العسكر وإنقاذ الديمقراطية، أم بقوا في معسكرهم المطالب بعودة الرئيس المعزول!
خاص بموقع “المقال”.
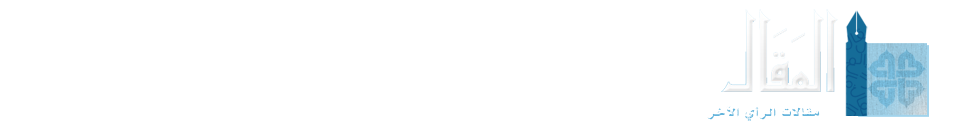











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك