
حمزة كاشغري..دروس الحرية
 4 فبراير, 2013
4 فبراير, 2013  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
لعل قضية حمزة كاشغري وتداعياتها شكلت منعطفاً في تاريخ النقاشات الفكرية في المجتمع السعودي، إذ إنها فتحت الباب واسعاً لنقاشٍ أبعد من موضوع الشاب المعتقل منذ سنة والتغريدات التي كتبها، نقاشٌ يتعلق بشكل رئيسي بحرية التعبير والاعتقاد، وبالربط بينها وبين الديمقراطية والحرية السياسية، ويبدو الوقت ملائماً للعودة إلى رؤية الموضوع من هذه الزاوية والحديث عن الدروس التي يمكن الخروج بها من ما بات يُعرف بـ”قضية حمزة كاشغري”.
أول درس يتبادر إلى الذهن بعد المعركة الصاخبة هو وجوب التصدي لمحاولات استعداء السلطة على أشخاص أو توجهات معينة، وتحريضها على قمعهم وتصفيتهم، وبخلاف أن هذا الأسلوب مناوئ لمبادئ الديمقراطية والحريات، فإنه يرتد على أصحابه، فمن قاموا بالتحريض على المختلفين معهم شرعنوا ضمنياً تحريض الآخرين عليهم، وكرّسوا القمع بدلاً من القانون الضامن للحريات حكماً بين الأطراف المختلفة فكرياً.
كما أن الحديث عن الإصلاح السياسي لا يتفق أبداً مع استعداء السلطة على المختلفين، إلا إذا كان هذا الإصلاح السياسي لا يعني في نظر المحرِّضين أكثر من إشراكهم في تنفيذ سياسات الاستبداد وتمكينهم من استخدام أدوات الدولة في قمع مخالفيهم وإقصائهم، وهكذا بات لزاماً التأكيد على التمايز بين الإصلاح السياسي الرامي إلى إيجاد بيئة ديمقراطية تضمن حرية التعبير والاعتقاد وبين شعارات الإصلاح التي ترمي إلى دفع الدولة باتجاه إيجاد سياسات استبداد “مطورة” هدفها النهائي نصر فريقٍ على الآخرين، ولم يعد الاحتجاج بأهمية توحيد الصفوف في معركة الإصلاح السياسي نافعاً في رفض إيجاد هذا التمايز، إذ إن معركة الإصلاح السياسي لا يمكن أن تبنى على ضبابية في الرؤية والمفاهيم، ولا يمكن بناء حالة إصلاحية حقيقية وفاعلة دون توضيح تفصيلي للمفاهيم التي تتبناها وموقفها من الحريات وتصورها للديمقراطية.
درس آخر قديمٌ/متجدد مفاده أن الشعار الديني الذي تم استخدامه في قضية حمزة هو أداة لتحقيق أهداف سياسية، والاعتقالات التي طالت تركي الحمد ورائف بدوي تشهد بالتوجه لتثبيت منطق القمع عبر دغدغة المشاعر الدينية، ومنطق القمع هذا لا يستثني أحداً، لكن أحد ألعابه المفضلة اللعب على التناقضات الفكرية واستغلال المشاعر الدينية بالظهور بمظهر “حامي الدين والعقيدة” بينما لا تتجاوز المسألة حماية الاستبداد وتكريسه. إن قراءة الأحداث والتطورات التي تلت قضية حمزة على مدار سنة كاملة تقود إلى هذه النتيجة، وهو ما يعني أنه من الضروري محاربة استغلال مشاعر الناس الدينية في تحقيق أغراض سياسية، وكشف كذبة “حماية العقيدة”.
ويبقى الدرس الأهم ضرورة الدفاع عن حرية التعبير والاعتقاد، ويشمل هذا بالطبع قضايا الإيمان والكفر، فالاعتقاد بأي معتقد والتصريح به علانية يدخل في هذا النطاق، وحرية الاعتقاد هذه لا علاقة لها بشتم المقدسات كما قد يتوهم البعض، أو كما يحاول البعض أن يوحي بذلك في محاولة لشيطنة مفهوم الحرية، فشتم المقدسات مرفوض في أكثر الدول ليبرالية في العالم، حيث يُعد إساءة لذوات الأشخاص الذين يُجلّونه، ورفض شتم المقدس هنا جزء من تقييد حرية التعبير بضابط عدم التعدي على الآخرين وإيذاءهم مادياً أو معنوياً. يمكن الحديث بتوسع حول مفهوم المقدس في سياقنا الاجتماعي، والاختلاف حول توسيع المفهوم أو تضييقه (وهو أمر يحتاج إلى تفصيل قانوني أيضاً)، لكن القاعدة الأساسية التي يتبناها دعاة الحرية والديمقراطية تقول بأن حرية التعبير هي الأصل، والتقييد استثناء، ولا يمكن فهم التركيز على الاستثناء في غياب الأصل إلا كضربٍ من ضروب العبث، أو كمحاولة لإعلاء منطق القمع بتحويل الاستثناء إلى أصل. إن المطلوب هو التركيز على حرية التعبير والاعتقاد التي هي الأصل، وترسيخها في الوعي العام والمطالبة بقوانين تحميها وتعززها، وبعد أن يتم ذلك يمكن للنقاش حول الضوابط والقيود أن يكون منطقياً ومفهموماً (وهي القيود التي لا يجب أن تقوض حرية التعبير أو تفرِّغها من مضمونها بالطبع).
ليست المشكلة فيما يخص مفهوم حرية التعبير والاعتقاد محصورة فقط في من يحاسب الناس على اعتقادهم ويطالب بمعاقبتهم على آرائهم، لكنها تشمل أيضاً من يستخدم الخطاب الاعتذاري في مواجهة حملات التفتيش في الضمائر، فهذا الخطاب حين يحاول التأكيد على توبة فلان أو الشهادة لفلان بأداء الصلاة مثلاً فإنه يسلم ضمنياً بمشروعية عمل “محاكم التفتيش العقائدية” وحقها في مساءلة الناس حول عقائدهم يما يتنافى مع حرية الاعتقاد، فبدلاً من الحديث الصريح حول حق الناس في اعتناق ما يرونه مناسباً لهم، يدخل النقاش إلى تفاصيل حياة الأشخاص “المتهمّين” لإثبات أنهم لم يتبنوا معتقداً “منحرفاً”، وهذا يؤكد الإخفاق في فهم حرية التعبير والاعتقاد وخوض معركتها كما ينبغي.
إن محاولة الفصل بين الحرية الفكرية والحرية السياسية عبر التركيز على الثانية وتجاهل الأولى يوقع البعض في إشكال على مستوى الخطاب المبشّر بالديمقراطية والحريات، فالحرية السياسية من وظائفها أن تكون ضمانة للحريات الفردية وحرية التعبير، ولا يمكن تخيل حالة ديمقراطية لا تؤكد على الحريات والحقوق المدنية، وهنا لابد من التأكيد على الحريات والحقوق المدنية كجزء لا يتجزأ من الخطاب الإصلاحي الديمقراطي، وأي حالة إصلاحية تدعو للديمقراطية وتتجاهل هذا الأمر لحسابات جماهيرية أو ما شابه تقع في تناقضٍ يصعب تبريره مع المبادئ التي تروج لها بما يؤثر على مصداقية خطابها.
لا ديمقراطية دون حرية تعبير واعتقاد، ولا إيمان دونها أيضاً، فالتدين المفروض على الناس بالترهيب وهمي غير حقيقي، ويتبخر مع أول فرصة للتحرر من الإجبار عليه، ولا يقدم من يفرضون نمط تدينهم على الآخرين غير تشويه الدين نفسه وتنفير الناس منه. تحكي قضية حمزة كاشغري أهمية حرية التعبير والاعتقاد، وتقدم التحدي لأطياف واسعة من النخب المثقفة السعودية في مقاربة مفهوم الحرية عبر مظلومية شاب صار كبش فداء لتفاهم “الديني” مع “السياسي” على قمع الحرية.
خاص بموقع “المقال”
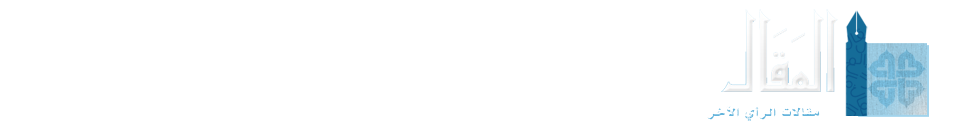











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك