
العميري والعجلان يردان على مقال سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة
 17 نوفمبر, 2011
17 نوفمبر, 2011  لاتوجد تعليقات
لاتوجد تعليقات
توالت ردود الأفعال بعد نشر موقع “المقال” سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة للكاتب عبد الله المالكي، وتنوعت الردود بين معارض ومؤيد لما طرحه المالكي، وحرصاً من موقع المقال على نشر مختلف الآراء في هذا الجدل الدائر ننشر هنا بعض ردود الأفعال التي عارضت طرح المالكي. اخترنا للقارئ نموذجين ناقدين سواءً لفكرة المقال الأساسية أو لما تضمنه المقال من أفكار،وقد تم نشرهما في مواقع إلكترونية أخرى.
ظاهرة المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة
سلطان العميري
يشكل الاستبداد إشكالية من أضخم الإشكاليات التي واجهت الأمة الإسلامية , ولهذا سعى عدد من المصلحين من أبنائها للخروج من هذه الإشكالية بحل يحقق للأمة سعادتها .
ومن الحلول التي ظهرت في الساحة , وبدت تظهر بين الفينة والأخرى , ما يمكن أن نسميه “ظاهرة المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة” .
وصورة هذا الحل تقول : إنه لا سبيل إلى الخروج من تسلط الحكام على الأمة وسلبهم لإرادتها وعبثهم بحياتهم إلا بطريق واحد فقط , وهو استعادة سيادة الأمة , فالحل الوحيد هو أن نسعى إلى استعادة هذه السيادة , ولا يصح لنا أن نطالب بتطبيق الشريعة ونحن لم نستعد تلك السيادة المسلوبة , لأن الشريعة نفسها لا تكون ملزمة للناس ما لم يرضوا بها .. فإلزامية تطبيق الشريعة في الواقع لا تكون إلا بعد رضى الناس , وما لم يرضوا بها فإنا لسنا ملزمين بتطبيق الشريعة .
وأخذ أصحاب ذلك الحل يقولون: إذا أردنا أن نزيل الاستبداد والقهر .. علينا أن نرجع الأمة إلى المربع الأول , ونقول لهم هل ترضون بتطبيق الشريعة أم لا ؟.. وهل تحبون أن نطبق عليكم الشريعة ؟ .. ولو لم نفعل ذلك فنحن لم نفعل شيئا .. بل خالفنا الشريعة نفسها !!
ولست أشك في أن هذه الإشكالية وإشكالية مواجهة الاستبداد المخيم على الأمة منذ زمن بعيد تحتاج إلى بحوث واسعة ومقالات مطولة وجهود مضنية , يتم فيها تناول الموضوع من جهات عديدة ؛ ولكني حسبني هنا أن أثير بعض الإشكاليات التي أرى أن من ينادي بذلك الحل وقع فيها .
ويتلخص ما أريد ذكره في قضيتين :
القضية الأولى : في منطلق الإصلاح السياسي والخطوة الأولى فيه :إن أول خطوة في إحياء النظرية الإسلامية السياسية وأول درجة في تقرير سيادة الأمة على تصرفات الحاكم واعتبار رضاهم ومشورتهم .. هو تخليص الأجواء الفكرية من المفاهيم والمصطلحات العلمانية ونشر المفاهيم والمصطلحات الإسلامية , فواقعنا المعرفي مشبع بتلك المصطلحات التي تنتمي إلى المنظومة العلمانية , وغدت الأذهان لا يتبادر إليها في الغالب إلا المفهوم العلماني .
وليس من المقبول شرعا ولا منهجا أن نعتمد في بناء وتوضيح حقيقة من الحقائق الشرعية على مصطلحات أجنبية عن الفكر الإسلامي , بل لها حمولاتها العلمانية المعروفة والمستقرة في العقل الجمعي لدى كثير من المسلمين ..
وحين تستعمل في بيان أفكارك المصطلحات العلمانية ، ولا تذكر فرقا بين الاستعمالين.. لا تلوم القراء حين يحكمون عليك بما يعرفونه عن تلك المصطلحات… لأن استعمالك ذلك يصبح جزء كبيرا من أجزاء المشكلة .
ولو تأملنا في جهود المصلحين والمجددين نجد أن أكبر وصف يتصفون به هو التعالي على الخضوع للأجواء التي تسبب أصلا في وجود الإشكالية .. والذهاب نحو المنبع الصافي الذي لا يحتاج إلى تعديل أو عمليات تجميل .
ولكن البعض ممن يريد الإصلاح السياسي .. لم يراع هذه الخطوة المهمة .. فأخذ يعتمد في بناء أفكاره على مصطلحات مبهمة وبعضها لها حمولات تطبيقية سيئة , كلفظ الحرية والسيادة والمساواة وغيرها … وهذه الألفاظ كلها محملة بحمولات علمانية , توجب على المصلح الإسلامي أن يتجنبها ويحذر من الوقع فيها , فضلا عن ان يبني عليها تصوراته الإسلامية!!
فلو أخذنا مفهوم السيادة مثلا , فإنا نجد معناه يرجع إلى السلطة العليا الآمرة الناهية للدولة وتكون مرجعية ومصدر لقراراتها , والسيادة بهذا المفهوم مناقضة لأصل الدين , وأنا أعلم أن البعض قد يستعملها بمعنى المصدرية لا بمعنى المرجعية , ولكن ما الذي يحوجنا إلى مثل هذه الأساليب الطويلة الوعرة والملتبسة .
وكذلك أخذ البعض ينطلق من منظومات وافدة تحتاج إلى أسلمة وتحوير حتى تتوافق مع الإسلام ومنظومته .. والغريب أنه يعترف بها .. ويقول إن الديمقراطية تشكلت في الغرب على حسب مرجعياتهم .. ونحن نشكلها في واقعنا الإسلامي على حسب مرجعيتنا ..
وهذا في الحقيقة إقرار بأنها في صورتها الحالية الواقعية تحتاج إلى تعديل وتحوير وأسلمة .
والسؤال الآن : لماذا ننطلق في مشروعنا السياسي الإسلام من مثل هذه المنظومات التي تحتاج أن نبحث في صورتها الموافقة للإسلام .. ونبتعد عن الانطلاق من المنظومة الإسلامية التي اشتمل عليها المخزون السياسي في الشريعة والتي لا نحتاج معها إلى كل هذا العناء .
في تصوري أن هذا ابتعاد عن الخطوة الأولى المؤثرة في مسيرة الإصلاح ونجاحه .
ولا بد من التأكيد هنا أن البحث ليس في أصل الاستفادة من المنتج الإنساني المشترك ولا في التقليل من شأنه ولا في الدعوة إلى الانغلاق على النفس .. كل هذه المعاني غير مقصوده , إنما المقصود هو البحث في منهجية وكيفية الاستفادة من المشترك الإنساني , وهناك فرف بين البحث في أصل الاستفادة وبين البحث في منهجية الاستفادة .
*** *** ***
القضية الثانية : في حل معضلة الاستبداد :
لا يشك مسلم في أن مشكلة الاستبداد تعد من أعظم وأضخم الإشكاليات التي حلت بالأمة الإسلامية . وأنها تسببت في إحداث أضرار كبيرة بالأمة .وهذا الأمر يستوجب استنهاض الهمم في المبادة إلى إصلاح هذا الخلل الضخم.
ولكن أمام هذه الإشكالية اختلفت الحلول :
ومن الحلول المطروحة الآن بشكل مكثف . ما أصبح يمثل ظاهرة قبلية سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .
وقبل تسليط الأضواء على هذا الحل لا بد من شرحه بهدوء وأمانة.
لما رأى البعض استطالة الحاكم على تنفيذ الشريعة وعدم اعتباره لبعض أحكامها , وعبثه بحياة الأمة وأموالها مقدراتها , ووقوفه عثرة في طريق تقدمها , أخذ يقول : إنه لا سبيل إلى الخروج من هذه الإشكالية إلا بطريق واحد فقط وهو استعادة سيادة الأمة , فالحل الوحيد هو أن نسعى إلى استعادة هذه السيادة , ولا يصح لنا أن نطالب بتطبيق الشريعة ونحن لم نستعد تلك السيادة المسلوبة , لأن الشريعة نفسها لا تكون ملزمة للناس ما لم يرضوا بها .. فإلزامية تطبيق الشريعة في الواقع لا تكون إلا بعد رضى الناس , وما لم يرضوا فإنا لسنا ملزمين بتطبيق الشريعة .
وأخذ يقول : إذا أردنا أن نزيل الاستبداد والقهر .. علينا أن نرجع الأمة إلى المربع الأول , ونقول لهم هل ترضون بتطبيق الشريعة أم لا؟ .. وهل تحبون أن نطبق عليكم الشريعة ؟ .. وما لم نفعل ذلك فنحن لم نفعل شيئا .. بل خالفنا الشريعة نفسها !!
وهذا الحل بهذه الصورة .. يبدو لي محملا بأخطاء كبيرة جدا .. بعضها راجع إلى مخالفة أصول الشريعة الإسلامية نفسها , وبعضها راجع إلى انعدام الثمرة فيها , وبعضها راجع إلى الالتباس المتجذر .. وسأقوم بتلخيصها في الأمور التالية :
الخلل الأول : التصوير الخاطئ , وحتى يتبين لنا وجه التصوري الخاطئ , لا بد من التذكير مجددا بصورة الإشكالية الأصلية , وهي باختصار : هناك حكام ظلمة مستبدون سلبوا أمة ( مسلمة , لم يقع التحريف في دينها ) إرادتها وحريتها وعبثوا بممتلكاتها وتحكموا في حياتهم ومعاشهم وأنزلوا بالأمة سوء العذاب , وهم مع ذلك ينتسبون إلى الإسلام .
هذه هي الإشكالية التي تعيشها الأمة بشكل مختصر , ويتضح أن المعارضة الآن هي بين إرادة الحاكم وإرادة الأمة , وموضوع التعارض ليس هو ( أصل ) تطبيق الشريعة نفسها , لأن الأمة دينها محفوظ وكتابها لم يقع فيه التحريف وأحكام دينها واضحة , وفيها علماء يصدعون بالحق صباح مساء , فالأمة لم تفقد أصل تطبيقها لدينها أبدا , وإنما موضوعها تصرفات الحكام وعبثه بحياة الناس ومقدراتهم وأموالهم .
والحل الطبيعي القريب هو أن نقوم باستنهاض همم الأمة الإسلامية بالوقوف ضد عبث الحاكم , ونقوم أيضا بتوعية الناس بحقوقهم , وشرح الحقوق والمساحات التي حددتها الشريعة للحاكم حتى يتعرف الناس على مقدار خروجه عنها , وحتى يمكنهم إلزامه بها ومحاكمته إليه , فالناس إذا عرفوا الحدود والمساحات التي حددتها الشريعة للحاكم سيقومون بمهمة محاكمته إليها تلقائيا .
هذا هو الحل القريب المتبادر إلى الذهن لمن يعيش في بلاد المسلمين , وهو الحل الذي دلت عليه نصوص الشريعة , وهو الحل الذي طبقه الخلفاء الراشدون وأرشدوا الناس إلى تطبيقه , وهو الحل الذي طبقه المسلمون الذين ثاروا على الاستبداد وجور الحاكم , من لدن الصحابة رضي الله عنهم في حادثة الحسين إلى من جاء بعدهم .
ولكن أصحاب حل المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة , قفزوا على هذا الحل , بل قفزوا على الإشكالية نفسها , وبدءوا يصورونها بصورة أخرى مختلفة تماما , وجاءوا بخلطة مركبة من الأفكار لا يستطيع المرء أن يتصورها بسهولة , أخذوا يقولون : إنا إذا أردنا أن نزيل الاستبداد عن الأمة علينا أولا أن نزيل الإلزام عن الشريعة نفسها , ونجعلها خاضعة لإرادة الشعب , لأن الأمة لا يمكن أن تطبق الدين مع الاستبداد , وجعلوا – في بعض فقراتهم – المقابلة بين تطبيق الشريعة وبين سيادة الأمة , ولهذا عبروا بالقبلية , وقالوا سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة .
فالحل – في نظرهم – ليس هو أن نقوم بتوعية الأمة بحقوقها المكفولة لها في الشريعة , ونسعى إلى مراقبة الحاكم , وإنما الحل أن نرجع الأمة إلى مربع آخر ونسألهم هل يرغبون في تطبيق الشريعة أم لا ؟ , وكل حل لا يرجع إلى هذا المربع فهو حل خاسر وقاصر لديهم .
وهذا منطلق خاطئ في تصوير الإشكالية , فالمشكلة ليست في عدم رضى الأمة بتطبيق الدين , وليست في المقابلة بين تطبيق الشريعة وبين إقرار رقابة الأمة على الحاكم , فإنه لا تعارض بين أن نقول بإلزامية الشريعة وتعاليها عن رغبات الناس وبين أن تكون الأمة هي الحاكمة والمراقبة على الحاكم … بل لا نستطيع أن نقرر سيادة الأمة على الحاكم إلا بالاعتماد على إلزامية الشريعة .
فنحن لا نحتاج عن البحث في القبلية والبعدية إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة التعارض. وهنا أتساءل هل هناك تعارض بين تطبيق الشريعة وبين رقابة الأمة على الحاكم؟!
والشيء الذي يعارض رقابة الأمة وسيادتها هو نفوذ المستبد وليس إلزامية تنفيذ الشريعة.
ويزيد من وضوح وضخامة ذلك التصور الخاطئ .. ذلك السؤال الذي بدأ يظهر بشكل مكثف في حواراتنا .. وهو أيهما أحفظ للشريعة وتطبيقها الفرد أو الجماعة ؟!!
وإيراد هذا السؤال بهذه الصيغة غير دقيق , وإنما يصب في إشكالية التصوير الخاطئ .. لماذا ؟! .. لأنه لا ينازع أحد من المسلمين ولا العقلاء في أن العدد الكبير من حيث الأصل أحفظ للشريعة وتطبيقها من الفرد الواحد , ولم يحصر أحد حفظ الشريعة ومرجعية تطبيقها إلا الشيعة الرافضة , حين أرجعوا ذلك كله إلى الإمام أو من ينوب عنه , ولهذا أنكر عليهم ابن تيمية , وبين بأن حفظ الشريعة وتطبيقها ليس موكولا إلى فرد منها ولا حتى أبا بكر وعمر , بل الأمة كلها مشتركة في حفظ الشريعة بعضهم من جهة الحفظ لنصوصها والتفقه في أحكامها وهم العلماء وبعضهم من جهة تطبيق حدودها والدفاع عن حياضها وهم الحكام الأمناء , وبعضهم من جهة المراقبة لتصرفات الحاكم وأعماله وهم عموم الأمة , وبعض الشريعة أصلا مرتبط بكل شخص بمفرده من حيث إلزام التنفيذ..
وكذلك لم يرتبط حفظ الدين وتطبيقه بشخص واحد إلا في الحالة الأوربية المنحرفة , ولهذا ثار عليها الناس .. أما المشهد الإسلامي فإنه لم يشهد ربط حفظ الدين ونقله وفهمه وتطبيقه بشخص واحد إلا ما وجد في الفكر الشيعي فقط ..
فإثارة السؤال بتلك المقابلة خاطئ ولا يصح أن يرد إلا على الفكر الشيعي الإمامي .. أو الفكر الأوربي المنحرف … أمام عموم الأمة فلا يصح أن يرد عليهم السؤال .
أرأيتم وجه التركيب الخاطئ لهذه القضية وإدخال قضايا في بعضها من غير مبرر؟!! .
الخلل الثاني : الالتباس الغارق , الذي يحاول أن يقرأ ذلك الحل بهدوء ويقوم بتحليل وإعمال الفكر فيه يجد فيه التباسا كبيرا أحدث خللا واضحا في تركيبة الحل وانتهى به إلى التناقض , ووجه ذلك : يظهر في معنى سيادة الأمة : يقوم ذلك الحل على أن تطبيق الشريعة لا يكون إلا بعد رضى الأمة , وأن الأمة ليست ملزمة بتطبيق الشريعة عليها ولا على واقعها إلا إذا رضيت بذلك فإن لم ترض أو سلبت إرادتها فهي غير ملزمة .
وفي إثناء النقاش والمطالبة بالتوضيح : يظهر لك معنى آخر , وهو أن الشريعة لا يمكن أن تطبيق نفسها بنفسها وإنما لا بد لها من أناس يطبقونها , وبالتالي فالأمة هي السيدة على تطبيق الشريعة , وسيادتها مقدمة على تطبيقها .
وهذا التصوير ليس صحيحا .. وهو يوقع في الالتباس , لأن كون الشريعة لا يمكن أن تطيق نفسها بنفسها أمر بديهي لا يخالف فيه كل عاقل , فالذين يقولون بإلزامية تنفيذ الشريعة يقولون كذلك : إن الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها وإنما لا بد من امتثال الناس لها.
ونحن إذا رجعنا إلى المعاجم والمصطلحات نجد لفظ السيادة يطلق بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني .. بل حتى في لغة العرب لا يطلق لفظ السيادة على الاحتياج للتنفيذ ..
فقرارات الأب في البيت لا تنفذ نفسها بنفسها وإنما هي محتاجة إلى من ينفذها من الأولاد وغيرهم .. ولا يقول أحد إن هذا الاحتياج يجعل الأولاد لهم السيادة على قرارات الأب .
وهذا الالتباس يجعل القارئ الذي يريد أن يفهم القول كما هو يجد صعوبة كبيرة , لأنه تارة يستعمل معنى صحيحا وتارة يستعمل معنى خاطئا مخالفا لمقتضيات الشريعة نفسها .
وحتى نخرج بصورة واضحة من هذا المأزق الالتباسي أقول : إن قصد بقبلية سيادة الأمة على الشريعة المعنى الثاني , أي أن الشريعة لا يمكن أن تطبيق نفسها بنفسها وإنما لا بد لها من أناس يطبقونها , فالمعنى صحيح , ولكن استخدام اللفظ خاطئ لغة وشرعا .
وإن قصد بقبلية سيادة الأمة على الشريعة المعنى الأول , وهو أن تطبيق الشريعة لا يكون ملزما إلا بعد رضا الناس ومن لم يرض بالشريعة لا تطبيق عليه .. فهو معنى خاطئ كما يأتي الاستدلال عليه .
وختاما لهذه الفقرة أقول : إنه لا داعي لإثارة هذه القضية أصلا في حل مشكلة الاستبداد , لأن المشكلة ليست في أصل تطبيق الشريعة ولا في حفظها وظهور أحكامها ولا في وجود علماء في الأمة يصدحون بالحق صباح مساء , وإنما في حكام استبدوا بالأمر .
الخلل الثالث : افتقاد الثمرة , ووجه ذلك : أن فكرة الدين الأصلية قائمة أصلا على الخضوع والتسليم بنفوذ الأحكام.. فمن العبث أن تأتي إلى أي متدين بدين فتقول له هل ترضى بتطبيق دينك عليك؟!! فمن العبث أن تأتي إلى اليهودي الذي يعتقد أن دينه لم يحرف ثم تقول له هل تريد أن نطبق دينك عليه؟!! هل تريد أن نجري أحكامه عليك؟!! وكذلك الحال في كل دين .
فكيف بالمسلم الذي يفتخر بدينه ويرى أن دينه محفوظ لم يحرف ؟!!
إن الانطلاق في حل معضلة المستبد من اختبار إرادة الأمة في تطبيق دينها على واقعها تغريد في فضاء آخر مختلف عن فضاء المشكلة .
إن المؤثر الحقيقي الذي ترغب الأمة في إثارة الأسئلة من أجله وتتمنى أن يُفعّل القول فيه هو سؤالها عمن ترضاه في سياسة دينها ودنياها…ومن ثم يكون لها حق المراقبة عليه .
إن الأمة المسلمة لا تريد ممن يريد إصلاح حلها أن يقوم بانتخابات يسألها فيها عن رغبتها في تطبيق الإسلام ((ولا تريد منه أن يكشف قبلية سيادتها على تطبيق دينها)).. وإنما تريد منه أن يزيل عنها ذلك المستبد الظالم الذي عبث بحياتها .
إن الذي يأتي إلى الأمة المسلمة ويقول لها لا يمكن أن نزيل الاستبداد عنكم إلا إذا قمنا باختبار إرادتكم وهل ترغون في تطبيق الإسلام((ونحقق لكم قبيلة سيادتكم على تطبيق الشريعة)) سيكون أضحوكة بين الأمة .. لأنهم سيقولون له بصوت واحد .مشكلتنا ليست في رغبتنا في تطبيق ديننا وإنما في تسلط هذا الظالم علينا .
هذا كله يبين لنا أن طرح الإشكالية في ذلك الحل لا فائدة منه في حال معضلة المستبد , أو على الأقل فيه تطويل غير مفيد ولا مثمر .
ومن جهة أخرى فطرح هذا السؤال على الأمة أو محاولة اختبار رضى الأمة بتطبيق الدين .. فضلا عن أنه لا فائدة منه فهو مشتمل على خطأ منهجي .. ويتحصل في عدم التفريق بين حال الكافر الأصلي وبين حال المسلم المقر بالإسلام .. فإن النصوص الشرعية التي دلت على الاختبار إنما هي في حال الكافر الأصلي لا في حال المسلم , وحين بايع الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بل ومعاوية , لم يرد أي ذكر لرضى الناس في تطبيق الشريعة أبدا .. وحين ثار بعض الصحابة والفقهاء على الاستبداد لم يرد أي ذكر لرضى الناس بتطبيق الدين . ولم يرد ذلك إلا في حال الكافر الأصلي في دخوله في الإسلام فقط .
الخلل الرابع : المخالفة لقطعيات الأدلة , ووجه ذلك : أن القول بأن معنى سيادة الأمة هو أن الشريعة لا تكون ملزمة بنفسها , وإنما بعد رضى الناس بها , وإذا لم يرضى بها كل الناس أو بعضهم فلسنا ملزمين بتطبيقها عليهم , وأن النظام الإسلامي ليس ملزما بإخضاع الناس لتطبيق الشريعة .
وقبل مناقشة هذه الفكرة لا بد من التأكيد على أن البعض يطلق مثل هذه العبارات ثم في تفسيره لها يذكر معنى آخر وهو أن السيادة تعني أن الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها , وهذا معنى آخر مختلف تماما عن المعنى الأول .
وإذا رجعنا إلى المعنى الأول .ورجعنا إلى النصوص الشرعية لنختبر صحته نجد قدرا كبيرا من النصوص مخالف له .
فتلك النصوص تدل على معنى واحد وهو أن الجماعة الإسلامية بحاكمها وأفرادها إذا أمكنهم أن يخضعوا الناس لنفوذ الشريعة الإسلامية فإنه يلزمهم ذلك , وتدل على أن أي جماعة تريد الخروج عن المنظومة الإسلامية فإنه يجب على الجماعة الإسلامية حاكمها وأفرادها إذا كان لديهم قدرة أن يزيلوا ذلك .
فكل الشواهد التي ستذكر تدل على تعليق الحكم بالقدرة من حيث الأصل , ولا تربطها بإرادة ورغبة من خرج عن حكم الشريعة .
((ولا بد من التأكيد هنا على أن المراد إظهار المخالفة في المجتمع لا في وجود أصل المخالفة , بمعنى أن الإنسان إذا خالف الشريعة في السر بأي نوع من أنواع المخالفة فإن الجماعة الإسلامية ليست ملزمة بالبحث عنه ما لم يتعد أثره على المجتمع أو ما لم تكن مخالفته معارضة ظاهرة لنظام الإسلام))
والآن نأتي إلى سوق الشواهد .. وهي كثيرة جدا .. ولها ارتباطات واسعة وتتطلب توضيحات متعددة .. وسيكون ذلك في بحث مستقل بإذن الله , ولكن سنعرض لها هنا مختصرة :
الشاهد الأول : هدم مسجد الضرار , فالمنافقون كانوا يمارسون مخالفتهم للدين في السر , فلما أرادوا أن يكوّنوا لهم حزبا ويظهروا فيه العلن والمحاربة المعنوية الحسية . قام النبي عليه صلاة والسلام بهدم هذا المبنى وإزالته من الوجود .
ووجه الشاهد منه : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر رضى هؤلاء النفر , بل ألزمهم بالخضوع لحكم الشريعة , مع علمهم بعدم رضاهم .
الشاهد الثاني : فعل الصحابة مع المرتدين , فالصحابة حين ارتدت العرب قاموا بمحاربتهم وإخضاعهم لحكم الشريعة , ومن المعلوم أن المرتدين كانوا أصنافا منهم من ارتد عن أصل الدين و ومنه من ارتد عن دفع الزكاة .
والسؤال هنا : كيف نعرف الدافع الحقيقي الذي دفع الصحابة إلى محاربة أولئك النفر؟! وكيف نحدد المناط المؤثر في فعلهم ؟! , والجواب هو أن نرجع إلى كلامهم وطريقة نقاشهم وحوارهم , وإذا رجعنا إليه نجد أن المؤثر الحقيقي في تلك المحاربة هو كونهم خالفوا أحكام الشريعة فلم يقبلوا بها , كما قال أبو بكر حين حاوره عمر في وجه محاربتهم: ( والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة الصلاة ) , ولم يقل : لأقتلن من خرج عن الدولة .
فالمناط المؤثر هو كونهم خالفوا الشريعة , وهذا يدل على خطأ من يقول أن المبرر هو خروجهم عن الدولة , فهذا المبرر ليس عليه أي دليل في حوارات الصحابة.
ووجه الشاهد منه : هو ان الصحابة ألزموا المرتدين بالخضوع لحكم الشريعة مع علمهم بعدم رضاهم .
الشاهد الثالث : جهاد الصحابة في فارس والروم , فالصحابة خرجوا لقتال فارس والروم بأعداد كبيرة , ولم يكن بينهم أي خلاف في مشروعية هذا القتال , فهم مجمعون على شرعيته .
والسؤال مرة أخرى , كيف نعرف الدافع الحقيقي الذي دفع الصحابة إلى محاربة تلك الدول؟!! وكيف نحدد المناط المؤثر في فعلهم؟!! , والجواب هو أن نرجع إلى وصايا أبي بكر وعمر لهم وإلى صياغات الكتب التي أرسلوا بها إلى ملوك فارس والروم وإلى حوارات الصحابة مع قادتهم .. ويظهر فيها أن الصحابة قصدوا إلى إخضاع الدول لحكم الشريعة .
ووجه الشاهد منها : أن الصحابة أجمعوا على مشروعية ذلك الفعل مع علمهم بعدم رضا عدد كبير من فارس والروم عن هذا الفعل .
ولا بد من التأكيد هنا أن الصحابة لم يكرهوا أفراد تلك الدول بالدخول في الإسلام , بمعنى أنهم لم يجمعوا الناس في صعيد واحد قالوا : من لم يدخل في الإسلام قتلناه , وإنما الذي حصل منهم هو إخضاع جملة المجتمع وحكومته لنفوذ الشريعة , ومن ثم من أراد أن يدخل في الإسلام فمرحبا به , ومن لم يرد لا يجبر على ذلك , ولهذا ظهر في المجتمع أهل الذمة , ولو كانوا يجبرون كل احد على الدخول في الإسلام لما ظهر أولئك النفر .
الشاهد الرابع : موقف الصحابة وعلماء الأمة من أفراد المرتدين , فقد شهد التاريخ الإسلامي منذ زمن الصحابة حالات من الارتداد , وكان موقفهم منهم هو السعي إلى معاقبتهم , وهذا محل إجماع ظاهر جدا في تصرفات الصحابة والعلماء من بعدهم , وأخف حكم ورد عن بعضهم هو أنه يحبس أبدا , وهذه عقوبة تدل على أن الخضوع لحكم الشريعة ليس راجعا إلى مطلق إرادة الشخص وإنما إلى القدرة ولإمكان من حيث الأصل .
ولا بد من التأكيد على أن الشاهد مبني على مطلق العقوبة وليس على قتل المرتد .. فمن ينازع في الإجماع على قتله غاية ما يفعل يعتمد على قول من قال يستتاب أبدا .. وهذا لا يدل على نفي مطلق العقوبة عنه.
* المصدر: موقع تأصيل
**************
هل الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟!
فهد العجلان
في أكثر من لقاءٍ فضائي.
وفي إشارات قليلة في بعض المؤلفات المعاصرة.
وفي كلام كثير في الشبكات الاجتماعية.
يتردد الحديث بأن تحكيم الشريعة يؤدّي إلى النفاق، وأن الشريعة لا تلزم الناس بأحكامها لأن ذلك سيخلق مجتمعاً منافقاً، ولهذا كان من دلائل الشريعة أن (لا إكراه في الدين).
فهل الإلزام بالشريعة أو ببعض أحكامها يؤدّي للنفاق؟
يقول لك حامل هذا الاستشكال: إنه لا يمكن الإلزام بأحكام الشريعة لأنه يورث النفاق، فالناس حين لا تقتنع بالحكم فإنها ستمارسه في الخفاء، فالمطلوب هو غرس القيم الإيمانية وتعزيز انتماء الناس لدينهم وهويتهم، والاجتهاد في نصحهم ووعظهم حتى يقوموا بالدين من ذات أنفسهم، وأما مع الإلزام فهو إكراه ينافي الإسلام ويؤدي للنفاق.
وثم تفاوت في إعمال هذا الكلام:
فبعضهم: ينفي بسبب هذا عن الإسلام أي إلزام، ويجعله مجرد رسالة روحية فردية بين العبد وبين ربه ولا علاقة له بنظام ولا حكم لأن حين يرتبط بالدولة يتحوّل من رسالة هداية إلى وسيلة قمع، وهؤلاء هم العلمانيون الخلّص.
وبعضهم: يأتي بمثل هذا الكلام لكن في جانب معين من الدين وهو ما يتعلّق بالرأي، فما كان رأياً ليس فيه أي اعتداء فلا إلزام ولا منع له لأن منعه سيعزز النفاق.
وبعضهم: يأتي به ليعلّق الإلزام بالشريعة والحكم بها بطريقة معينة معاصرة، طريقة الدساتير والاختيار بطريقة محددة معروفة، فإذا اختار الناس الإلزام بهذه الطريقة فلا بأس، وإلا فهو مرفوض، ولا يمكن تطبيق الشريعة بغير هذه الطريقة لأن هذا حق من حقوق الأمة.
فهذه اتجاهات مختلفة كلّها تستدل – بشكل أو بآخر- بشبهة ترتب النفاق على الإلزام بالشريعة.
إذن: الحديث هنا ليس عن الإيمان بالحكم الشرعي، بل عن مستوى الإلزام.
لا حاجة هنا أن يعترض أحد فيقول (إن صاحب هذا الاستشكال لا يؤمن بالنص ولا بحكمه) لأن هذا ليس محلّ السؤال، الحديث تحديداً عن الإلزام بالحكم.
ولا حاجة لصاحب السؤال بأن يجيب ( بأنه مؤمن بالنص)، لأن الخلاف تحديداً عن الإلزام بالنص وليس عن مجرد الإيمان به.
هذا هو تفصيل السؤال، وهو يحمل في طياته خللاً بينا وتصوّرا خاطئاً وإشكالات مركّبة، ستظهر بإذن الله من خلال تفكيك هذا السؤال ومناقشة مقدماته وإظهار مخفياته.
فهذا السؤال يحمل ثلاث إشكالات رئيسية:
الأول: إلغاء وصف (الإلزام) في الشريعة تصريحاً أو مآلاً.
الثاني: الخلل في فهم النفاق ومعرفة أسبابه.
الثالث: الخلل في تصوّر الإلزام وأثره.
وحجم هذه الإشكالات يتضح – بإذن الله- مع استعراض هذه العناصر:
(1)
يجب التفريق – أولاً- بين ترك الإلزام بالشريعة في ظرف ما، أو مكان ما، أو لسبب ما، وبين التأصيل الكلّي العام الذي يعود على مفاهيم الشريعة بالنقض والتحريف.
فهذا التأصيل – بجعل الإلزام يؤدي للنفاق- يرجع على أصل الإلزام بالشريعة بالنقض.
فإذا كان الإلزام بالشريعة يؤدي إلى النفاق فمعناه أن الشريعة يجب أن لا يكون فيها إلزام، ولو وجد فيها إلزام فهو مفسدة ظاهرة تؤدي للنفاق ولا فائدة منها ويجب تبرئة الشريعة من هذه النقيصة، وهذا هو لازم مؤدٍ للوقع في الفكرة العلمانية الصريحة التي غمرتها الأمة كرهاً ونفرة.
وهنا تكمن المشكلة:
فالإلزام ببعض أحكام الشريعة قد لا يكون ممكناً في بلد ما، أو يترتب عليه مفاسد أعظم في حالة ما، الخ هذه الأسباب التي يجب مراعاته عند تطبيق الأحكام الشرعية، فالموقف الصحيح حينها أنه واجب شرعي يسقط لعدم القدرة، وهذا أصل شرعي محكم (فاتقوا الله ما استطعتم) (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقاعدة السياسة في الإسلام تقوم على الأخذ بأرجح المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، فالإلزام ليس فرضاً في كل زمان ومكان وحال وشخص ونظام، بل قد يسقط أو يؤجل لاعتبارات عدة، وكلنا نتفهم مثلاً: موقف (حركة النهضة) التونسية في عدم الإلزام بالأحكام الشرعية فليست الخلاف في عدم تطبيقها، ولا محلّ الخلاف هنا ( هل يجب عليهم أن يلزموا الناس الآن بالشريعة).
إذن أين المشكلة؟
المشكلة أن يتحول الاستثناء إلى أصل، وتترحّل الضرورة إلى أصل ثابت وأساس محكم، فالقول بأن النفاق تابع وأثر للإلزام يعني أن أصل الإلزام كله مرفوض مطلقاً، وأن الشريعة ليس فيها إلزام، وهذا تجاوز وحذف لأصل شرعي ثابت ومجمع عليه ولا يمكن إنكاره، وكون الإنسان لا يستطيع تنفيذه أو يرى أن ثم ما هو أولى منه أو يرى أن تنفيذه سيثير مفاسد معينة، كلّ هذا لا يعني أن يلغي المفهوم.
فالإنسان قد يضطر لشرب الخمر مثلاً، وهو شيء مقبول، بل ويجب عليه أن يشربه، ولو قال إن الخمر شراب من ضمن الأشربة ولا تشددوا على الناس لعد قوله منكراً شنيعاً ولو كان مضطراً، لأن الضرورة في الشرب وليس في تغيير الحكم الشرعي.
فالإشكال ليس في (التطبيق) الذي سيجري في تونس أو في تركيا أو في غيرها، بل في (المفهوم الشرعي).
حينها فلا معنى لما يكرره كثير من الفضلاء من أنكم لا تدركون ولا تفقهون الواقع في تلك البلاد.
فأياً ما كان مستوى فقه العلماء لذلك الواقع، لا علاقة بهذا بأساس الخلل.
القضية متعلقة بمفهوم شرعي، وليس بتطبيق معين في أي بلد، فالقضية علم بأحكام شرعية ثابتة وليس علم بواقع مجتمع معين.
فكون البلد يعاني من مشكلات معينة، ويجد الدعاة فيه إشكالات وإحراجات كثيرة، كلّ هذا لا يجيز تحريف الأحكام الشرعية أو تغيير مفاهيمها، فهذا دين وشرع من عند الله، الحديث فيه قول على الله، والقول على الله بلا علم مزلق عظيم (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فحاجة المجتمع والمتغيرات التي يعيشها ليست عذراً لأحد في حذف شيء من الشريعة أو إدخال شيء فيها، والعناية بهذا الموضوع ليس ترفاً علمياً أو سجالاً جدلياً بل هو من بيان أحكام الشرع، وحفظ المفهوم الشرعي مطلب بحدّ ذاته من جهة، ومن جهة أخرى: فوضوحه للناس سبب لأن يتمسكوا به ويطالبوا به حتى يستطيعوا تحكيمه فيما بعد، ومن جهة ثالثة: أن حاجة المجتمعات تختلف فإذا لم يستطع بلد أن يطبق بعض أحكام الشريعة فثم مجتمعات تستطيع أن تطبقه، فيجب أن تكون الحكم الشرعي بيناً لا تختلط فيه صورة الأصل مع الضرورة.
(2)
ومن يلتزم بهذه الشبهة سيقع في إشكال عميق مع قائمة طويلة من الأحكام الشرعية، وسيطول عليه أساليب التأويل والتحريف والتغيير.
فالقضية ليست نصاً جزئياً يمكن أن يتأول أو يكون ضعيفاً.
الإلزام أصل شرعي محكم يقوم على نصوص وأحكام وقواعد لا تحصر، وسأعدد سريعاً – لتوضيح حجم هذا الأصل بعض هذه الأحكام :
– الحدود الشرعية، ففي القرآن حد السرقة (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وحد الزنا (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وفي السنة حد شرب الخمر، فهذه ليست إلزامات فقط، بل عقوبات على هذه الجرائم، وعقوبات صريحة وصحيحة وواضحة، تعني تجريم الفعل وتحديد عقوبة معينة عليه، فهو إلزام بترك الفعل، وإلزام بعقاب معين، فهل نتعامل مع هذه الحدود على مبدأ (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) أم على مبدأ إن الإلزام يؤدي للنفاق؟
– تغيير المنكر، الثابت شرعاً، كقول النبي صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) فالتغيير باليد يعني منعاً وإزالة، وهو إلزام على التزام أحكام الشريعة، وهو خطاب لعموم الناس وليس خاصاً فقط بالنظام، فهل الواجب تغيير المنكر أم هو داع للنفاق؟
– التحاكم إلى الشرع، فقد أمر الله بالتحاكم إلى كتابه فقال سبحانه (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال تعالى (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) وقوله تعالى (الم ترا إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) فهذه آيات صريحة على وجوب التحاكم إلى الشريعة، ولو لم يكن في الشريعة إلزام ومنع وفرض لما كان للتحاكم أي معنى؟ فيتحاكمون لأي شيء ما دام أنه حكمه غير ملزم؟
وقد قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فالمؤمن ليس له خيار في الالتزام بالشريعة وأحكامها، كيف توفّق بين الإيمان بهذه الآية وبين القول بأنه لا إلزام في الشريعة؟ كيف لا يكون له خيار، لكنه في نفس الوقت ليس ملزماً؟! هذه معادلة معقّدة جداً!
– الجهاد في سبيل الله، ففي نصوص القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وأصحابه منها ما هو شائع مشهور، فإذا لم يكن في الشريعة إلزام فعلى أي شيء كان كل هذا الجهد والجهاد؟
حتى على التفسير العصري المحدث القائل إن الجهاد في الإسلام كان لردّ العدوان ولدفع المعتدي فقط، فحتى على هذا التفسير يبقى موضوع الإلزام مشكلاً، لأن الصحابة لما جاهدوا وقاتلوا لم يدفعوا العدوان ويسلموا البلد لأهلها ثم يعودون، بل حكموا البلد بالإسلام وأقاموا شعائره وألزموهم بنظام الإسلام، فهل كانوا دعاةً إلى الإسلام نشروا شعائره في الخافقين أم أنهم كانوا يغرسون النفاق في جذور المجتمع وهم لا يشعرون؟
وسيرة الخلفاء الراشدين ظاهرة في الأخذ بالإسلام ونشره وإقامة شعائره، وأحكامهم مع أهل الذمة لا تخفى على أحد، فبغضّ النظر عن تأويل أو حكم هذه الأفعال، هل أدّى هذا الإلزام للنفاق أم كان سبباً لنشر الإسلام وتقويته وتوسيع دائرة أوطانه؟
– نصوص العقاب والإهلاك: ففي القرآن والسنة نصوص عدة أن المنكر إذا ظهر وفشا كان عاقبته الهلاك (وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش وقد سألته أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فكثرة الخبث مؤذنة بالهلاك، وهذا يعني أنه يجب منع هذا الخبث حتى لا على المسلمين في الهلاك.
– تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقات صحابته وخلفائه رضي الله عنهم في الأخذ بالشريعة والإلزام بها، فقد حد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ورجم في الزنا في عدة وقائع، وهم بتحريق بيوت تاركي الصلاة في المساجد، وعاقب من تخلّف عن الجهاد معه، وقام بجباية الزكاة، وأسقط الزيادة في الديون الربوية، وأخذ الجزية من أهل نجران، وجلد في القذف، وأخذ الناس بأحكام الجنايات والديات والبيوع والأسرة، وقام بالفصل بين الخصومات الخ الخ.
وأما نصوص الصحابة فحدث ولا حرج، فقد قاتلوا المرتدين، وجبوا الزكاة، وحكموا بين الناس في كافة قضاياهم، وطبّقوا أحكام أهل الذمة، وأقاموا الجهاد، والحدود، والعقوبات التعزيزية على المعاصي، الخ.
بصراحة أجد أن تعداد هذا ترف علمي لا حاجة له، لأنه من البدهيات التي يعرفها كل الناس، فلم يكن سؤال (الإلزام) بالشريعة مطروحاً في تلك العصور أصلاً، لأنه بدهي وضروري من أحكام الإسلام، إنما طرح هذا الموضوع بسبب ضغط مفاهيم الثقافة العلمانية المعاصرة فتتحرك معها محاولات التوفيق والتلفيق والموائمة.
– قول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) وقال (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة) وقد اعتضد هذا الحكم بعدة تطبيقات عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وانعقدت عليه كلمة عامة فقهاء الإسلام.
أعرف جيداً أن لبعض المعاصرين تفسيراً مختلفاً للحكم في قول لا يعرف له قائل من قبلهم.
لكن بغض النظر عن صحة قولهم أو فساده، ما تفسيرهم لاتفاق كافة الفقهاء على هذا القول؟ هل كانوا يطبقون أحكام الإسلام أم يزرعون النفاق في مجتمعاتهم وهم لا يشعرون؟؟
وعلى فرض أن بعض الفقهاء لا يقولون بحدّ الردة، فإنهم كانوا يقولون بسجنه أو استتابته الخ، يعني في النهاية هو منع وإلزام وليس فيها حرية مطلقة للردة.
مع ملاحظة أن دافع النفاق هنا قوي جداً، لأنك أمام شخص أعلن كفره، ثم يوقف على القضاء حتى يتراجع وإلا عوقب، فاتجاهه للنفاق حتى يسلم بنفسه سلوك طبيعي جداً، ومع هذا فلم يكن أحد من الفقهاء بتاتاً يقول اتركوه حتى لا يكون منافقاً، بل يلزم بقانون الإسلام وباحترام نظامه وآدابه، ولو نافق مثله فهو خير من الإضرار بعموم المجتمع.
فإذا كان مثل هذه الصورة المؤدية فعلاً للنفاق غير معتبرة عند أحد من فقهاء الإسلام، فكيف يكون الخشية من النفاق مؤثرة في قضايا لا يمكن بتاتاً أن تكون سبباً للنفاق؟
(3)
هل من يثير هذا السؤال يتصوّر حالة المنافقين في عصر الرسالة؟
النفاق وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله في القرآن وحذر منهم وبيّن صفاتهم، ولم ينبت النفاق في المدينة إلا بعد أن قوي الإسلام واشتد عوده وظهرت شعائره، فوجودهم حالة طبيعية ملازمة لتطبيق الشريعة وقوتها وظهورها وليس عيباً على الشريعة، فالنفاق لا يخرج إلا في المجتمع الإسلامي القوي، حين تظهر شعائره وتعظم حرماته فيضطر البعض لسلوك النفاق لأنه لا يستطيع أن يمارس فساده وانحرافه، فهذا علامة قوّة وصحة للمجتمع، فوجود النفاق لا يؤدي لإلغاء الإلزام بالحكم الشرعي وإلا لكان هذا طعناً وانتقاصاً من سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوّة الشريعة وظهورها على يده هو الذي أنبت المنافقين ولم يكونوا موجودين قبل ذلك لما كان الإسلام ضعيفاً في مكة.
فالحديث بطريقة: أن الإلزام يؤدي للنفاق، وبالتالي فلا إلزام، خلل وتركيب خاطئ للموضوع.
بل وجود النفاق مع الإلزام ظاهرة صحية شرعية طبيعية، فلا يتعطل أصل شرعي من أجله.
النفاق لا يوجد إلا مع قوة الإسلام، ولن يذهب إلا مع ضعف الإسلام، فإذا كان الهدف هو إزالة النفاق فالحل إذن هو في إضعاف الإسلام حتى لا يحتاج أحد للنفاق.
أما حين يذهب الدعاة والعلماء والفضلاء لتقوية الإسلام وأحكامه وقيمه ومبادئه في نفوس الناس وإشاعته ونشره فإن هذا سيؤدي بداهة لوجود المنافقين الذين يضطرون لمسايرة هذا الواقع والاستفادة من منجزاته، فوجود النفاق دليل على قوة الإسلام وإيجابيته وفاعليته وليس ضعفه.
فالإلزام لا يُترك خشية النفاق، بل الإلزام يلحق حتى المنافقين، فقد كان يتهرّبون من حكم الإسلام (ألم ترا إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت).
فهم يرفضون التحاكم، والله يذمهم ويعيبهم على تركهم للتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فترك التحاكم إلى الشريعة والابتعاد عن الإلزام بها هو صفة المنافقين، وليس هو سبب للنفاق.
فالتصوّر الشرعي: هو دعوة المنافقين للتحاكم وإلزامهم به.
أما أن يترك الإلزام لأجل أن لا يكون منافقين فهو بعثرة للصورة بالكامل.
وإذا كان هذا في المنافق غير المؤمن من الأساس فكيف بالمؤمن المسلم المنقاد؟
(4)
إن هذا يدعوني للسؤال عن مفهوم النفاق وتعريفه لدى صاحب هذا الاستشكال.
فما هو مفهوم النفاق؟
لأن كل المعطيات السابقة والآتية تثبت أن المسلمين يتحولون إلى هذا النفاق بسبب إنكار المنكر ولا بتطبيق الشريعة بتاتاً، فهو غير مؤدٍ للنفاق، فالنفاق أن يسر الإنسان بالكفر ويظهر الإيمان، فما علاقة هذا بإنكار المنكرات أو تحكيم الشريعة؟
نعم، هذا سيكون في بعض الأحكام الشرعية ومن فئة قليلة لديها موقف سلبي من الدين نفسه وتريد الطعن في الإسلام لكنها لا تستطيع خشية العقاب فتلجأ إلى النفاق، وهذا موقف صحي وقوي، فخير من أن يظهر كفره واعتدائه يتخفى به ويستتر.
فالنفاق لا يكون بالإلزام.
بل الواقع أن النفاق إنما يكون حين يضعف الإلزام.
فالمنافقون يخفون غيظهم وحنقهم على الإسلام والمسلمين، وإذا وجدوا فرصة أو مجالاً استغلوه وأظهروا الرجف والتشكيك، لهذا كان علاجهم القرآني بالتهديد والوعيد (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً) فالقوة والإلزام هي التي تحمي المجتمعات من المنافقين، وتركه هو الذي يجرئهم ويغريهم، لهذا جاء الخطاب القرآني (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم)،
فهذه هو علاج القرآن للمنافقين، ولم يكن علاجهم بأن يقال لهم ( تفضّلوا خذوا راحتكم، واعلنوا كفركم وأنتم في حلّ من الشريعة، أهم شيء لا تصيرون منافقين)!!.
النفاق لا يستقر في النفوس بسبب الشعائر، الشعائر والإلزام بركة وديانة وتقوى لله، هذا يحبب النفوس للدين ويجعلها تألفه وتحبه وتعتاده، النفاق لا ينشأ بسبب هذا، إنما ينشأ بأسباب أخرى، من أعظمها شيوع الشبهات والتشكيكات في الدين ونشر كل ما يمس الدين ويقدح فيه، فهذا من أعظم أسباب النفاق لأنه يهز اليقين في نفوس بعض الناس ويدخلهم في الحيرة والشكوك، فهذه منابت النفاق التي يجب الحرص عليها لمن كان صادقاً فعلاً على علاج النفاق ومتألماً منه.
فتعريف النفاق في السؤال قائم على نفاق آخر ليس هو النفاق الذي يعرفه الناس.
(5)
أن إخفاء المعاصي والمنكرات خير من إظهارها وإشهارها، فعلى أسوء الاحتمالات فلو أن المنع لم يفد شيئاً وأصبح الناس يمارسون ذات المنكرات في الخفاء فإخفاؤها خير بلا مقارنة من إظهارها وإشاعتها، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) فالمجاهرة بالذنب شر وأقبح من الإسرار به، وما دام المنكر سراً فلا يحاسب عليه المجتمع ولا يؤاخذ به، إنما المحاسبة على المنكر حين يشيع ويظهر.
(6)
ثم إن التخفي بالمعصية ليس نفاقاً، فإذا منع المسلم من شرب الخمر فشربه سراً فهذا خير له وأخف شراً وليس نفاقاً.
فما أدري لماذا يفترض السؤال أن المسلم إما يشرب الخمر جهراً ويفعل الفاحشة جهراً وإما يكون منافقاً يشربه سراً؟
هل الإسرار بالمعصية نفاق؟
لا يقول هذا عالم ، فالإسرار بالمعصية أولى من الجهر بها، فهو شرعاً أفضل وأهون، فلا أدري على أي اعتبار صار منافقاً؟
حتى ولو بحث المسلم عن المعصية واجتهد في الوصول إليها ولم يجدها فهذا ليس نفاقاً ولا علاقة له بالنفاق بتاتاً.
(7)
هذا السؤال يمارس تصويراً مغلوطاً فاحشاً، فهو يفترض أن المسلم حين يمنع من الحرام فإنه سيفعله في السر، وكأنه لا وجود لخيار ثالث هو الأكثر والأشهر والأبرز، وهو أن عامة المسلمين حين يمنعون من الحرام فإنهم سيتركونه لما في نفوسهم من تعظيم الشرع وميل لتطبيقه أحكامه ما استطاعوا، وإنما تبقى قلة تمارسه في الخفاء.
فإشاعة الحرام يجرئ على فعله ويكثر من مرتاديه، واعتقاد أن منعه لن يؤثر في مضايقته وإبعاد الناس عنه تصور بعيد جداً عن الواقع، ولهذا جاءت الشريعة بالحث على التستر بالمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمّ فليستتر بستر الله) وهو شيء بدهي يفهمه عامة الناس فتراه يرددون: إذا بليتم فاستتروا.
وقد قال ربنا جل وعلا: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) فالمنكر الظاهر يجرئ الناس ويوسع الفساد فإذا لم يظهر غفل عنه الناس وتركوه.
(8)
وهذا الإلزام لا يخلو منه أي قانون ولا نظام معاصر، فكل الأنظمة المعاصرة تقوم على قوانين وأنظمة ملزمة في كافة شؤون حياة الناس ودقائق تفاصيلهم، والالتزام بها ضرورة، حتى ولو خالفها البعض فلا يتصور أن يخطر ببال أحد أن مخالفة البعض تعني أن القانون لم يعد له أهمية فإما أن تلتزم به أدبياً أو لا حاجة له؟
لا أحد يفكر بهذا لأن هذا شأن معيشي بدهي، والناس يعرفون أن القانون إذا قوي ولزم وعم زادت قناعة الناس به ورضوا به مع كونهم في الأصل مكرهين عليه وملزمين به.
(9)
ثم إن خطاب الشريعة في القرآن والسنة، القائم على أوامر ونواهٍ، هل هو خطاب للفرد فقط، أم للفرد والمجتمع؟
حين نقرأ في القرآن مثلاً (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا)
فمباشرة سيفهم منه المسلم أنه خطاب للفرد بأن يترك الربا امتثالاً لأمر الله، وللمجتمع المسلم بأن يترك الربا، وللدولة المسلمة التي تقوم على سياسة هذا المجتمع أن تترك الربا.
وهذا يعني أن الإلزام جزء أساسي من الحكم الشرعي.
أما اعتقاد أن النص يدل على تحريمه على الفرد، أما تحريمه نظاماً وقانوناً فهو شيء آخر، فهو تفكير جديد، يناسب تفكير الفئة المتأثرة بالثقافة العلمانية حين تجعل الدين شأناً فردياً وخطابه متجه للفرد ولا يمسّ النظام والدولة.
ثم إن المسلم حين يدخل في الإسلام فإنه تلقائياً يكون مسلماً ومنقاداً لحكم الإسلام، فالإسلام نظام شامل، لا يوجد في الفكر الإسلامي أن يسلّم المسلم فيدخل في الدين، ثم يسلم فيوافق على حكم الشريعة، هذه درجتا فهم تناسب الدين النصراني والثقافة العلمانية لأن الدين لديهم علاقة روحية لا تمس الحكم، فيختار الحكم الذي يريد بغض النظر عن دينه، أما المسلم فإنه حين رضي بالإسلام فقد رضي به حكماً بداهة ولزوماً ضرورياً لدينه، وحينها فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئاً طارئاً وجسماً غريباً نبحث له عن سبب ومشروعية وطريقة معينة، هو أصل وفرض لازم وبدهي ما دام أن الناس مسلمين، وهذه مجتمعات مسلمين قامت في أرضها دول إسلامية خلال عشرات القرون، لم تعرف غير حكم الإسلام وإلزامه، فلا يجوز أن نتعامل مع حكم الإسلام وكأنه جسد غريب على تلك المجتمعات.
(10)
أن المطالبة الشرعية تتجه للظاهر لا الباطن، فلست مسؤولاً عما في بواطن الناس وخفايا قلوبهم فأمرهم إلى الله، فما دام أنه في خفايا قلبه فهو خاص بصاحبه ولا يضر إلا نفسه، ولا يعد منكراً في الشريعة يجب إنكاره لأنك لا تدري عنه.
فمن المفارقات أن يُترك الداعية المنكر الظاهر الذي يجب عليه، خشية من منكر خفي لا يعلم عنه وهو غير واجب عليه!
فالشريعة تأمره بالمنكر الظاهر، فيتركه، خشية من منكر ليس بواجب عليه؟
ويترك منكراً معلوماً، خشية من منكر غير معلوم ولا يمكن الكشف عنه؟
ويترك منكراً متيقناً خشية من منكر موهوم لا يجزم به؟
ثمّ إن بعض النفوس فيها من الشر والسوء والكره للإسلام وأهله، فهل نتيح لهم الفرصة ليعبّروا عن مشاعرهم ويسيئوا للإسلام وأهله حتى لا يتحولوا لمنافقين؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول 3/939
(فإن الكلمة الواحدة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفار ولأن يظهر دين الله ظهوراً يمنع أحداً أن ينطق فيه بطعنٍ أحب إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو منتهك مستعان).
هذا هو التفكير الإسلامي البدهي الذي تجده في عموم المسلمين فلا يفكرون بطريقة (بل اجعلهم يظهرون ويمارسون فسادهم وانحرافهم حتى لا يتحولوا إلى منافقين)!!
(11)
أن الصلاح الظاهر وشيوع الشعائر يؤثر على صلاح الناس، كما أن شيوع المنكرات تؤثر على فساد الناس، فالمنكر إذا انتشر أثر في الناس وزاد ضرره وكثر مرتاديه، فالقضية ليست خاصة بمن يريد المنكر ويبحث عنه، بل إن المنكر إذا شاع سهل في النفوس وخف أثره وجرأ الناس عليه، ولهذا كان من حكمة الشريعة في إنكار المنكر إضعافه وتقليله لئلا يؤثر على الباقين، فالمنكر يؤثر على الصالحين، وليست الصورة أنه منكر متجذر في نفوس الناس بدأ معهم فطرة، بل إن تركه وطول العهد به هو الذي جعله منتشرا وتقبله النفوس وإذا حورب وضيق عليه قل أثره وضرره.
(12)
إذا كان الإلزام سيؤدي إلى النفاق، فحتى النصيحة والموعظة ستؤدي إلى النفاق كذلك، لأن أكثر الناس يستجيبون للنصح والوعظ وإن كان قد يمارسها في الخفاء، فهل يكون مثل هذا منافقاً؟
فعلى طريقة تفكير السؤال يجب أن يكون حكم النصيحة كحكم الإلزام لأنها تجعل الشخص يستحي منك ويترك المنكر حياء ويفعله سراً فيكون منافقاً؟
بل إن أثر الحياء من المجتمع في ترك المنكر أقوى بكثير من أثر الإلزام، فالإنسان يراعي الناس وأعرافهم، ويمارس معهم من الحياء والمداراة ما هو أعظم بكثير من مراعاته لمجرد الإلزام القانوني، فإذا كان الإلزام يؤدي للنفاق؟ فالحياء من المجتمع نفاق أيضاً؟
ثم إن الواقع أن الإنسان يلجأ إلى النفاق ليس من أجل الإكراه، بل لدوافع مصلحية متعلقة بالجاه والمال والمكانة وتحقيق المصالح الذاتية من المجتمع، فهو يراعي الناس أكثر من مراعاته للنظام، فارتباط مصالحه للناس أضعاف ارتباطه بالنظام، وحينها فحتى لو زال الإلزام فسيبقى النفاق ما دام في الناس اعتزاز بدينهم وهويتهم يجعلهم ينقصون مقدار من يخالف الإسلام فيضطر للنفاق مسايرة لهم.
لهذا نجد في سيرة المنافق عبد الله بن أبي أنه كان يقف أمام منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة ويقول: أيها الناس هذا رسول الله فوقروه وعظموه واسمعوا له وأطيعوا ثم يجلس.
فواضح جداً أنه لا إكراه في الموضوع بتاتاً، إنما هو بحث عن مصالح ومكانة وقيمة اجتماعية من خلال هذا النفاق.
(13)
ثم إن هذا الإلزام بأحكام الشريعة هل سيأتي من خلال البرلمان واختيار الناس أم لا؟
هل ستمنع الخمور والقمار وبقية المنكرات وتطبق أحكام الشريعة لو أتيحت الفرصة من خلال اختيار الأكثرية؟
هل سيكون فرض للشريعة وأحكامها حين يكون نصاً دستورياً؟
إن كان بالإيجاب فإن هذا سيؤدي للنفاق وهي ذات المشكلة التي كان يتحدث عنها؟
فهل سيزول النفاق وتنتهي المشكلة بمجرد أن يصدر قرارا برلمانيا بذلك؟
أو يكون نصاً دستورياً؟
إذا كان الإلزام إكراه في الدين ولا يمكن أن يلتزم به الإنسان إلا برضاه، فلا يجوز إذن إلزامه ابتداءً ولا بقانون ولا برأي أكثرية، لأن ذات المشكلة لم تتغير.
(14)
يسوق هذا السؤال جزئية: (أن المطلوب هو تزكية النفوس وتطهيرها لا إلزامها بما لا تريد).
والحقيقة أن الإلزام جزء من تزكية الناس وتطهيرها.
فجعل المسألة: إما إلزام للشخص وإما أن يقوم بها من نفسه وضميره، قسمة غير عادلة ولا منصفة.
بل الإلزام يتكامل مع مراقبة المسلم وإيمانه ودافعه الذاتي، فهما متكاملان لا ضدان، كون الشريعة جاءت بالإلزام لا يعني أنها لا تأتي بالدافع الذاتي، بل كلاهما واجبان شرعيان وطريقان صحيحان لتزكية النفس وتطهيرها ودفعها نحو طاعة الله وعبادته.
ثم إن الإلزام بالشريعة هو سبب لتطهير النفس وتزكيتها من الأمراض والأهواء وتصحيح مسارها وتقوية مراقبتها لله.
فالله تعالى يقول (ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين).
فترك التزامه بالتحاكم ينفي عنه صفة الإيمان، فالإلزام جزء من الإيمان، وقد أثنى الله عليهم (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) فالالزام فلاح ونجاة وهذا معنى عظيم من معاني التزكية.
فالتزكية إنما تكون بالقيام بأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليست التزكية حالة روحانية شعورية خارجة عن الشريعة، فبقدر ما يلتزم بالعبادة والطاعة – والتي منها الإلزام- بقدر ما تحصل التزكية، وبقدر ما يبتعد عنها تضعف التزكية، فالتزكية غاية شرعية تقوم على وسائلها الشرعية.
* المصدر: صفحة الكاتب على تويتميل
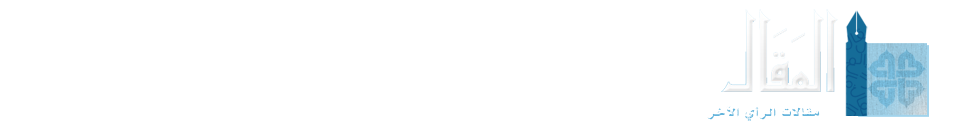











 معلومات الكاتب
معلومات الكاتب
لا توجد تعليقات... دع تعليقك